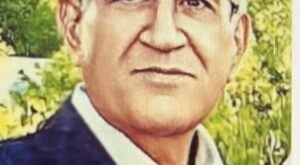السيمر / السبت 09 . 09 . 2018
صالح الطائي
بعد أن تقدم بي العمر، وأصاب الوهن عيوني، أقصرت قراءاتي على المواضيع التي أكتب عنها، فضلا عن قراءات الطريق، حيث أختار عشوائيا أحد الكتب من مكتبتي لأصحبه معي في السفر للقراءة، أما عدا ذلك، فهي مجرد نظرات عابرة ألقيها على بضعة صفحات من كم الكتب الكبير الذي يُهدى إلي، وحتى الكتب التي يُطلب مني أن أكتب عنها، أو التي تغريني للكتابة عنها، لا أوغل نزولا في أعماقها، بل أختار صفحات محددة، لأستخلص منها الرؤية، بل وحتى الكتب (كتب فكرية أم أدبية قصصا وشعرا) التي كانت تغريني لذاتها، أو التي اتصفحها فأجد فيها ما يستحق المتابعة، تجدني ما إن أتعمق بالدخول إليها حتى يصيبني الملل، فأتركها غير مأسوف عليها، وأترك الكتابة عنها.
كان هذا ديدني خلال السنوات العشر الأخيرة، تطبعت عليه، ولاسيما وأني اضطر الكثير من القراءات أثناء تأليف أحد كتبي، وإلى إلى قراءة كتبي المعدة للطبع أكثر من ثلاثين مرة متتابعة لأجردها وأدققها وأصحح ما فيها، بمعنى أني مشبع بالقراءة إلى حد التخمة، ولا أجد مكانا للمزيد.
وكما أن في كل خطوة في الحياة هناك استثناء يكسر القاعدة، وطبع يعارض التطبع والطباع، هناك من الكتب ما له القدرة على تغيير القناعات وتبديل السلوكيات ومخالفة العادات، والخروج على المألوف، وهذه حكايتي مع رواية “سلام لم يعد يغني” لصديقي الطبيب البيطري الذي أراد أن يزاحم الآخرين في دنيا الأدب، ربما تطفلا مني لأعرف إن كان قد نجح أم لا.
أهداني صديقي الدكتور باسم عبد علوان روايته الموسومة “سلام لم يعد يغني”، ولكني ما إن رأيت غلافها البسيط جدا حتى تصورت أنها قد تكون مغامرة غير مدروسة، أو عملا اعتباطيا فطريا ساذجا. أما العنوان فهو في بساطته وطريقة صياغته كان قد زاد مخاوفي من هنات هذا العمل المسمى (رواية).
على مدى عشرة أيام كنت أقلب أوراقها فأصطدم بكم كبير من الحوار باللغة الدارجة المحكية (العامية) فأقرأ بضع كلمات وألقيها من يدي، مؤجلا قراءتها إلى وقت آخر، ربما يطول كثيرا إلى درجة النسيان.
بعد اليوم العاشر، وبعد الساعة العاشرة ليلا، شعرت بإنهاك شديد، بعد أن أنهيت جرد كتابي الأخير، وأرسلته إلى دار النشر، ولكني لم أغادر مكتبي، بل بقيت جالسا، وتناولت الرواية، وبدأت أقرأ بجد عليَّ أغير حكمي أو أبدل رأيي فيها. وفعلا وجدت شيئا يستحق المتابعة، ووصفا يُقرِّب إليك الرؤى، حتى تشعر وكأنك في المكان الذي يتحدث عنه الروائي. وحينما عجزت عيوني المنهكة عن متابعة القراءة، فبدأت الكلمات تتداخل ببعضها، والحرف تنفصل عن أصولها، نظرت إلى ساعة الحائط، فأصابتني الدهشة! ياه… إنها الواحدة ليلا، عجيب، أين كنت؟ هل فصلتني الرواية عن واقعي، هل جعلتني أحلق في دنيا التأمل المغري، ففقدت الإحساس بالزمن؟ هل مارست الرواية عليَّ طقوس سحر لتأخذني عدوا ـ وأنا الشيخ الكبير ـ طوال هذا الطريق المحفوف بأشياء لم تكن على البال؟ وأي متعة تلك التي كانت تخامرني؟ أي شعور ذاك الذي انتابني، كيف تحولت من قارئ ضجر، إلى أحد أفراد (المنسية) القرية التي وقعت فيها أحداث الرواية، بل إلى واحد من أكثرهم مشاركة في الأحداث وخوضا للمغامرات؟
نهضت من كرسيي؛ وأنا أتمنى لو لم تخني عيوني، لأتمكن من إتمامها. أويت إلى فراشي وأنا كلي قلق وحيرة، ونمت وأنا أعيش احداث المنسية بأدق تفاصيلها، وحينما نهضت صباحا، كنت لا أزال أجتر أحداث المنسية، كنت استدعي تراكمات ما قرأت بالأمس، ولاسيما الحوارات باللغة المحكية، وأقارنها بخزين ذاكرتي عن قرية أعرفها، زرتها مرات كثيرة، تحدثت مع أهلها، أكلت ونمت وضحكت معهم، تربطني بهم علاقة قرابة ورحم، فتعيد لي فضاءات من عمري الذي ولىّ، وأحن إلى أصدقاء فارقتهم، وأشتاق لرؤيتهم أكثر من اشتياق الظمآن إلى قدح ماء في ظهيرة تموزية!.
منحني هذا الشعور حرصا على أن لا تنتهي هذه الرواية، أن تطول إلى الأبد، فقسمتها على أقسام صغيرة، وآليت على نفسي أن أقرأ يوميا قسما واحدا منها، أبدأ بقراءته بعد الحادية عشرة ليلا، لكي لا أخالف القاعدة فأستمر بالقراءة إلى النهاية، فعشت على مدى عدة أيام مراحل طفولتي وشبابي من خلال حوار الرواية وأحداثها الملتهبة؛ التي تعنيني حرفيا، ولكني ما إن وصلت إلى الجزء الثاني منها حتى فقدت التوازن، ورفضت التقييد، وخالفت القانون الذي وضعته بنفسي، فاستغرقت في القراءة وبشكل نهم، ومع كل صفحة أطويها، كانت توقعاتي عن الحدث تتغير، والحوار يزداد سخونة حتى أكاد أتحسس نيرانه، وخوفا يزداد من أن تنتهي الرواية فلا أعود أتذكر معاناة قرية بسيطة أعرف أهلها.
بهدوء، وبقراءة متأنية، وبتقطيع للجمل، وتعمق في النظر إلى الحوارات، وإعادة قراءة بعضها عدة مرات، كانت الرواية تقترب من النهاية، ومعها كانت رغبتي تزداد عنفوانا بأن امنعها من الانتهاء. وبعد الثانية والنصف ليلا، طويت آخر صفحاتها والدموع تترقرق في عيني مثل طفل أخذوا منه لعبته.
مع انتهاء الصفحة الأخيرة أيقنت أن العنوان (سلام لم يعد يغني) هو أجمل وأفضل وأليق عنوان لهذه الرواية، وفيه من الرمزية ما ينجح في إعطائك مختصرا عن فحواها. أما صورة الغلاف التي بدت حينما نظرت إليها أول الأمر وكأنها اختيار ساذج، فقد كانت هي الأخرى ترجمة حقيقة لأجواء الرواية وطبيعتها، لا أعتقد أن غيرها كانت ستنجح في أداء هذه المهمة الصعبة.
أما اشتغالات الدكتور باسم وانتقالاته من حدث إلى آخر برشاقة راقصة البالية، ونجاحة في رسم الأحداث بريشة بيكاسوية، وتوظيف الحوار المناطقي، لهجة ولفظا للكلمة، واستخداما لكلمات بعينها، تنتهي بمدة قوية يمتاز بها أهل تلك القرية، فالهاء تتحول إلى ألف فـ(الماصوله) مثلا تتحول إلى (ماصولا)، فقد حول الرواية، ولاسيما لمن تعنيهم بالذات دون غيرهم، إلى استذكار لقصص الآباء، يروونها بأنفسهم وبلهجتهم، فهؤلاء بالذات هم الذين تستفز الرواية خزين ذكرياتهم، وتجعلهم يسرحون في دنيا الخيال للمقارنة بين أسماء أبطال الرواية، ورجال القرية الحقيقيين الذين يعرفونهم معرفة كبيرة.
إنك وبدون مبالغة تكاد من خلال الوصف والصور التي رسمها الأديب تشم رائحة الطين حينما يتحدث عن فليح البلام، وتشم عبق الغبار الذي يتطاير من الشارع غير المعبد حينما يتحدث عن مقهى أبو شكر، وكثير من اللوحات الموحية الأخرى التي نجح باسم في أن يجعلك تتفاعل معها بحيوية غريبة.
مضمون الرواية يكاد يكون مطروقا من قبل بكثرة، فهي تتحدث عن الخير والشر والطمع والعداء والكراهية والحسد والنفاق والدجل والسذاجة والفطرة، وأيضا عن الإخاء والتعايش بين الأديان، وعن الحب العذري، والأمل الكبير الذي يراود كل إنسان مهما كان بسيطا. واستخدام الأديب باسم للهجة الشعبية للقرية في صياغة الحوارات في الرواية، كان هو الآخر لوحة أخرى من لوحات الإبداع التي مارس طقوسها، اجتمعت كلها، ونجحت في تقريب المعنى إلى عقل وذائقة المتلقي، وقد تركت فيَّ أنا بالذات أثرا أكبر حتى من أثر الرواية نفسها، وهنا تحولت شكوكي من صحة وصلاحية وجود النص الحواري الشعبي في الرواية، وهو الأمر الذي تحدثت بشأنه مع الأديب الكبير شوقي كريم حسن، إلى يقين تام بأن الحوارات لو تمت صياغتها باللغة الفصحى، ما كانت لتنجح في إيصال الفكرة إلى المتلقي.
وبالمجمل أراد الكاتب من خلال تلك الحوارات أن يقول للإنسان: إنك قد تخسر الملايين، ولكن بمجرد أن تؤاتيك الفرصة، ستتمكن من إرجاعها، ولكنك مهما فعلت لن تنجح في استعادة الوقت الذي تضيعه!.
إن هذا العمل الأدبي الرائع والكبير بالرغم من كونه العمل الأدبي الأول للدكتور باسم ـ على حد علمي ـ إلا أنه علامة مميزة تنبئ بمولد روائي عراقي كبير.
جاءت الرواية في (396) من الحجم المتوسط، وصدرت عن دار ليندا السورية، وهي رواية جديرة بالقراءة.
 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل