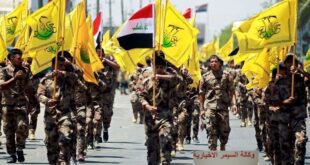السيمر / السبت 30 . 01 . 2016
فؤاد ابراهيم / السعودية
«نادم على سنوات قضاها في محاولة التقريب بين السنة والشيعة… وعلماء السعودية أنضج منه في موقفهم من الشيعة… وفكرة التقريب صبّت لصالح الشيعة ولم يستفد السنة منها شيئاً…». هذه خلاصة ما نقلته صحيفة «الشرق الأوسط» أول من أمس عن الشيخ يوسف القرضاوي. لم تحدّد الصحيفة متى وأين قال الأخير ذلك، خصوصاً أن كلاماً مطابقاً صدر عن القرضاوي في عام 2013.
ما يلفت في ملابسات الخبر أنّه تعمّد التجهيل كما في هذه الفقرة: «وأعاد القرضاوي نشر مقطع مصوّر له خلال مؤتمر لنصرة الشعب السوري عقد في قطر…» في إشارة إلى المؤتمر الذي قال فيه هذا الكلام في ذلك العام، ولكن من دون توضيح الكيفية التي من خلالها «أعاد نشر مقطع مصوّر» ومتى كان ذلك وأين، بما يوحي وكأن صانع الخبر تعمّد استدعاء حادثة سابقة وإدمادجه في حادثة متخيّلة، وعلى الأرجح لم تقع، أي أن لا كلام جديداً للقرضاوي في هذا الموضوع، وإنما هو إعادة نشر ليتناسب مع الحملة الطائفية المسعورة التي يقودها الاعلام السعودي. لا يعني ذلك أن الشيخ القرضاوي قد تراجع عن مواقفه الأخيرة، ولكن ثمة استغلال هابط لها في سياق التظهير الطائفي للصراع السياسي في المنطقة.
مهما يكن، فمن المناسب في ظل انفلاشات الخطابات الكليّة (الامة، العروبة، الانسانية) وانفجار الخطاب الطائفي بقرار سعودي، إنعاش الذاكرة ببعض الصوّر المشرقة في تاريخ هذه الأمة والتي نفخر كجيل تشرّب ثقافة التقريب على المستوى الاسلامي والوحدة على المستوى العربي، إذ من تلك الصور تشكّل وعينا العام في مقابل سدنة التقسيم والفتنة في الجزيرة العربية.
نستعيد حركة التنوير في آواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، حين برز عالمان كبيران وهما جمال الدين الافغاني ومحمد عبده لجهة التصدي للزحف الثقافي الغربي مدفوعاً بمشروع استعماري للمنطقة. تجاوز كل منهما عقده بما فيها العقدة المذهبية، واختارا الأمة إطار انتماء نهائياً، وشقّا طريقاً عاماً رئيساً خارج المنعرجات و»الزواريب»، وصنعا وعياً جديداً للأمة في ضوء فهم متجدّد للنص الديني، يجمع بين التقليد والتحديث والأصالة والمعاصرة. كان مصدر قوة هاتين القامتين يكمن في سؤال الهوية الذي لا يزال يتجدد كلما تناول باحث في سيرتهما الفكرية. هل كان الافغاني شيعياً؟ هل كان عبده سنيّاً خالصاً؟ كيف كانت علاقة الشيعي والسنيّ؟ هي أسئلة المأسورين بالماضي العبء وتراثه السجالي، أما بالنسبة للأفغاني وعبده فقد اختارا هوية الإسلام على أفقه الواسع، تلك هي «العروة الوثقى» التي لم تنفصم مذ أرسيا أسس وعي متين، فاعتصم بها جيل من التنويريين من أمثال عبد الرحمن الكواكبي ورشيد رضا والآخوند الخراساني ومحمد حسين النائيني والميرزا الشيرازي ومئات من الرموز الفكرية والدينية.
آثار الأفغاني وعبده غمرت المشرق الإسلامي برمته، وأطاحت «الأصنام الذهنية»، وأزالت الحواجز الوهمية. سوف يبدو الفارق جليّاً بين علماء المسلمين السنة والشيعة الذين تساموا على انقسامات التاريخ وعزلوه عن واقعهم للتصدي لقضايا الأمة، كل الأمة، وبين علماء الوهابية الذين استحضروا كل خصومات التاريخ (الخلافة، نزاع الصحابة، زوجات النبي، القرآن…). وبرغم من أن تلك الموضوعات بقيت عالقة منذ أكثر من ألف عام ولم يحسم الجدل حولها لعقم بعضها، وانتهاء صلاحية الأخرى، ولو سكت عنها أهل الخصومة لاندثرت. ولكن هناك من يستمد مشروعيته وحيويته من بقاء ورسوخ الانقسامات في الأمة يلجأ الى أوحال التاريخ ليغرف منها بما يبقيه حيّاً.
بالعودة الى جيل التنوير الذي اشتق الافغاني وعبده مساره في الامة، ونتوقف عند بعض المحطات المعينة على عقد المقارنة بين ما فعله علماء هذا الجيل في مقابل علماء الوهابية.
ولعب جمال الدين الافغاني دوراً توعوياً وتعبوياً وسط علماء المسلمين السنة والشيعة، وترك بصمات واضحة في حوادث سياسية كبرى منها ثورة التنباك وحركة المشروطة. وحذا باقي المصلحين حذوه في حث شعوب الشرق نحو مقاومة الاستعمار الغربي، فبرزت مجموعة مـن الاصلاحيين من العراق وايران وشرق الجزيرة العربية، تجمعوا في النجف الاشرف، حول الآخوند الخراساني (1839 ـ 1911) الذي كان يمثّل رمزاً روحياً وسياسياً لهذه المجموعة، بسبب موقعه الديني (المرجعية) واضطلاعه بالشأن السياسي في ايران والعراق بوجه خاص، وبلاد المشرق بوجه عام.
ونبدأ بالجزيرة العربية، وفي وقت كان عبد العزيز آل سعود يقود جيش الغزو (الاخوان) باحتلال الإحساء والقطيف في عام 1912، بعد تكفير أهلها، كان الشيخ حسن علي البدر القطيفي، أحد علماء الدين في القطيف، قد يكتب رسالة بعنوان «دعوة الموحدين الى حماية الدين» وهي رسالة في تحريض المسلمين على الجهاد لإخراج المستعمر الايطالي من ليبيا في عام 1913. وجاء في مقدّمة رسالته:
«اللهم إنّا نشكو اليك ما أصبحنا فيه من تفرّق الكلمة، وتشتّت الآراء، وشدّة الفتن، واختلاف الأهواء، وحبّ العافية، والركون الى الدنيا…». ووجّه نقداً لاذعاً لجنود الاستعمار الأوروبي الذين «جعلوا يشنّون الغارات على أوطاننا، ويوقعون الوقايع بإخواننا، حتى استولوا على الهند وغيرها، والسند والأندلس وتونس، واستعمروا مصر القاهرة، وأنشبوا مخالبهم بالبحرين وعُمان وأغلب سواحل جزيرة العرب، وشوّشوا إيران، وأخذوا قفقازية، وانتزعوا منّا هذه الأقطار العظيمة وغيرها مما يعجز عنها الحاسب، ويكلّ عن تعدادها قلم الكاتب».
في هذا المقطع يرسم الشيخ البدر القطيفي خريطة وعي الجيل الذي نشأ في تلك المرحلة. ورغم أن لا رابطة نسب ولا مذهب ولا مصلحة من أي نوع بينه وبين ليبيا، إلا أن ما تفصح الرسالة عنه ينبئ عن سمو الروح لدى هذا الجيل، فكانت وحدة الأمة نصب عينيه وملء قلبه.
في الوقت نفسه، أصدر إثنا عشر عالماً فتوى بعنوان «فتوى علماء النجف للجهاد ضد الطليان المستعمرين لليبيا» من بينهم محمد كاظم الخراساني، عبد الله المازندراني علي رفيش، محمد حسين القمشة، حسن محمد النجفي، محمد جواد الشيخ مشكور، محمد سعيد الحبوبي. وجاء في مقدمة الفتوى:
«الى المسلمين الموحدين كافة، وممّن جمعتنا وإيّاهم جامعة الدين، والإقرار بمحمد سيد المرسلين.
السلام عليكم أيّها المحامون عن التوحيد، والمدافعون عن الدين، والحافظون لبيضة الإسلام». واستنهضوا همم المسلمين كافة بما نصّه:
«ما لكم تبلغكم دعوة الإسلام فلا تجيبون؟ وتوافيكم صرخة المسلمين فلا تغيثون؟ أتنتظرون أن يزحف الكفار الى بيت الله الحرام، وحرم النبي والأئمة عليهم السلام، ويمحوا الديانة الإسلامية عن شرق الأرض وغربها، وتكونوا معشر المسلمين أذلّ من قوم سبأ؟».
في قراءة السياق التاريخي الذي صدرت فيه الفتوى أول ما يظهر أن مفهوم الامة الواحدة كان راسخاً في وعي علماء الأمة حينذاك. قد يكون وجود الدولة العثمانية كإطار جيوبوليتيكي جامع عاملاً رئيساً في المشاعر الوحدوية لدى علماء النجف، ولكن لا يمكن إغفال دور الخطاب التنويري الاسلامي في تعزيز مفهوم الامة الواحدة. السؤال: هل ثمة فتوى مماثلة من علماء الوهابية صدرت في هذا الشأن؟
ومع إعلان الدستور العثماني في تموز عام 1908، كتب الآخوند الخراساني والشيخ عبد الله المازندراني رسالة الى السلطان العثمانـي محمد رشاد، طالباً فيها المضي في تنفيذ بنود الدستور، وعدم الاصغاء الى المعارضين ومثيري الشبهات حول تطابق الدستور مع الشريعة، حيث رد الآخوند والمازندراني على هؤلاء بالقول: «فهل يمكن قيام الاحكام الشرعية بغير المشروطة وهل يمكن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا بقطع عرق الاستبداد، ومتى عارض القانون الاساسي الاحكام الشرعية، وفي أي مادة عارض الصوم والصلاة والحج والزكاة، ومتى أوجب غير المشروع وبدّل أصول الدين والفروع، فنأمل من سلطان الاسلام دامت افاضاته وبركاته عدم الاصغاء لكافة هؤلاء فإنهم إما اعداء وإما جهلاء».
وكان لدى علماء المسلمين رؤية واضحة إزاء الخلاف المذهبي وتأثيراته المدمّرة على واقع الأمة، وهذا ما خلص إليه مؤتمر بغداد عام 1908 بحضور كبار علماء الشيعة والسنة حيث أكد المؤتمر: «أن خلاف المذاهب الخمسة، والشقاق بين المذاهب الاسلامية، كان هو السبب الوحيد لانحطاط الامة الاسلامية، والعلة التامة لاستيلاء الاجانب على بلاد المسلمين».
وتأسيساً على هذا الوعي العميق بمشكلة الامة الحاضرة، أفتى كبار علماء النجف وكربلاء منهم: الآخوند الخراساني، والشيخ عبد الله المازندراني، وشيخ الشريعة الأصفهاني، والسيد صدر الاصفهاني والشيخ حسين المازندراني، بـ»وجوب اتحاد كافة المسلمين في حفظ بيضة الاسلام وحراسة جميع الممالك الاسلامية عثمانية وايرانية، وصونها من تشبثات الاجانب وهجوم الاعداء».
وبقيت علاقة علماء الشيعة في العراق بالدولة العثمانية إيجابية الى حد كبير، رغم ما كان ينتابها أحياناً من توترات نتيجة حيف ولاة السلطنة العثمانية في العراق. فقد أصدر المرجع الاعلى في النجف فتوى بضرورة مساندة الاتراك ومعاضدة السلطة العثمانية، وأعلن الجهاد ضد الانكليز في الحرب العالمية الأولى. وأحدثت الفتوى صدمة عنيفة للانكليز، إذ لم يتخيّلوا أن يكون الاحتلال الانكليزي عامل توحيد بين السنة والشيعة.
وتزامنت المبادرات من علماء المسلمين الشيعة والسنة إزاء إعلان «الحلفاء» الحرب على الدولة العثمانية وبدء الاحتلال الانكليزي بغزو ميناء الفاو في 6 تشرين الثاني 1914 فأصدر شيخ الاسلام، مفتي الدولة العثمانية في اليوم التالي، فتوى بوجوب الجهاد باعتبارها «فرض عين» على جميع المسلمين في العالم بما فيها الذين تحت حكم بريطانيا وروسيا. وفي يوم 23 من الشهر نفسه، صدر بيان بإذن السلطان وقعه شيخ الاسلام وثمانية عشر عالماً آخر موجه الى العالم الاسلامي وتلي في الممالك العثمانية كافة.
وأصدر علماء الشيعة فتاوى مماثلة تدعو للجهاد ومقاومة الاحتلال الانكليزي وتأييد العثمانيين في الحرب. وقد استفتى علماء البصرة المراجع الكبار للشيعة في النجف وكربلاء والكاظمية يطلبون فيها بمساندتهم ضد الانكليزي وبإثارة العشائر الشيعية في العراق، فألقيت فتاوى المراجع على الملأ العام في ساحات النجف وكربلاء والكاظمية، وأصدر محمد سعيد الحبوبي والسيد محمد كاظم اليزدي فتاوى لاستنهاض الشيعة في العراق، وقرر المشاركة في الجهاد بعد اجتماع موفد الحكومة العثمانية الى اليزدي، وأرسل الأخير نجله للنيابة عنه في استنهاض العشائر للجهاد، كما ألقى اليزدي خطبة في 6 كانون الأول 1914 في داخل حرم الإمام علي بالنجف جدّد فيها دعوته للجهاد وحث الناس على الدفاع عن مقدّسات المسلمين وبلادهم، وأكد ذلك حتى على الفتى العاجز بدناً لتجهيز الفقير القوي. وشارك في هذه الحرب، في جبهة الاتراك عدد كبير من علماء الشيعة البارزين ومنهم محمد سعيد الحبوبي الذي كان يحث العشائر الشيعية في العراق على الجهاد في صف العثمانيين ضد الانكليز كما حضر معركة الشعيبة الطاحنة.
وحين بدأت ترتيبات الحكم في العراق، كتب قائد ثورة العشرين الشيخ محمد تقي الشيرازي رسالة الى الملك فيصل الاول في صيف عام 1919 جاء فيها يحثّه على التصدي للحكم وقال له: «… نبدي لكم أننا لا زلنا نسمع أنباء تفاديكم العظيم، في سبيل إحياء الجامعة العربية، التي هي عنوان المجد الاسلامي». كما دعا في رسالته الى الرئيس الاميركي ويلسن خلال انعقاد مؤتمر باريس عام 1919 الى دعم خيار الشعب العراقي في «اختيار دولة جديدة عربية مستقلة إسلامية، وملك مسلم مقيّد بمجلس وطني».
وبرغم من الجور الذي لحق بالمكوّن الشيعي منذ قيام الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي وحتى سقوط نظام صدام حسين في نيسان 2003، فإن التشكيلات الحزبية الشيعية (حزب الدعوة، حركة الطلائع الرساليين) والمجموعات التي كانت تدور في فلكهما تمسّكت بالخطاب الوحدوي، وكانت تتغذى على أدبيات تشكيلات سنيّة مثل الاخوان المسلمين وحزب التحرير.
ومن نافلة القول، ليس صحيحاً الرأي القائل بأن الطائفية السياسية في العراق ولدت مع الاحتلال الاميركي في عام 2003، بل تعود الى بداية تأسيس الدولة العراقية. وقد جاء في مذكرة للملك فيصل الأول عام 1932 أي قبل ستة أشهر من وفاته «الضرائب والموت للشيعي والمناصب للسني». وكان نوري المالكي يحرص على الحفاظ على الهوية الطائفية للسلطة، أي تفوّق العنصر السني. ويكفي التمثيل المنخفض بصورة حادة للشيعة في الحكومات العراقية المتعاقبة.
وكان هاني الفكيكي كتب في «أوكار الهزيمة» عن عبد السلام عارف: «ونظرة عبد السلام الى الأكراد لم تكن أفضل حالاً من نظرته الى المسلمين الشيعة، اذ كان يردد باستمرار كلمة «الشعوبية» بالمعنى والقصد اللذين كان يستعملهما بعض الطائفيين في محاربتهم لعرب العراق الشيعة، وأذكر أننا، محسن الشيخ راضي وانا، وصلنا مرة متأخرين الى جلسات مجلس قيادة الثورة فقال عبد السلام: جاء الروافض، وكان يقصد بذلك أننا شيعيان».
على الضد، كان الخطاب الوحدوي لدى علماء النجف من كل المناطق التي جاءوا منها راسخاً في ثقافة التيار الديني العام. نذكر في السياق رسالة المرجع الشيعي الأعلى في العراق السيد محسن الحكيم (ت 1970) الى الزعيم جمال عبد الناصر بتاريخ 6 جمادى أول 1382 الموافق 5 تشرين أول 1962 جاء فيها: «إن صدور الحكم بالاعدام على سيد قطب وأصحابه موضع استياء المسلمين عامة والعلماء خاصة، وإن للعلماء حرمة يجب أن تراعى وتصان مهما كانت الظروف والأسباب فالأمل اهمال الحكم بالإعدام وتبديله باللطف والإكرام إن الله جلّ شأنه يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين».
الحكيم الذي ينتمي الى جيل التقريب بين المذاهب تبنى الموقف الديني المنسجم مع تكوينه الثقافي والفقهي والشرعي، وهو في رسالته كان متصالحاً مع ذاته ولم يكن مرغماً على فعل خارج نسق التفكير العام لدى جيل دعاة التقريب.
في المقابل، وفي الجزيرة العربية، وقبل أقل من عام على حكم الاعدام ضد سيد قطب، أصدر مفتى الديار السعودية الشيخ محمد بن ابراهيم، أحد أحفاد محمد بن عبد الوهاب، في 3 تشرين الثاني 1961 حكماً بالإعدام على الشيخ الشيعي عبد الله الخنيزي، من القطيف، لتأليفه كتاباً بعنوان «أبو طالب مؤمن قريش» يثبت فيه أن أبا طالب، عم النبي، مات على الإيمان.
في الأخير، إن محاولة الاعلام السعودي اختطاف وعي الأمة وتفجير التاريخ العبء في حاضرها تلبية لمصلحة فريق من الطائشين الذي يحكم الجزيرة العربية سوف تبوء بالفشل «وما يحيق المكر السيئ الا بأهله»، وقدر الأمة مهما بلغت مؤامرات خصومها في الداخل والخارج هو التعايش والوحدة، ولا خيار لها غير ذلك.
* كاتب من السعودية
الاخبار اللبنانية
 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل