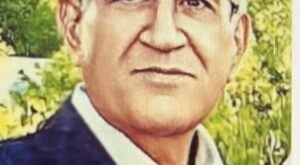السيمر / السبت 06 . 02 . 2016
عبد الله حبه
كان ينوي أن يسهد، لكن النوم فارقه بعد ان دقت ساعة القشلة معلنة منتصف الليل. وها قد مضت عدة اشهر وهو قابع في زنزاته الانفرادية التي تنبعث منها رائحة الرطوبة العفنة منذ ان صدر الحكم عليه ورفاقه بالاعدام. وعلى حين غرة راودته الافكار بصدد الدرب الذي اختاره في وقت مبكر من شبابه ليكون طريقه في الحياة، وفيما اذا يوجد معنى لهذا كله. فقد شب في بلاد ذات تاريخ عريق ارتبط بأسماء حمورابي ونبوخذنصر وآشور بانيبال وهارون الرشيد والمأمون. لكن اصاب هذه البلاد الخراب والدمار بعد اجتياح البرابرة المغول والتتار لبغداد ودمروها واحرقوها وقتلوا اهلها. وأعقبهم الاتراك العثمانيون الذين ارادوا طمس الهوية العربية وابقوا الشعب في اسر الجهل والتخلف. وكان لا بد من ان تستعيد بغداد حاضنة الحضارة العربية امجادها بجهود أهلها. وهذا ما آمن به السجين الذي اختار ان يمضى في طريق العمل من اجل تغيير النظام الذي فرضه الاستعمار البريطاني على العراق . ومضى في هذا الدرب بإصرار ومثابرة ، بالرغم من انه كان يعد نفسه في فترة الصبا ليصبح مهندسا، وهذا ما كان يريد له ابواه. غير ان فكرة غامضة سيطرت عليه تلبية لنداء داخلي مبهم بأن من الممكن بالرغم من كل شئ تغيير مجتمعه الذي سادت فيها العلاقات العشائرية والاقطاعية وسيطرة الاستعمار البريطاني. وترسخت هذه الفكرة لديه بعد ان إلتقى زملاء له في المدرسة شاركوه في رؤيته لمستقبل وطنه. وهكذا انخرط في التنظيمات السرية وصار يطالع الكتب المحظورة والمنشورات التي توزع في المدرسة واحياء المدينة سرا. وعانى ما عانى من حياة العمل السري والفقر بعد ان فقد العمل وملاحقات رجال الأمن ومن جراء تضعضع الصحة ووهن العافية.
وقطعت عليه حبل افكاره قطرات المطر الذي انهمر فجأة وصارت تدق زجاج النوافذ بعنف في دجنة الليل الغامضة والرهيبة. تواصل المطر بلا توقف حوالي الساعة. ودار في خلده ان الموت الذي ينتظره ليس شيئا مهما بالنسبة له الآن. فقد أعد نفسه منذ البداية لصعود الجلجلة من أجل قضية عادلة، بل واعتبره شيئا عاديا مثل الاكل والنوم . وكان قد نحل جسمه كثيرا وظهرت التجاعيد في جبينه واصاب عينيه الذبول خلال ايام وجوده في الزنزانة. ولم يهمه موعد أخذه الى المشنقة. وكان بعد صدور الحكم عليه يستلقي على سريره في الزنزانة ويستغرق في نوم عميق، و حين يصدف ألا يستطيع أن يجد فرصة الى النوم، فيسترسل في استعادة الذكريات الحلوة . وبانت أمام ناظريه صورة سمية حبه الأول والاخير وزميلته في الدراسة. كانت تنير محياها دائما ابتسامة آسرة كلما إلتقت عيونهما. فيكتفي هو بالنظر الى شعرها المحلول وصفحة جيدها وملاحتها الخلابة ولا سيما دقة الخصر وامتلاء الصدر. واذا ما تبادل الحديث معها كانت تجيب عن اسئلته المقتضبة برفق وكياسة وأدب. وبعد كل لقاء معها يغدو طافح القلب ممتلئ النفس بنشوة غامضة. وكان يود أكثر من مرة ان يكشف لها ما يعتلج في نفسه من أحاسيس نحوها، لكنه كان يشعر بالعجز في اختيار الكلمات. فهو خجول شديد الخجل ، وسريع التأذي. كما كان يبتعد عن هاجر الكلام وغليظ القول الذي غالبا ما يردده زملاؤه في الدراسة. وعندما حمله تيار النشاط السياسي السري الى ضفافه المجهولة، لم تبق في ذاكرته سوى صورة ابتسامتها وكأنها ابتسامة الجيوكنده.
وحملته الذاكرة ايضا الى جولاته الكثيرة مع أكرم صديق الطفولة في احراش النخيل حيث تنبجس احيانا قطعان الغنم او الابقار مع الراعي في منطقة الكاورية. وكانا يتذاكران هناك المواد الدراسية، او يجلسان على ضفاف دجلة حيث ترابط قوارب الصيادين. وكانا في بعض الاحيان يرتادان دور السينما في شارع الرشيد لمشاهدة الافلام الاجنبية، ذلك الشارع الذي يضطرب دوما بصخب وحركة ويجسد كل حيوية المدينة. ولا ينسى السجين ابدا رحلته الى البصرة حيث يعيش اقاربه. وهناك ركب المشاحيف وتجول في احراش الاثل وبساتين النخيل.
مضى الصبي متلصصا في مجاز البيت الطويل بعد ان بسط النوم جناحيه على الأسرة كلها. وكان والده قد أقام صلاة الفجر منذ فترة طويلة وعاد الى فراشه. وجثم على المكان سكون مرهق، وأصاغ السمع مرة أخرى. وخشى الصبي الذي عقد النية على ارتكاب “جريمة” السرقة ان يتعثر بشئ ما او تبدر عنه حركة قد تكشف وجوده هناك في تلك الساعة المبكرة… بعد محاولات سابقة عديدة لم يقيض لها النجاح. وكان هدفه صعود الدكة عند الباب وفك لمبة المصباح هناك ووضعه في جيبه والعودة الى فراشه دون ان يلحظه أحد. ولاحظ في الوقت نفسه وجود ورقة ما رماها أحدهم تحت باب البيت، وكان غالبا ما يجدها هناك في الصباح ، وقد اوصاه ابوه بأن يرميها في المزبلة في الزقاق”لاتقاء شرها”، حسب قوله. ولم يهتم الصبي بمحتواها ولو ان الفضول دفعه مرة لقراءة عبارة ” وطن حر وشعب سعيد” في أعلاها. وقد رمى بهذه الورقة كعادته في صندوق النفايات. ولم يرتفع الضحى من الغد حتى كان الصبي قد أخفى اللمبة في مكان أمين وانصرف الى هوايته المحببة في صنع الطيارات الورقية . ولم يكن يحب مشاركة اقرانه في الحي الواغلين في لعب الدعبل والكعاب أو الدخول في معارك بين الاطفال في الأزقة حيث يتم خلالها تبادل رجم الحجارة على بعضهم البعض وسط المعارك المحتدمة الوطيس بينهم.
قام الصبي في الغرفة الكائنة في اعلى البيت التي تحفظ فيها قطع الاثاث والافرشة الزائدة عن الحاجة بصنع ثلاث طيارات ورقية ملونة. وكان يحب صنع الطيارات ” الهنداوية ” أو ” الكشافية ” التي يعتبرها بمثابة مقاتلات تنقض على طيارات الخصوم من ابناء المحلة وتقطع خيوطها فتحملها الريح الى اماكن بعيدة. لكنه لم يصنع الا فيما ندر طيارة ” ام السناطير” التي يتقن صنعها اخوه الاكبر سعيد الذي لا يباريه احد في المحلة في ” المعارك الجوية ” بين ابنائها، وقد علمه اسرارها.
وبعد ذلك بدأ بأهم عملية وهي تزجيج الخيوط. ان الخيوط التي يتم تزجيجها بكثافها قادرة على قطع خيوط اية طيارة للخصم. وهذا يتطلب توفر المزيد من مسحوق الزجاج. فأخرج اللمبة المسروقة من المجاز وبدأ بتحطيمها ودقها بالهاون حتى اصبحت مسحوقا ناعما جدا. ونزل الى المطبخ حيث كان يجري طبخ الرز، فأخذ عدة ملاعق منه، وطفق بمزجه بمسحوق الزجاج . وعندما انجز ذلك صار يمرر كتلة الرز والزجاج على الخيوط المشدودة فوق سطح الدار وجلس بانتظار تجفيفها. وبذل قصاراه حتى ينجز العمل قبل ان ينكشف أمر اختفاء اللمبة .
ونزل الى باحة البيت مشرق الوجه متهلل الاسارير من أجل تناول طعام الفطور، في انتظار الساعة التي سيطلق بها طيارته “الهنداوية” التي ستبث الرعب لدى خصومه ولاسيما حسوني ابن الخبازة عدوه اللدود الذي طالما عانى منه الأمرين في المدرسة. وكان حسوني طويل القامة عريض المنكبين وأراد ان يفرض سلطته على جميع الصبيان في المحلة ولاسيما ضعفاء الجسد منهم. وقد آلى الصبي على نفسه ان ينتقم منه في المعارك الجوية. ولا ينسى الصبي كيف أنه لوى مرة ذراع حسوني ألاقوى منه جسدا، مما جعله يصرخ من الالم. ولحظتئذ اطلق الصبي ساقيه للريح ، لكن والد حسوني جاء الى ابيه واشتكى من فعلتي. ولكن الصبي لجأ الى حماية أخيه الاكبر الذي صار يرافقه الى المدرسة في كل يوم.
كانت الاصباح في بغداد أيامذاك باردة، فصعد الصبي الى السطح مرة أخرى بالرغم من ممانعة أمه. لكن رافقته اخته خولة الطالبة في الكلية التي غالبا ما حنت عليه وشجعته على هوايته. وهي فتاة كتوم لا تفشي الاسرار. وسألته من اين اخذ الزجاج من اجل تزجيج الخيوط، فزاغ بصره وكتم انفاسه. ولم يجب عن سؤالها اجابة تشفي الغليل ولم ينبس بحرف. ولحظتئذ سمع صراخ الأب الذي اكتشف فقدان اللمبة في المجاز. لكن سرعان ما هدأ الصراخ ويبدو ان الأم تدخلت في الأمر . وبعد قليل ارتفعت في الجو الطائرة الهنداوية الثلاثية الالوان ووجه الصبي “المقاتلة ” نحو الخصوم في الازقة القريبة. فقطعت خيوط بعضها وحملتها الرياح بعيدا بينما عاجل البعض الى انزال طياراتهم لتفادي المواجهة معه، ولم ترتفع في الأجواء سوى طيارة حسوني. وطال الأسى نفس الصبي.اذ كان يتمنى ان ينقض عليه بعد ان صنع خيطا مزججا قادرا على قطع غصن شجرة.
جلس المحكوم عليه بالاعدام في سيارة السجن المغلقة السوداء برفقة شرطيين يرتديان الزي الشتوي للشرطة بسدارتين وسراويل قصيرة ويمسكان ببندقيتهما. ولاحت على وجه المحكوم ابتسامة خجولة كما لو انه يعتذر لهما لإزعاجهما وارغامهما على مرافقته. كانت السيارة تطلق زحيرا وتطقطق بين حين وآخر. وفجأة توقفت السيارة وأخرج منها، فوجد نفسه في ساحة تنمو فيها شجيرات الدفلة وفي جانب منها تنتصب المشنقة. وتم تطويق المكان كله بصف من رجال الشرطة الذين يرتدون الخوذ الحديدية ويحملون البنادق، بينما نصب مدفع رشاش بإتجاه الشارع الرئيسي. كانت الشمس ساطعة بعد طلوع الفجر واقتادوه الى المشنقة وصعد درجاتها بخفة، وبغتة رأى أمامه كائنا له وجه قنفذ ومنفوش شعر الرأس وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة تلمع بينها اسنان ذهبية. أنه الجلاد المكلف بشنقه ورمى القنفذ جانبا السيجارة التي كان يدخنها. فوضع مساعده القيود في يدي وساقي المحكوم بالاعدام. وغطي رأسه بكيس أسود. وصار أحد ما يتلو شيئا ما.
في تلك اللحظة حدث أمر مفاجئ. فقد تراءت امام أنظار المحكوم تحت الكيس صورة أمه في شبابها وهي تكفكف دموعه الغزيرة بعد أن ذبح أمام سمعه وبصره الحمل الذي كان يطعمه ويلاعبه طوال شهرين في حديقة البيت. ولم يصدق ان والديه يمكن ان يرتكبا جريمة السماح بذبح الحمل. واستبد به حزن شديد وكرب عظيم وسحت عيناه بدموع ساخنة. فصار يضرب أمه بكلتا يديه ويصرخ فيها. بينما كانت الأم تقبله وتعده بحمل آخر، وبانه كان لا بد من ذبح هذا في عيد الاضحى.
كانت أمه ذات جمال بارع وفتنة اصيلة، بعينين رائعتين تشبهان ان تكونا سوداواين تماما وبشفتين قرمزيتين، وصارت تنهال الدموع على خديها ايضا. لكن بعد ذلك الحادث ومرض ولدها الحبيب خلال عدة اسابيع بعد ذبح الحمل غشت وجهها الصفرة وابيضت شفتاها واصابها الذبول.
أراد المحكوم ان يتذكر تفاصيل ذلك الحادث لكن الجلاد فتح بوابة المشنقة.. وساد الظلام …
استيقظ الصبي في صباح ذلك اليوم بمزاج عكر غير مألوف حيث انه كان في ايام العطلة المدرسية نئوم الضحى ، لكنه فتح عينيه حين خبط أحد اخوته باب الغرفة. وقد راودته في الليل كوابيس مرعبة تتخللها الاحداث المرعبة التي كانت ترد في حكايات أمه عن الجن والسعلاة . فجلس في الفراش ذاهلا واجما مشرد اللب. أنه لن ينسى ما سمعه في العشية من حديث بين اخيه الاكبر واخته عن اعدام السجناء السياسيين. انه لم يكن يفقه من هذه الأمور شيئا لأن والده المتدين الورع كان لا يسمح بأي كلام في البيت عن الاوضاع السياسية ويعتبر ان التدخل فيها لا يجلب الى العائلة سوى البلاء والمحن.
بعد تناول الفطور لجأ الى ركنه المحبوب في البيت من اجل صنع الطيارات الورقية وممارسة الرسم. أنها الهواية التي غرسها فيه جيرانهم طارق الرسام الذي درس في اوروبا. وعندئذ جاءت اليه اخته وجلست صامتة وبانت على محياها علائم الحزن بشكل غير معهود. وسألته بحنان : ما رأيك لو علمت ان رجلا طيبا قد قتل؟ فأجاب ان قتل البرئ كما علمنا معلم الدين في المدرسة هو أمر شائن. واردفت اخته قائلة: لقد قتلوا انسانا لمجرد انه اراد الخير للناس وناضل من أجل ” وطن حر وشعب سعيد “. ولحظتئذ تذكر الصبي الاوراق التي كان يجدها تحت باب البيت وفيها هذه العبارة بالذات. ورجته خولة ان يرافقها الى الميدان حيث شنق هذا الانسان لأنها تخاف الذهاب لوحدها. لاسيما انه تجاوز سن اثني عشر عاما واصبح صبيا كبيرا، كما كانت تثق بأنه لن يبوح بسرها الى أي أحد. وفي الطريق تبادلا أكثر من مرة الحديث عن الذين يريدون الخير للناس بينما يزج بهم في السجن . وادرك الصبي أن لأخته الطالبة الجامعية علاقة بهؤلاء الناس.
كان جمهور كبير قد احتشد في الميدان المطوق من قبل رجال الشرطة المدججين بالسلاح . ولاحت من بعيد المشنقة ويتدلى منها جسد المشنوق بزي السجن البني والقيود في يديه وقدميه. وأقترب الصبي واخته من المشنقة فشاهدا لافتة معلقة من عنق المشنوق وجذب انتباه الصبي ان اظافر المشنوق في يديه البيضاوين مقلمة بعناية وان حذاءيه الاسودين قد صقلا بعناية. وفي هذه اللحظة طارت حمامة من حديقة المدرسة المجاورة وحطت فوق عود المشنقة. كانت الحمامة تتطلع الى تحت نحوالمشنوق وحشد الناس بفضول، كما لو كانت تريد معرفة ما يجري هناك من احداث. ودهش الصبي لرؤية الحمامة التي لا تخاف المشنوق.
انهمك الصبي طوال اليوم في صنع طيارة ” ام السناطير” ضخمة . وطلب مساعدة اخته خولة في الحصول على الورق السميك والاعواد اللازمة . ان صنع مثل الطائرة يتطلب جهدا كبيرا حيث يجب ان تضبط المقاييس ويتم اللصق باستخدام صمغ شديد من صنف خاص. كان ما شاهده في الصباح في الميدان قد ترك في نفسه تأثيرا كبيرا ، وجعل يفكر لأول مرة بمدى قسوة ووحشية البشر الذين يقتلون اخيار الناس لمجرد مطالبتهم باحقاق العدالة وازالة الظلم. وبعد صلاة العصر التي ادّاها الأب في غرفته، وقبل ان تغيب الشمس صعد الصبي الى سطح الدار حاملا الطيارة ” ام السناطير” وقد كتب عليها بالحبر الصيني عبارة ” وطن حر وشعب سعيد” ، واطلقها في الهواء حيث صعدت الى عنان السماء متهادية. ولم يجرأ احد من صبيان المحلة على التعرض الى الطيارة الضخمة ذات الخيط السميك، ووجد الصبي صعوبة في الامساك بها . وفجأة تراءى له ان الطيارة ليست وحيدة في السماء فهناك في اسفلها مشنقة.. مشنقة حقيقية! وفرك عينيه من اجل التحقق من رؤياه ، لكن المشنقة بقيت ترافق الطيارة . فأصاب الصبي الرعب وترددت في اذنيه همهمة صماء، وصرخ ثم اطلق الحبل من يديه وراحت الطيارة تحلق لوحدها مع المشنقة نحو الشمس . وبدا كما لو ان الشمس تدعو الطيارة اليها .
هبط الصبي الى غرفته واجف القلب وقد تملكته وعكة هستيرية، واستبد به كرب خانق ويأس مضن. ولم يجد من يبث اليه لواعج قلبه سوى اخته خولة التي احتضنته وواسته وخففت عنه ألمه، ولازمت فراشه عندما داهمته الحمى خلال عدة أيام . كانت تراوده كوابيس مرعبة. وخُيّل اليه انه يرقد في فراشه وقد شدت يداه وساقاه اليها بالحبال كالمصلوب. واراد التحرك من اجل القيام لشرب الماء فعجز عن ذلك. وفجأة صار السرير يتحرك في الغرفة وشاهد شقيقه الاكبر الى جانبه ورجاه ان يفك وثاقه لكن هذا بقي بلا حراك وكأنه لا يسمع ولا يرى . وتكرر الأمر مع أمه وأخته. فطفق يبكي ويتوسل ان يعطوه قطرة ماء او يحرروه لكن بلا جدوى . وأخيرا وجد السرير يتحرك في الزقاق حيث واصل الصبيان ألعابهم دون ان يلقي اليهم أحد أي اهتمام. واذا بالسرير يحلق في السماء بإتجاه الطيارة ” ام السناطير” والمشنقة !!
ثاب الصبي الى رشده وفتح عينيه فرأى أمه وأخته خولة إلى جانبه، بينما وقف أمامهما ابن عمه الطبيب وطمأنهما أن كل شئ على ما يرام ولا خطر على صحة الابن وستزول السخونة حتما، وقد مرت النوبة المرضية بسلام.
شباط 1963
 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل