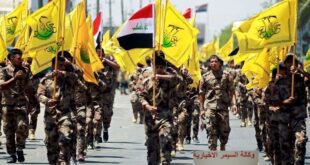السيمر / الاحد 11 . 06 . 2017
ضياء الشكرجي
هذه هي الحلقة الأولى بعد المئة من مختارات من مقالات كتبي في نقد الدين، حيث ما زلنا مع مقالات مختارة من الكتاب الرابع «الدين أمام إشكالات العقل».
مع مقولة «المرأة ناقصة عقل وحظ ودين»
على ضوء سؤال من القارئة المحترمة نسرين السامرائي، ونزولا عند رغبتها في تناول مقولة «النساء ناقصات عقول وحظوظ ودين»، لأجيب على سؤالها، حول ما إذا كان النص قابلا لتأويل آخر، غير المعنى الظاهر.
جوابا على سؤال السائلة المحترمة، أقول كل نص قابل للتأويل، وهذا يتوقف على فهم السياق، والإحاطة بالشخص الصادر عنه ذلك النص، وبلا شك أيضا على عقيدة المؤوِّل. ولكن المشكلة في الشخصيات التاريخية، لاسيما الدينية منها، إذ لا يمكن لنا الإحاطة بكل تفاصيلها، ولذا فإني غدوت أبتعد عن تقويم (تقييم) هذه الشخصيات، وعن اعتماد أقوالها وأفعالها كمرجعية، إيجابا أو سلبا، لأني لا أجد جدوى من ذلك، باعتبار أن الصواب والخطأ يمكن لنا تحديده بعيدا عن نصوص الدين وشخصياته التاريخية (المقدسة)، بحسب عقيدة المؤمنين دينيا أو مذهبيا بتلك الشخصيات، وأيضا بسبب عدم إمكان منح الثقة للروايات التاريخية المتعلقة بالإسلام وحوادثه وشخصياته، لأن معظم هذه الروايات بقية لأكثر من قرن تتناقل شفويا، وما يحيط علم (العنعنة)، أعني علمي الحديث والرجال من غموض واختلاف، وبالتالي عدم موثوقية معظم تلك الروايات، على الأقل بالنسبة لي.
ومع هذا، بالنسبة لسؤالكِ، أقول هذا يتوقف على فهم المرء لشخصية علي بن أبي طالب الذي يروى عنه النص موضع البحث. فإذا كان معصوما، حسبما يعتقد الشيعة الإمامية، فيفترض ألّا يصدر عنه ما يتعارض مع مبادئ الإنسانية والعقلانية، هذا بالنسبة للعقليين منهم، أما بالنسبة للنصيين، فألّا يتعارض مع ثوابت الدين. ولو إن العصمة، لو صدقت، تبقى نسبية، وليست مطلقة، والقول بنسبيتها هذا يصح حتى باعتماد عقيدة المذهب الشيعي وفق رؤية معتدلة، أما غلاة الشيعة، فيقولون بأن العصمة مطلقة، بحيث يجعلون المعصوم إلها، ولو بقرار من الله نفسه، بحيث تكون ألوهيته في طول ألوهية الله وغير مستقلة عنها، هذا دون أن يقولوه، بل كمحصلة لعقيدتهم، أي الغلاة، مع إن ممن أعتبرهم غلاة، هم من غير فرق الغلاة بحسب المصطلح المتداول. ومن هنا إذا كان علي معصوما حقا، أو إذا لم يكن كذلك، بل يمثل شخصية عُرِفَت بالعدالة والإنسانية من جهة، وبالحكمة والعقلانية من جهة أخرى، فلا بد من افتراض أحد أمرين؛ إما إن هذه المقولة المنسوبة إليه مشكوك نسبتها إليه، بل قد تكون مكذوبة عليه، وإما إذا ثبت يقينا أنه قد قالها حقا، فإن كان كما عُرِفَ عنه، فلا بد أنه يقصد بها غير الذي يُفهَم من ظاهرها، إلا إذا كان يمثل مبنى للدين الإسلامي، وهنا يكون هذا الدين، إذا كان حقا هذا مبناه غير إلهي المصدر، أو لا أقل مشكوكا في إلهيته. طبعا أنا أتكلم هنا بشكل متجرد، أو هكذا أحاول، بقطع النظر عن العقيدة التي أعتمدها. ولندع الباب مفتوحا أمام احتمال ثالث، ألا أن عليا كان يتحلى بتلك الصفات الكمالية النسبية (دون العصمة)، وهذه تمثل إحدى كبواته.
بالنسبة للنص القائل: «النساء ناقصات عقول، وناقصات حظوظ، وناقصات دين»، ففيما يتعلق الأمر بدعوى النقص في عقل المرأة، فإذا أردنا تأويل هذه العبارة، أو هكذا يؤولها البعض في ضوء النظرة الدينية، فنقص العقل يُستَدَلّ به بأن شهادتها نصف شهادة الرجل. وهذا دليل بائس، فإذا كان هذا التشريع إلهيا حقا، فهو لا يمكن أن يمثل قاعدة عامة، بل جاء في ظرف معين ومحدد، وغير قابل للتعميم، بحيث يصبح حكما شرعيا يقضي بكون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، لأن هذا خلاف العدل الإلهي، ولأن ليس من دليل على أن المرأة بالضرورة تساوي بوعيها وبذكائها وبذاكرتها وبتقواها وبصدقها نصف ما للرجل من كل ذلك، بل الناس كأفراد، بقطع النظر عن الذكورة والأنوثة يتفاوتون في ذلك، والقاضي العادل والنزيه والحِرَفي هو من يستطيع أن يُميّز بين من يُعوَّل على شهادته أو لا، بقطع النظر رجلا كان أو امرأة، وللعلم إن عددا غير قليل من فقهاء الطائفتين لا يعممون الحكم بِعَدّ شهادة المرأة نصف شهادة الرجل في كل الأحوال. إذن هذا تبرير غير مقبول نهائيا لهذا القول. إذن إذا كان هذا الدين هو وحي الله، وكان علي معصوما، أو قل يمثل إلى حد كبير بقوله وفعله وإقراره هذا الدين الإلهي، فلا يمكن أن يصدر لا عن الدين الإلهي، ولا عن علي، مع فرض ما فرضناه، مثل هذا القول، وبهذا المعنى. أما إذا ثبت أن الدين هو الذي يؤسس لهذا التمييز الظالم والمجحِف وغير المبرَّر، وهذا ما أذهب إليه، فلا يمكن أن يكون هذا الدين دين الله، بل هو من صنع البشر. أما إذا أريد من هذا القول، وعلى فرض عصمة قائله، أنها ناقصة عقل بحكم غلبة العاطفة عند المرأة على العقل، بحكم أن العقل والعاطفة لا يكونان على الأعم الأغلب متكافئين عند أفراد الإنسان، ذكورا كانوا أو إناثا، إلا عند المعصوم عصمة كاملة، وقد قلت إن العصمة نسبية وليست مطلقة، وهنا تكون المرأة بحكم غلبة عاطفتها، إذا أخذنا العاطفة بمعناها الإيجابي، تكون أكثر إنسانية من الرجل، وبالتالي تكون قد فُضِّلَت عليه في هذا الجانب، وهو قد فُضِّل عليها بعقله لموضوعيته وقدرته أكثر من المرأة على التفكير بعقل بارد في القضايا المحركة للعاطفة، ويتطلب فيها الحكم بالعقل، ومنها قضايا العدل، بعكس قضايا الرحمة، التي تغلب فيها العاطفة، أي البعد الإنساني. من هنا يكون النقص في عقل المرأة نقطة إيجابية تُسجَّل لها، وكما تكون هي ناقصة في عقلانيتها وموضوعيتها، يكون الرجل ناقصا في عاطفته الإنسانية ومروءته ورحمته وحبه. طبعا ليس هذا مما أتبناه، وإن كان هناك من المفكرين غير الدينيين، من يقسم مكونات شخصية الإنسان إلى مكونات أنوثية وأخرى ذكورية، وفي كل إنسان، ذكرا كان أو أنثى شيء من النوعين الذكوري والأنوثي من مكونات الشخصية، تغلب المكونات الذكورية عند معظم الرجال، والأنوثية عند معظم الإناث، وقلت «معظم» لوجود حالات الاستثناء؛ مع هذا أقول هذا لا يجب أن يمثل رؤيتي، وإن اعتبرت فيها شيئا من الصحة، وإنما أقول هذا يمكن أن يكون ثمة تفسيرا أو تأويلا للنص المذكور، وسأعود إلى تسجيل التحفظ عليه، رغم إمكانية تفسيره تفسيرا إيجابيا. لكن مع صحة ما ذكر، فمن غير المعقول تعميم حكم، إيجابيا كان أو سلبيا، على كل النساء، وتعميم حكم آخر، إيجابيا كان أو سلبيا، على كل رجال، وعلى نحو الإطلاق في الحالتين، أو في الحالات الأربع.
أما كون النساء ناقصات حظوظ، ومفردة «الحظ» تعني هنا السهم أو الحصة، فلكون الإسلام شرَّع بأن يكون سهمها من الإرث نصف سهم الرجل. ولا أريد مناقشة هذا الموضوع، لكني أقول إذا كان هذا تشريع هذا الدين، فهذا مبرر للتشكيك ثانية بإلهيته، لأن كل التفسيرات والتبريرات، وأعرفها كلها، لا تقوى على نفي التمايز غير العادل، فهنا يقوم الدين نفسه بظلم المرأة، بجعل حصتها نصف حصة الرجل، ثم يعيب عليها أنها ناقصة الحظ، بمعنى ناقصة الحصة، الذي قرر هو أن تكون ناقصة، وحتى مع فرض عدم وجود ظلم في هذا الحكم، فلا يمكن أن يعاب ويُعَيَّر إنسان، امرأة كان أو رجلا، على حكم شرعي، يفترض أنه من تشريعات الله. نعم سيقولون – دفاعا عن أحكام الإرث – إن المرأة مفضلة بامتيازات مالية جمة بهذا التشريع، لأن كلا من الرجل والمرأة، إذا كانا كمثال شقيقين لنفس الأبوين، فورث هو ضعف شقيقته، عندما يدخل كل منهما في حياة زوجية، ويكون لكل منهما نفس العدد من الأطفال، ولنفرض خمسة أطفال، فالشقيق بما ورثه، والذي هو ضعف ما ورثته شقيقته، سيكون مسؤولا عن الإنفاق على نفسه، وعلى زوجته، وعلى أطفالهما الخمسة، بينما ورثت شقيقته نصف ما ورث هو، مع هذا تكون غير مسؤولة حتى عن الإنفاق على نفسها، بل يجب على زوجها أن ينفق عليها وعلى نفسه وعلى أطفالهما، حتى لو كان أفقر منها. نعم إذا ساعدته هي بطوع نفسها تكون مُثابة من الله، ولكن تركها لذلك لا يجعلها آثمة، وإنما يفوّت عليها ثوابا بترك الأَوْلى. لكن هذا الكلام لا واقع له، ففي الواقع يستحوذ الزوج – لاسيما الزوج الشرقي – على مالية زوجته، ويتصرف هو بها، بحكم القوامة «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَى النِّساءِ»، أو بحكم العرف الذي يسود حتى على الشرع. إذا قيل إن هذا ليس ذنب التشريع الديني، بل ذنب العرف، أقول ألم يكن الله المحيط علما بكل شيء ليعلم أن العرف سيؤدي إلى سوء استخدام هذا التشريع في غير صالح المرأة؟ وللكلام تفصيل وأدلة، أعرض عنها هنا. ولو فصّلت في الموضوع، لدحضت كل الأدلة المعاكسة. إذن هل نتهم الإسلام؟ أقول كما في المسألة السابقة، إذا ثبت إن هذا التشريع هو تشريع هذا الدين، فهو دليل آخر على عدم إلهيته، تنزيها لله سبحانه، وإذا ثبت باليقين أن الدين هو دين الله، من قبيل أن فرض المحال – عندي على الأقل – ليس بمحال، فلا بد من تأويل التشريع بطريقة تجعله ليس من الثوابت، وهناك من فقهاء الفريقين من يقول بذلك، ويعتبر أن التشريع لم يأت ليجعل للمرأة نصف حصة الرجل من الإرث كتشريع ثابت ودائم، بل أراد أن يجعل لها أصلا حصة من الإرث، بعدما كانت محرومة منه. أما المقدار، فجعله نصف حصة الرجل آنذاك، من أجل أن يكون مقبولا عند مجتمع كان يرفض أن ترث المرأة أصلا، إذا صحت الروايات. إذن وبحكم أن التشريعات غير ثابتة، بحكم قاعدة النسخ التي مورست لثلاثة وعشرين عاما، يكون النسخ جائزا، بل وأحيانا واجبا، من قبيل الأولى بعد أربعة عشر قرنا. أرجع إلى القول بكون النساء ناقصات حظوظ، فيما هي حصتهن من الإرث، فحتى لو سلمنا بأننا سنخرج بحصيلة، إذا ما طبق التشريع تطبيقا دقيقا، ولم يجعل خاضعا للعرف، بحيث تكون المرأة هي الرابحة اقتصاديا بالنتيجة، يُشكَل على ذلك، بأن المرأة التي تريد أن تحقق إنسانيتها، وتحترم شخصيتها، وتؤمن بتساويها مع الرجل، لا تقبل بالتمايز، حتى الذي يكون لصالحها، بل تريد أن تكون شريكة للرجل على نحو التكافؤ، ليس في الحقوق والامتيازات فقط، بل حتى في الواجبات والمسؤوليات، فتكون شريكة في إعالة الأسرة، تتحمل مسؤولية ذلك كالرجل، وتتمتع بامتيازاتها، بما في ذلك صلاحيات اتخاذ القرار فيها، دون قيمومة أو قوامة من الرجل، نعم باستثناء ما لها من امتيازات في التسامح معها في أن تكون مسؤولياتها متساوية تماما، لكونها وحدها التي تتحمل مهمة الحمل والإنجاب والرضاعة، مما يوجب التخفيف عنها في مسؤولياتها. ولكن في حالة عدم الإنجاب يكون الزوجان متساويين، ثم هما متساويان في تحمل مسؤولية تربية الأولاد، باستثناء الفترة التي تختص بها المرأة فسيولوجيا. نعم يمكن في حالات تقسيم الأدوار بين الزوجة والزوج، وقد تتغير المواقع، بحيث لو تهيأت فرص عمل للمرأة دون الرجل، لا بد أن ينهض هو بالمهام المنزلية، والعكس بالعكس. أما إذا كان كل منهما يعملان، أو كل منهما عاطلين عن العمل، فيتساويان في تحمل أعباء العمل المنزلي. وهذا ما يفترض أن يلزم به الدين، ولو إن هناك الكثير مما يثبت عكسه، ولكن مع فرض صحة أن الدين يفرض المساواة، فإن العرف غالبا ما يخالفه.
أما القول بأن المرأة ناقصة دين، فيقال لأن الإسلام شرع لها وجوب ترك الصلاة والصيام أثناء حيضها ونفاسها. وهذا كلام غير مقبول، لأنها إذا تركت الصلاة والصيام بأمر الله حسب عقيدتها، إذن الصلاة والصيام لها تمثلان معصية، وتركهما يمثل طاعة لله، حسب عقيدتها كما بينت، وإنما الأعمال بالنيات، إذن هي بهذا الترك لم تكن ناقصة دين. ولو كان الأمر كذلك لصح القول أن المسافر ناقص دين، لأنه يصلي في اليوم إحدى عشرة ركعة، بدلا من سبع عشرة ركعة، ويترك الصيام، إما جوازا كما عند السنة، أو وجوبا كما عند الشيعة. كما يكون المريض المعذور عن الصيام بسبب مرضه ناقص دين، والمعوق العاجز عن القيام في الصلاة ناقص دين، وهناك أمثلة كثيرة أخرى. ثم هناك مناقشة لحكمة ترك المرأة لبعض العبادات في فترات حيضها ونفاسها، وكأنها أصبحت غير طاهرة، ومع التسليم بلزوم طهارة البدن في أوقات العبادة، كان لا بد من منع الرجل من أداء هذه العبادات، عندما يصدر منه ما يخل بطهارة البدن، كأن يكون لديه نزف بسبب مرض ما، أو عند خروج قيح، أو ماشابه. وفي تصوري إن عدم طهارة المرأة أثناء الحيض هو مما تأثر به الإسلام باليهودية، وهو قد تأثر بها في الكثير الكثير. سيقول المؤمنون بإلهية الأديان إن هذا ليس تأثرا أو اقتباسا، بل من الطبيعي أن تكون هناك مشتركات في الأديان الإلهية، وهذا القول صحيح تماما، إذا افترضنا فعلا إلهية الأديان. نعم لو ثبت أن هذا تشريع الله، ولكون الله يتنزه أن يصدر عنه إلا ما هو موافق للحكمة والعدل، فلا بد من وجود ثمة حكمة وراء التشريع، وهذا ما يسمى في المصطلح الديني بالتعبد، أي التعبد بالنصوص الدينية وبتشريعات الدين، إذا؛ أقول (إذا) ثبت أن مصدره الله سبحانه، حتى لم لم تدرك الحكمة من وراء ذلك.
أما التحفظ الذي يسجل على هذه المقولة، مهما كانت التأويلات مقبولة، أي حتى لو أمكن تأويلها تأويلا إيجابيا، أنه بخلاف الحكمة أن يطلق شخص كعلي بن أبي طالب قولا يساء على الأعم الأغلب، فهمه ويساء تطبيقه من قبل الأكثرية، ولا يفهمه على النحو الصحيح إلا نخبة من أقلية ضئيلة. ومخالفة الحكمة لا تجوز على المعصوم، حتى لو قلنا بالعصمة النسبية، بل لا تجوز على الحكيم العاقل العادل، حتى لو لم يكن بمستوى العصمة. ومن هنا يكون التشكيك بأحد ثلاثة احتمالات، إما الشك بصدور هذا القول عن علي، أو الشك بعصمة علي، إلا إذا قلنا بالعصمة النسبية، فجوزنا صدور بعض الهفوات من المعصوم، وإما بعدم إلهية الدين الإسلامي أصلا. ومع القول بالعصمة النسبية التي تجوّز على المعصوم صدور بعض الهفوات منه، نقول لكن هناك مشكلة، ذلك إذا افترضنا أن المعصوم جرى اختياره من الله، كما هو الحال مع الأنبياء باتفاق المسلمين، أو كما هو الحال إضافة إلى الأنبياء مع الأئمة المعصومين، باعتبارهم منصوصا عليهم من الله، كما يعتقد الشيعة، لأن تدخل الله بنفسه لاختيار أشخاص لدور مهم وخطير، يجعل هؤلاء في موقع الأسوة والقدوة والمثل الأعلى، عبر توثيق وتزكية الله لهم، ومن هنا إذا أخطأ هؤلاء في بعض الأحيان، لن يستطيع الإنسان العادي، أي متوسط الوعي والذكاء، أن يميز بين ما يجب عليه الاقتداء بهم فيه، وما لا يجب، بل قد يجوز أو يجب مخالفته إياهم فيه. وهنا يكون التشكيك بحكمة الله ولطفه، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وهنا يطرح سؤال بالنسبة للموقنين بوجود الله وكماله وجلاله وجماله، كما هو الحال معي، إذا وقفنا بين أمرين، أن ننزه الدين على حساب تنزيه الله، أو ننزه الله على حساب اليقين بإلهية الدين؛ كيف سيكون خيارنا؟ هنا أحيل من يرغب في المزيد مما كتبت بهذا الصدد، إلى مقالتين كتبت إحداهما قبل ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، والثاني قبل سنتين وأربعة أشهر، أي بأحد عشر شهرا بعد الأولى، مع العلم إني الآن لم أراجعهما، لأحدد ما بقيت عليه، وما جرى ثمة تحول، أو تطور، أو رؤية مستجدة فيه. المقالة الأولى هي «أيهما حاكم في الدين على الآخر: وحي السماء، أم عقل وضمير الإنسان» في 27/02/2007، والثانية «هل يمكن التفكيك بين الإيمان والدين» في 29/01/2008. وهناك لديّ الكثير من الأفكار التفصيلية في موضوعة العصمة، دينيا وفلسفيا، إثباتا أو نفيا، وجوبا أو امتناعا أو إمكانا، إطلاقا لمعنى العصمة، أي القول أنها مطلقة، أو تحديدا لها، أي القول بنسبيتها.
خلاصة لا بد منها: الإسلام هو الذي يجعل قيمة شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، ثم يقول عنها «ناقصة عقل»، ويجعل حصتها من الإرث نصف حصة الرجل، ثم يقول عنها «ناقصة حظ»، وينهاها في بعض الأوقات عن الصلاة والصيام، ثم يقول لها عنها «ناقصة دين». كما لو دولة قطعت أيدي مجموعة من مواطنيها، ثم تقول عنهم إنهم ناقصوا عطاء، وبما أن الحقوق بمقدار العطاء، فهم ناقصوا حقوق.
وإذا صح القول عن علي «النساء ناقصات عقول، ناقصات حظوظ، ناقصات دين»، أو «المرأة شر لا بد منه»، فربما لما عاناه من امرأتين، عائشة وفاطمة، عائشة لما كان من حساسية بينه وبينها، فيما ظهر في قضية فدك، ثم خروجها عليه يوم كان خليفة، وفاطمة لموقفها المغالي في تشدده ضد الشيخين، ومؤشر ذلك أنه انفتح عليهما، وأنهى مقاطعته لهما بعد وفاتها. أو هل كان لعلي عقدة تجاه النساء؟ لا نعلم.
28/05/2010 (روجعت و وعدلت في 11/11/2016، ثم في 11/06/2017.
 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل