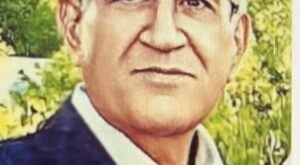السيمر / الثلاثاء 26 . 01 . 2021
فراس حج محمد/ فلسطين
تكون نفس الشاعر لحظة إنشاء النصّ محكومة لإيقاع ما، لا يدري كيف تأتي ولا كيف تذهب، ولذلك قد يحدث في الكتابة بعض “الانزلاقات” العروضيّة، فتفسّر على أنّها من الخلل العروضيّ الموسيقيّ التابع لعناصر الموسيقى الخارجيّة؛ التفاعيل والوزن العروضيّ، بصفته النسق العامّ للوزن الشعريّ، لأنّ ثمّة فارقاً بين الموسيقى الخارجيّة المؤطّرة بالوزن وبين الإيقاع، فالإيقاع قد يتلبّس تلبّساً تاماً بوزن عروضيّ ما، وقد يخرج عنه قليلاً أو كثيراً، ولا يكاد يحسّ الشاعر بذلك لحظة إنشاء النصّ؛ لأنّه عندما يكتب النصّ يكون الدافع إليه ما به من موسيقى خاصّة ناشئة من اللحظة التي يكتب فيها. ربّما اكتشف النقّاد أو القرّاء ذلك، وردّوه إلى خلل في العروض أو خطأ من الشاعر أو ضعف في موهبته الشعريّة، على الرغم من أنّ هناك شعراء كثراً وقعوا بمثل هذا المعدّ لدى منتقديهم خللاً عروضيّاً، وضعفاً في التمكّن من الوزن أو ما شاكل ذلك من تعليلات عقليّة منهجيّة. ولم ينتبهوا مثلاً إلى أنّ هذا “الخلل” هو المسافة الذاتيّة أو المساحة الشخصيّة الإبداعيّة التي ينتجها الشاعر وهو يكتب نصّه، فثمّة وزن عامّ، وثمّة إيقاع خاصّ مشتقّ منه، وليس شرطاً أن يتوافقا تماماً، فقد يخرج الشاعر عن عناصر الوزن المنضبطة إلى غيرها فيأتي النصّ مخالفاً في بعضه لتلك القواعد وقد تصل تلك المخالفة إلى أبعد من ذلك.
قد ينتبه الشاعر بعد حين إلى ما وقع فيه من انحراف موسيقيّ في الوزن لصالح الإيقاع الذاتي للنصّ، وذلك بعدما تهدأ نفسه ويتلاشى ذلك الإيقاع الخاصّ، ولم يبق في ذهنه إلّا العناصر الشكليّة العامّة للوزن العروضيّ، فيضطّر كغيره إلى مراعاتها والعمل على النصّ لتعديله ليتوافق توافقاً تامّاً مع عناصر الموسيقى، لأنّه سيكون- في الغالب- غير قادر على استعادة ذلك الإيقاع الناشئ لحظة ولادة القصيدة. فيأخذ بتأطير ذاته الخاصّة وتدمير مساحته الشخصيّة وإرغامها على أن تعود إلى العامّ، وبهذا يخسر النصّ خصوصيّته الإيقاعيّة التي حكمته وكانت سبباً في تميّزه واختلافه وتنوّعه ضمن الإطار العامّ لنسق الموسيقى المتعارف عليه.
إنّ الإيقاع أمر خاصّ بالشاعر، والوزن عامّ لكل من يكتب، والإيقاع حالة طارئة من الصعب أن تدوم، أو أن تظلّ حاضرة في النفس، لكنّ الوزن نظام موسيقيّ ثابت ومستقرّ، له قواعده المنضبطة بعكس الإيقاع، لذلك فالإيقاع لا يقاس عليه، ولا يعدّ أمراً مدرسيّاً منهجيّاً إلّا من حيث الإقرار بوجود هذه الحالة فقط، أمّا أن يتمّ تعلم الإيقاع فلا، فما يتمّ تعلّمه في المدارس والجامعات هو الوزن الموسيقيّ والتفاعيل والعروض، فهذه هي العناصر الثابتة في النظام الموسيقيّ للشعر العربي، والشاعر المتمرّس أكبر منها، وسيأتي عليه زمن ينقلب عليها أو يتفلّت منها، لعلّ إيقاعيّته تساعده على إنتاج أوزانه الخاصّة به، فالأوزان استقرائية أيضاً.
ربّما نجح الشعراء الموهوبون المسكونون بالموسيقى الخاصّة في إنتاج أوزان نابعة من إيقاع اللغة والتجربة والحسّ الداخليّ للنصّ، فقد سبق وأن أجاب أبو العتاهية من سأله هل تعرف العروض فقال: “أنا أكبر من العروض”، ولهذا الشاعر قصائد خارجة عن الأوزان المعهودة، و”لا تدخل في العروض”[1]، فالعروض للصغار ليتعلّموه، وأمّا الكبار فلهم موسيقاهم، وعلى النقّاد أن يرتقوا إليهم، ليفهموا الشعر والحالة الشعريّة ويفسّروا الإيقاع بناء على خصوصيّة تلك الحالة الشعريّة، ولا يحقّ لهم مطالبة الشعراء بوضع الأغلال في أيديهم وسجنهم في تلك الأوزان المقيّدة.
لم يستطع بعض النقّاد والعروضيّين أن يفرّقوا بين الوزن أو الإيقاع، واعتبروا أنّ الوزن هو الأساس، ولكن من يستقرئ الشعر والتجارب الشعريّة سيلاحظ اختلاف الإيقاع بين قصيدة وقصيدة في شعر الشاعر الواحد أوّلاً، وثانياً بين شاعر وشاعر آخر، حتّى وإن كان لتلك القصائد الوزن نفسه، إلّا أنّ كلّ قصيدة لها إيقاعها وجِرسها الموسيقيّ المختلفان عن غيرها من القصائد. ولعلّ الشعراء هم الأقدر على ملاحظة ذلك، ففي حوار مع الشاعر محمود درويش يقول عن هذه المسألة: “الإيقاع هنا ليس فقط ضبط الفكرة، إنّه طريقة تنفّس الشاعر، لذلك أقول دائماً إنّ الإيقاع ليس وزناً، فأنا أميّز بين الوزن والإيقاع. الوزن هو أداة قياس، وإلّا لكان الوزن الواحد ذا إيقاع واحد، الوزن الواحد الذي له إيقاع مختلف عند كلّ شاعر، لأنّ طريقة تنفّس كلّ شاعر مختلفة عن الآخر. الإيقاع أعمق من أن يكون فقط ضبط وزن، بل إنّ طريقة تنفّس كلّ شاعر في كلّ مرّة تتغيّر”[2]. ما تحدّث عنه درويش يعرفه جيّداً الشعراء المتمرّسون، ويجهله النقّاد، في أغلبهم، إلّا من كان له ذائقة شعريّة وموسيقيّة مدرّبة تستطيع لمح الاختلاف والتغاير.
هذه النظرة المتعمّقة في الإيقاع وطبيعة تكوينه ومنشأه، يلاحظها أحد محكّمي مسابقة “شاعر المليون”، فقد كان يركّز الشاعر الكويتي حمد السعيد على إيقاع النص، ويطلب من الشاعر إعادة قراءة بعض الأبيات ليتأكّد من إيقاع البيت المترابط مع الأبيات إن شعر أنّ خللاً قد طرأ على القصيدة، فيعود مرّة أخرى ليجبر كسراً قد ينشأ عن القراءة المجرّدة عن السماع، فالشاعر عندما كان يلقي نصّه يضيف إليه شيئاً من الإيقاع الصوتيّ الذي لا تستطيع اللغة حمله وتجسيده برموزها الخطيّة الكتابيّة. هذا واضح وضروري في الشعر النبطيّ، “الشعر الشعبيّ الخليجيّ والبدويّ”، والشعر العاميّ بشكل عامّ، فلا تكتمل إيقاعيّته إلّا بإلقائه، وربّما اشترك الشعر الفصيح ببعض هذا في تقطيع الجمل الشعريّة، وأماكن الوقف عليها، والتنغيم والنبر، والقراءة المعبّرة للأبيات المتّفقة مع المعنى في النفس، من أجل ذلك كان الشعر القديم القائم على الموسيقى الخارجيّة والإيقاع المتنوّع مسموعاً مقروءاً أكثر من أنّه فنّ كتابيّ مقروء، ففي قراءته بصمت يضيع الكثير من إيقاعيّته، ومن حقّ الشاعر ذاته أن يلقي نصوصه بنفسه ليصنع إيقاعها ويستمتع هو الجمهور بهذا الإيقاع، وليجبر إخلالاتها النصّ إن وجدت، إذ كانت مفروضة عليه بحكم اللحظة الشعريّة التي هي أكبر من الأوزان، وأكبر من قواعد الموسيقيّين المدرسيّين المنهجيّين المقيّدين بالقواعد والنظريّات، وأقصى حدودهم هو ما لاحظوه في الوزن من مظاهر الخروج على النسق النظريّ الكامل للبحر الشعريّ أو الوزن العروضيّ، وسمّوها “الخزم والخرم والزحافات والعلل والتشطير والتجزيء والإنهاك”، وكلها مصطلحات تشير إلى النقص والخروج عن النسق عند هؤلاء العلماء، لكنّها عند الشاعر مظهر من مظاهر الإيقاع المطلوب لحظة إنشاء النصّ ومتطلّب إبداعيّ مرتبط بالشاعر، وليس صحيحاً ما يدّعيه هؤلاء الموسيقيّون من أنّها ضرورات موسيقيّة أجيز للشاعر أن يواطئها لأنّها تتيح له الكتابة بحرّيّة أكبر ضمن قيود الوزن، لأنّه يكون محكوماً بتلك القواعد كما يقول هؤلاء النقّاد. إنّ الشعراء في حقيقة الأمر كانوا ينقادون إلى إيقاعاتهم الداخليّة الخاصّة، وليس كما اعتبرها النقّاد أنّها “رخص” و”إجازات” تجوز للشاعر ولا تجوز لغيره؛ هذه الإيقاعات التي فسّرها المنهجيّون بالإخلالات، وأعطوها أوصاف المرض أو العاهة.
لعلّ خضوع الشعراء الفطريّون الحقيقيّون الموهوبون إلى منهجيّة الموسيقيّين الحرْفيّة هي التي تحدّ من الإبداع، وتفسده، ولا تجعله منطلقاً، وربّما نجح الشعراء في الإفلات من قبضة هؤلاء السجّانين، لكنّهم بعد حين سيجدون أنفسهم مرّة أخرى مُلاحقين من هؤلاء المؤطّرين، لأنّهم سيحاولون تقعيد وتعقيد إنجازاتهم الشعريّة وفتوحاتهم الإيقاعيّة، كما حدث مع نقّاد شعر التفعيلة، وقد أخذوا بضبط الشعراء، وتأطيرهم في أطر من المسموح والممنوع في الموسيقى الشعريّة في هذا النوع من الشعر، لكنّ الشعراء يأبون الانصياع لمثل هذه القيود، ويظلّون في انطلاق حتّى لو أدّى ذلك إلى هدم المعبد على ما فيه من مقرّرات منهجيّة، كما فعل ويفعل شعراء قصيدة النثر، إنّهم “ثوار الشعر” بكلّ ما تعنيه الكلمة من معنى، وعلى النصّ- أيّ نصّ- أن يكون ابناً لشاعره في إيقاعه وتجربته وحرّيّته المطلقة، فلا حدود للإبداع، ولا حدود لتنوّعات الموسيقى، والشعر حدوده المطلق ليس غير، وعلى علماء الموسيقى العروضيّين أن يسلّموا بأنّهم سيظلّون تلاميذ بحضرة “أمراء الكلام”، كما سمّاهم يوماً الخليل بن أحمد عبقريُّ الثقافة العربيّة، “الشعراء أمراء الكلام، يصرّفونه أنّى شاءوا، ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى وتقييده، ومن تصريف اللفظ وتعقيده….، فيُحتجّ بهم ولا يُحتجّ عليهم، ويصوّرون الباطل في صورة حقّ، والحقّ في صورة الباطل”[3]، لقد جعلهم هم الأساس، حتّى وهو يؤطّر كلامهم ويشتقّ منه القوانين الموسيقيّة، إلّا أنّه لم يكن يتعامل مع تلك القواعد كأنّها حدود وحواجز، وإنّما مجرّد استقراء للكشف عن عبقريّة أمراء الكلام في اللغة العربيّة، بوصفها لغة موسيقيّة شاعريّة، لا تنضب تنوّعاتها اللحنيّة. ومع أنّ كلامه ليس مختّصاً بصنعة الإيقاع والوزن، إلّا أنّ له ارتباطاً بنشأة الشعر، وما يصاحب تلك العمليّة من عمل آخر مواكب للفكرة وإطلاق الكلام، كما يقول الفراهيدي. لقد حاول الفراهيدي أنّ يبيّن عناصر الوزن في القصائد العربيّة آنذاك، فكشف عن اثنين وعشرين وزناً شعريّاً مفترضاً، حسب نظريّته في التقليبات، منها ما هو مستعمل في زمنه أو قبل زمنه، ومنها ما وُجد عليه أمثلة بعد ذلك كالبحر المتدارك، فالفراهيدي لم يفته هذا البحر ليتداركه عليه تلميذه الأخفش، وإنّما لم يكن له أمثلة في النماذج التي استقرأها الفراهيدي، فهذا الوزن كان حاضراً في دوائره العروضيّة كبحور أخرى غير مستعملة كانت افتراضيّة عقليّة في دوائر الفراهيدي، استوعبت- نظريّاً- كل إمكانيّات الوزن الشعريّ بناء على ما هو موجود من أوزانٍ شعريّة، وظلّت غير مستعملة حتّى جاء ابن عبد ربّه الأندلسي وصنع لها أمثلة شعريّة- في كتابه “العقد الفريد”- تتوافق وتفعيلاتها المفترضة عند الفراهيدي.
ويبقى السؤال: هل هذه البحور الاثنان وعشرون هي كلّ بحور الشعر العربي، وإمكانية الإيقاع الشعريّ والموهبة الشعريّة العربيّة مقتصرة عليها، فلا يصحّ للشاعر أن يخرج عنها بوزن جديد أو إيقاع مختلف؟ لعلّ حركة الشعر العربي تجيب على السؤال ببلاغة واضحة، لكنْ يأبى الموسيقيّون التأطيريّون الاعتراف بهذه الرحابة الإبداعيّة في كلا المجالين؛ الوزن والإيقاع، ويصرّون على سجن الشاعر وشعره في قوالب لم توضع إلّا ليتحرّر الشاعر منها وينطلق ويحلّق بعيداً في فضاءات من الإبداع.
_________________
الهوامش:
[1] كتاب الأغاني، أبو فرج الأصفهاني، طبعة دار الكتب المصرية، 1950، ج4، ص13.
[2] محمود درويش- سنكون يوما ما نريد، إعداد مهند عبد الحميد، وازرة الثقافة، رام الله، 2008، ص69، من حوار مع درويش أجراه الشاعر اللبناني عبّاس بيضون.
[3] منهاج البلغاء وسراج الأدباء، أبو الحسن، حازم القرطاجني، تحقيق وتقديم: محمّد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، د.ت، ص143-144.
 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل