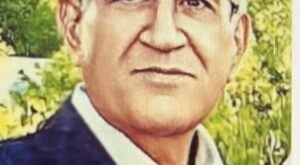السيمر / فيينا / الثلاثاء 20 . 12 . 2022
قراءة: عبد الستار نورعلي
(سعدي عبد الكريم): هو المبدع المتعدّد الفنون الإبداعية: هو السيناريست، الكاتب المسرحيّ، الناقد الأدبي، الفنان التشكيلي، والشاعر. وقبل كلِّ هذا هو الإنسان في رقيّ تجلياته القيمية.
هذا المزيجُ الفنيّ هو الذي منحهُ إبداعاً مائزاً تتشابك فيه هذه الألوان وتتناغم وتتعالق، لتنتجَ إبداعاً ملوّناً مثلَ قوس وقزح. حين تنظرُ في لوحةٍ مرسومةٍ
قصيدته (رئةٌ مثقوبة):
قرأتها عدة مرات. وفي كلِّ مرةٍ تمنحُني إحساساً مختلفاً.
أحسسْتُ كأني في النجف الأشرف على مشارفِ مقبرة وادي السلام:
“السّدرةُ الميتةُ في نهايةِ الزقاقِ
تذرفُ الدموعَ كلّما مرّتْ جنازة
………
احببتُكِ من ثلاثينَ عاماً
مذْ كانتْ مراسيمُ الدفن
يتكفلُ بها الشحاذون
والباعة المتجوّلون”
فالموت والدفن: ثنائيةٌ تذكّرنا بوادي السلام في النجف الأشرف، حيثُ اعتدنا دفنَ أحبابنا.
في المرّة الثانية منحتني إحساساً آخرَ: كأنّني في صريفة من صرائفِ خلف السدة في بغداد أيام زمان، وما كانتْ تحتضنُه تحتَ سقوفها المثقوبة منْ حكايات عن الفقرٍ، والمعاناةِ، والحرمان، والصبرٍ على ضيم الزمان، وقصص حبٍّ خفيةٍ عن الأعين، والتقلُّبِ منَ الألم على سطح صفيحٍ ساخنٍ منَ القهر:
” أحببتكِ بحجمِ أيامِ الصبرِ
أيامَ كنّا ننتظرُ الشمسَ تطلعُ علينا
من كُوّةٍ في صفيحِ السقفِ
تُظلِّلُ بيتَنا القديمِ
أحببتكِ منذ كنّا حفاةً.. وجِياعاً
نتقاسمُ رغيفَ الخبزِ مع القططِ السائبةِ”
ثمَّ تقلّبْتُ مع إحساسٍ آخر: وهو وطأة الأيام على كتفِ المعاناة، وتشبيهها بوطأة وثِقَل ظلمِ السلطةِ على أكتاف المُستضعَفين الرازحين تحت سوط الجلاد وقضبان السجنِ، وأيامِها الثقيلة على النفس. والشاعر هنا يرومُ أنْ يشيرَ الى دور السلطة في كلِّ ذلك الحرمان والقهر، ونضال الناس كي يخرجوا مِنْ مثل هذه البؤرةِ العميقة والثقب الأسود، والهواء الخانق المسموم؛ ليشمّوا هواءَ الله القريب منهم، وهم يدعونه للتخلّص من تلك الأيام، فهو السميع العليم: “وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ” البقرة 186:
” كانَ اللهُ قريباً..
والدعاءُ مبحوحَ الصوتِ
والأيامُ ثقال !
لم نعدْ نُميّزُ فيها بين سوطِ الجلادِ
وقضبانِ السجنِ”
وكذلك أعادتني القصيدة بما فيها منْ أحاسيس تذكُّرنا بالأماكن والناس والمعاناة والعلاقات الإنسانية، أعادتني الى أزقتنا القديمة في بغداد، أزقة باب الشيخ (مسقط رأسي) ومنشأ طفولتي وشبابي، وتربيتي، وأصحابي . وما كانت تحتضنه من قصص حبٍّ، ما زال بعضُها محفوراً في الذاكرة، تخطرُ بين حينٍ وآخرَ، يومَ تشتدُّ سُحُبُ الأيام. كما أنّها توثّقُ ما كانت تحمله مِنْ ثِقَل الإحساس بضنك العيش والحرمان، والتفاوت الطبقي بين عامةِ الناس الفقراء الجياع وبين الحاكمين الطغاة المُتخمين، الذين يبيتون مِلاءً بطونُهُم، وشعوبُهم يبيتون جياعاً خاويةً بطونُهم، مثلما صرخَ يوماً (الأعشى) في وجوهِ المُتخَمين مالاً وطعاماً، ولم يكونوا يُحسّونَ بتقلُّبِ أقربِ الناسِ إليهم مِنْ جَمْر الجوع والحرمان:
تبيتونَ في المَشتى مِلاءً بطونُكُمْ
وجاراتُكُمْ غَرْثَى يبِتْنَ خَمائِصا
“رئة مثقوبة” قصيدةُ تاريخٍ اجتماعيٍّ جمعيٍّ وفرديٍّ، حسّيّ، سياسيّ، مكانيٍّ وزمانيٍّ. إنها إدانة لنظامٍ قمعيٍّ نشرَ الخوفَ والفقر، كما هي تخليدٌ لنضالِ شعبٍ عانى الاضطهاد سياسيّاً وطبقيّاً، عندما مرّتْ على ذكر السجّان وسوطه وقضبان السجن، الى جانب وَقْعِ الجوعِ الثقيل.
أمّا البوحُ الشجيّ (الحوار الداخلي) مِنْ بطل القصيدة، والألمُ الكامنان خلف مناجاته لحبيبته، فقد منحاها حركةً ديناميكية درامية مسرحية، تُبيّنُ أثرَ الفنّ المسرحيّ ممتزجاً بالشعر، وشاعرُنا مسرحيٌّ محترف، كما نعلم، فلا غرابةَ عندها في هذا المزيج الفنيّ. إضافةً الى أنّها توحي بأنّنا أمام لوحةٍ مرسومةٍ بريشة الكلماتِ وألوان البلاغةِ:
حبيبان في زقاقٍ، بيوتُهُ سقوفُها منْ صفيح، تدخل الشمسُ من كوّةٍ فيها، قططٌ تقاسمُ الناسَ الخبزَ (الجوع)، قضبان السجن والسجّان (الطغيان والنضال)، سِدرة ميتة في نهاية الزقاق، جنازة تمرّ، طغاة مُتخمون، مراسيم دفن.
هذه لوحة فنيّة، لكنّها بالحروف والألفاظ وألوان اللغة.
فالقصيدةُ، مزيجٌ مركّبٌ، كما ذكرتُ، من ثلاثةٍ منَ الفنون الجميلة، التي احترفها أديبُنا الفنانُ درساً وإبداعاً.
أخيراً، وليسَ آخراً، لقد راودَني الحزنُ عنْ نفسي، وأنا أقرأها، فتمكّنتْ مني، ليجتاحَني احساسٌ، أعادَني حنيناً إلى الأيام الخوالي، والأماكنِ التي عاشرناها عيشاً ومحبّة، رغمَ المعاناة والضنك. وهذا يعني أنَّ عنصرَ المكان فيها أحدُ عناصرها الفنية الأخرى: مِنْ إحساس وعاطفة وبوح، وصور، ولغة، وتقنية فنية، وخيال. فكان كلُّ هذا هو الإطارَ المتكاملَ للوحةٍ شعريةٍ ملونة مرسومة بالكلمات، والمشاعرِ والخيال.
القصيدة:
* رئةٌ مثقوبة
لسعدي عبد الكريم
أحببتكِ بحجمِ أيامِ الصبرِ
أيامَ كنّا ننتظرُ الشمسَ تطلعُ علينا
من كُوّةٍ في صفيحِ السقفِ
تُظلِّلُ بيتَنا القديمِ
أحببتكِ منذ كنّا حفاةً.. وجِياعاً
نتقاسمُ رغيفَ الخبزِ مع القططِ السائبةِ
كانَ اللهُ قريباً..
والدعاءُ مبحوحَ الصوتِ
والأيامُ ثقال !
لم نعدْ نُميّزُ فيها بين سوطِ الجلادِ
وقضبانِ السجنِ
السّدرةُ الميتةُ في نهايةِ الزقاقِ
تذرفُ الدموعَ كلّما مرّتْ جنازة
تفتحُ (زيجها) وتدعو على الطغاةِ
والطغاةُ يأكلونَ لحمَ الضأن
ونحنُ نتقاسمُ ما تأكلُهُ الفئران
احببتُكِ من ثلاثينَ عاماً
مذْ كانتْ مراسيمُ الدفن
يتكفلُ بها الشحاذون
والباعة المتجوّلون
وفقراءُ الحيّ
العمرُ مرَّ سريعاً، يا حبيبَتي
ما بينَ رئةٍ مثقوبةٍ
وقلبٍ عليل
وأعوامٍ موزَّعةٍ بينَ غربةٍ
وحنين ..!
 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل