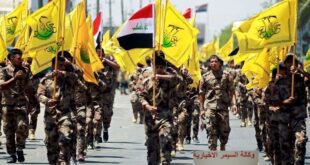السيمر / الأحد 02 . 07 . 2017
ضياء الشكرجي
هذه هي الحلقة الحادية عشر بعد المئة من مختارات من مقالات كتبي في نقد الدين، حيث نكون مع مقالات مختارة من الكتاب الرابع «الدين أمام إشكالات العقل». وفي هذه الحلقة مقالتان.
وتنشر هذه الحلقة اليوم في الذكرى العاشرة لتحولي في 01/07/2007 من الإيمان بالإسلام وفق منهج تأصيل مرجعية العقل، الذي اعتمدته للعشر سنوات الأخيرة، إلى المذهب الظني القائم على ثلاثة أسس، هي: 1- (العقلية)، و2- (التأويلية)، و3- (الظنية)، بمعنى اللاأدرية الدينية، التي تعتمد اليقين بالواجب العقلي (وجود الخالق)، والظن فيما يتعلق بالممكن العقلي (الدين)، حيث يتساوى منطقيا صدق الفرضية (الممكنة) أي الدين والوحي والنبوة، وعدم صدقها، لحين فحص أدلة أخرى ترجح إحدى الكفتين، والذي أي هذا الفحص، حسم في نهاية تشرين الأول من نفس السنة باعتماد الإيمان العقلي اللاديني (عقيدة التنزيه) أو (لاهوت التنزيه)، أي تنزيه الله عن نسبة الأديان إليه، واضعا في 26/10/2007 نهاية للمذهب الظني، باحتمال إلهية أو بشرية الدين أو ما يمكن تسميته باللاأدرية الدينية، حاسما تحولي إلى الإلهية اللادينية، وذلك بعدما توصلت إلى أن الدين مفهوما يبقى ممكنا عقليا، بينما كمصداق أو مصاديق من أديان أمامنا في الواقع فهي – وعلى نحو القطع الذي لا ريب فيه بالنسبة لي – ممتنعة الصدور امتناعا كليا بالمطلق عن الله. وهاذان التاريخان، تاريخ 01/07 كيوم للتحول إلى المذهب الظني، وتاريخ 26/10 كيوم للتحول إلى الإيمان اللاديني افتراضيان، لأنها كانت صيرورة لا يمكن تحديد مواعيد الحسم فيها بيوم محدد، لكني اعتمدت في تحديد التاريخين من خلال الرجوع إلى مقالاتي.
مصطلحات الإيمان والكفر والإلهية والإلحاد
بما أن الإيمان والكفر نسبيان، فيعني بالضرورة أن كل إيمان يختزن نسبة من الكفر، وكل كفر يختزن نسبة من الإيمان، أو إن الإيمان عند المؤمن بما يؤمن به ويعدّه إيمانا هو كفر عند غير المؤمن بما يؤمن ذلك المؤمن به ولا يعدّه إيمانا، بل قد يعدّه كفرا. من هنا إما علينا أن ننتزع من مصطلح الكفر معناه السلبي، أي المرفوض، ونعتبره توصيفا سلبيا بمعنى النفي، لا بمعنى اللامقبولية والمنبوذية والإدانة، كما ينفى عن شخص ما كونه طبيبا، أو كونه طويل القامة، أو كونه سياسيا، وهكذا، وهذا يختلف عن نفي الذكاء، أو الشرف، أو الضمير، أو الأخلاق، أو الإنسانية، أو الصدق، أو العدل، فالنفي من النوع الأول مفرغ من البعد القيمي، ولا يعد انتقاصا ممن تنفى عنه واحدة من الصفات، بينما النفي من النوع الثاني ذو بعد قيمي، ولذا فهو انتقاص ممن تنفى عنه قيمة من تلك القيم. فلو كان الإيمان والكفر، التوحيد والشرك، الإلهية والإلحاد من النوع الأول، فلا يُعَدّ إهانة أو انتقاصا عندما يقال عن شخص ما إنه كافر بالإسلام، أو بأي دين كان، أو كافر بعموم الأديان أي لاديني، أو حتى كافر بالله أي ملحد. ولكن في الواقع إن كلمة (كافر) مثقلة بكل المعاني السلبية، من انتقاص، وحرب نفسية، ونبذ اجتماعي، وكراهة وعداوة، بل في كثير من الحالات تهديد للحياة، وهكذا هو القول بالنسبة لكلمة (الملحد). ولكونه من الصعوبة بمكان انتزاع المعنى المنبوذ المثقل به كل من مصطلح الكفر والإلحاد، والكافر والملحد، لعله يكون من الأجدر إشاعة مصطلحات أخرى، ألا هي (الديني) وفي مقابله (اللاديني)، و(المؤمن) وفي مقابله (اللامؤمن)، و(الإلهي) وفي مقابله (اللاإلهي)، وكتوصيف للحالة، أن تستخدم مصطلحات (الدينية) و(اللادينية)، و(الإيمان) و(اللاإيمان)، و(الإلهية) و(اللاإلهية).
03/11/2009
أحاديث «لا يؤمن أحدكم حتى …»
هناك أكثر من حديث نبوي، يبدأ بعبارة «لا يُؤمِنُ أَحَدُكُم حَتّى …»، ثم يأتي ذكر خصلة، يجب أن يتحلى بها الإنسان، حتى يمكن أن تنطبق عليه صفة الإيمان، بحق وحقيقة. من أجل أن نكون موضوعيين، لنأخذ عبارة «لا يُؤمِنُ أَحَدُكُم حَتّى … [يحقق شرط كذا وكذا]» لا بالمعنى الحرفي في نفي الإيمان عمن لا يحقق الشرط المذكور في أي من تلك الأحاديث، بل نقول إن ذلك مقصود بالمعنى المجازي، أي لا بمعنى نفي الإيمان بالمطلق، بل بعدم تجذّره ورسوخه في نفس ذلك المؤمن، مما يجعل ذلك التجذر والرسوخ يتجلى بسلوك تلقائي، عبر تفاعل وجداني، منسجم مع القناعة الذهنية. ولو إن النبي الرسول ينبغي أن يكون خطابه واضحا مفهوما فهما دقيقا غير قابل للتأويل عملا بالقاعدة القرآنية «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقولوا قَولًا سَديدًا»، بحيث كان المفروض أن يقول «لا يُؤمنُ أحدُكم حقَّ الإيمان حتى …» أو «لا يكتمل إيمان أحدكم حتى …»، لأنه بحكمته المفترضة، ولكونه مسدَّدا من السماء عبر الوحي، ينبغي أن يعلم أن قول «لا يؤمن أحدكم» يفتح الباب أمام التكفير، بنفي الإيمان عمن لا يتصف بهذه الصفات كليا. وبعض أحاديث «لا يُؤمِنُ أَحَدُكُم حَتّى …» هي في غاية التألق الإنساني، ومنها:
•«لا يُؤمِنُ أَحَدُكُم حَتّى يُحِبَّ لِأخيهِ ما يُحِبُّ لِنَفسِه»: ما لم يقتصر مفهوم الأخوة على وشيجة الدين، كما تدل عليه معظم النصوص الأخرى، بل وحتى ذلك الحديث لعليّ، والذي لا يخلو من بُعد إنساني راقٍ في عهده لمالك الأشتر، عندما ولّاه على مصر يوصيه فيه بالرعية، لأنهم حسب تعبيره «إِمّا أخٌ لَكَ فِي الدّينِ، وَإِمّا نَظيرٌ لَكَ فِي الخلقِ»، فقد اقتصر فيه لفظ الأُخُوّة على أُخُوّة الدين. من هنا ومن خلال أن النبي الرسول يجب أن يكون كلامه دقيقا وقوله سديدا، كان يفضل أن يقول «حتى يحب لغيره ما يحب لنفسه»، إلا إذا كان تخصيصه مقصودا، ومجسدا لعقيدته، وهو الراجح من خلال كل النصوص القرآنية والنبوية الدالة على ذلك.
•«لا يُؤمِنُ أَحَدُكُم حَتّى يُحِبَّ لجارِهِ ما يُحِبُّ لِنَفسِه»: ربما يعمم البعض مفهوم الجار على من هو مسلم، ومن هو ليس مسلما، ويكون ذلك مفهوما إنسانيا راقيا، إن كان قد عُني بهذا المعنى، وبالتأكيد هناك ما يؤيد ذلك، ولكن هناك ما ينقضه.
•«لا يُؤمِنُ أَحَدُكُم حَتّى تكونَ فيهِ ثَلاثٌ: يَعفو عَمَّن ظَلَمَه، وَيُعطي مَن حَرمَه، وَيَصِلُ مَن قَطَعَه»: وهذا الحديث يجسد حقا حالة من السمو الأخلاقي، والألق الإنساني، مما يعتبر أنموذجا أمثل، فهو يتعدى الحد الأدنى للأخلاق الذي ورد في معنى أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إلى الحد الأعلى للأخلاق، وهو ما ورد معناه في نص قرآني غاية في التألق والرقي والسمو «وَلا تَستَوِي الحسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ؛ ادفَع بِالتي هِيَ أَحسَنُ، فَإِذَا الَّذي بَينَكَ وَبَينَهُ عَداوَةٌ، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَميمٌ» أي رد الإساءة بالإحسان، وفي الحديث آنف الذكر رد القطيعة بالتواصل، ورد الحرمان بالعطاء، ورد الإساءة بالعفو.
•«لا يُؤمِنُ أَحَدُكُم حَتّى أَكونَ أَحَبَّ إِلَيهِ مِن والِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنّاسِ أَجمَعين»: إذا صح هذا الحديث، فهو لو صدر من إنسان آخر، لقيل بحق إنه غاية في النرجسية، بحيث لا يكون المؤمن، مهما بلغ من إيمانه، وجسّده بسلوك مستقيم، وتعمقت تقوى الله في قلبه، مع هذا لا يكون مؤمنا حق الإيمان، ولا يكتمل إيمانه، ما لم يكن النبي أحب إليه من نفسه وولده وزوجته وأمه وأبيه وكل أحبائه. لو كان القول (حتى يكونَ اللهُ أحبَّ إليهِ من كلِّ أحدٍ، ومن كلِّ شيءٍ)، لكان ذلك مفهوما ومقبولا، بل ولعله مطلوبا، وفق فلسفة الإيمان. مع هذا أحب أن أثبِّت صحة المعنى الوارد، بشرط الإسلام. فإذا كان المقصود بعبارة «لا يُؤمِنُ أَحَدُكُم» هو الإيمان بالإسلام، فمن غير شك، إن الإنسان الذي يؤمن أن الإسلام هو دين الله، بل هو خاتم الأديان، وعُصارة وزُبدة الرسالات الإلهية كلها، وبالتالي أن الله قد اصطفى لأفضل وآخر وزبدة أديانه أفضل وعينة عباده، وبالتالي لا بد أن يكون أفضل الخلق أجمعين وسيدهم، ولا بد أن يكون «على خُلُقٍ عَظيمٍ»، وبالتالي لا بد أن يكون هو أحب الخلق إلى الله، وبالتالي وبالضرورة أحب الخلق بالنسبة لمن يؤمن بالله، ويؤمن بمحمد نبيا ورسولا، وبدينه وحيا إلهيا، على نحو ما ذكرت، ومع هذا أجد من الصعوبة أن يتوصل كل مؤمن بهذا الدين أن يصل إلى هذه الدرجة من الحب للنبي عنده. لكن إذا توصلنا إلى أن هذا الدين صناعة بشرية، وليس وحيا إلهيا، فمن البديهي أن صانعه يعلم بذلك، ومن هنا يأتي الاستغراب من جعله شرط اكتمال وتجذر وترسخ الإيمان بحبه فوق حب كل أحد، وفوق حب كل شيء، ما عدا الله. ولكن لو قالها، فقد قال عيسى إنه ابن الله، ولو إن القرآن ينفي ذلك، وقد يكون عيسى بريئا من ذلك، كما يمكن أن يكون محمد بريئا من بعض أو الكثير مما نسب إليه، لكن كما أكدت مرارا، إن التاريخ والسيرة والحديث، لم يكن الاهتمام الأساسي لهذا الكتاب، بل ركّز الكتاب على البحث الفلسفي لقضية الإيمان، والبحث القرآني فيما يتعلق بالإسلام، باعتباره النص المؤسِّس. لكننا نجد مثل هذه الأقوال مما يمكن نعته بحديث ألهنة أو أصنمة الذات في الكثير من النصوص الدينية، فقد قال في زماننا محمد محمد صادق الصدر إنه أعلم كل المتقدمين والمتأخرين من الفقهاء المجتهدين، وسنجد في التاريخ الديني أمثلة كثيرة على ذلك، ناهيك عمن لم يكتف بتفضيل نفسه على بقية الناس، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، ليجعل من نفسه ما فوق البشر، ويدعي لنفسه الألوهية، فلم يكن فرعون وحده الذي قال – إن كان قالها – «أَنَا رَبُّكُمُ الأَعلى»، أو «ما عَلِمتُ لَكُم مِّن إِلهٍ غَيري»، كما يحدثنا عنه القرآن.
انتهيت منه في 16/10/2012
 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل