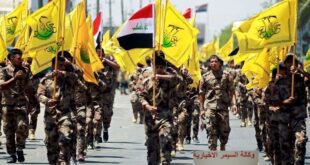السيمر / الجمعة 14 . 07 . 2017
ضياء الشكرجي
هذه هي الحلقة الخامسة عشر والمئة من مختارات من مقالات كتبي في نقد الدين، حيث نكون مع مقالات مختارة من الكتاب الرابع «الدين أمام إشكالات العقل»، وتشتمل على مقالتين قصيرتين.
الناطقون باسم الله لا يدعون إليه بل إلى الدين
كثير من المتدينين يتعاملون بطريقة، وكأن الواحد منهم هو الناطق الرسمي باسم الله. لكنهم في مزاولتهم للدعوة إلى الله، تطبيقا للآيات 125 من سورة النحل «اُدعُ إِلى سَبيلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجادِلهُم بِالَّتي هِيَ أَحسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبيلِهِ وَهُوَ أَعلَمُ بِالمُهتَدينَ»، والآية 33 من سورة فصلت «وَمَن أَحسَنُ قَولًا مِّمَّن دَعا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صالِحًا وَّقالَ إِنَّني مِنَ المُسلِمينَ»، والآية 108 من سورة يوسف «قُل هذِهِ سَبيلي أَدعو إِلَى اللهِ عَلى بَصيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَني وَسُبحانَ اللهِ وَما أَنَا مِنَ المُشرِكينَ»، لكنهم من حيث لا يشعرون إنما يدعون إلى الدين، لا إلى الله، وإنما يعملون على أن يهدوا الناس إلى الدين، متوهمين أو مدعين أنهم يريدون أن يهدوهم إلى الله، بل تراهم، من حيث يعون أو من حيث لا يعون، يدعون إلى أنفسهم، مدعين أو متصورين أنهم يدعون إلى الله، وإذا كانوا من معتمدي الإسلام السياسي، فهم دعاة إلى أحزابهم. وجميل تعبير مؤلف القرآن، عندما قال في بعض ما أصاب فيه الصواب: «وَالله يَدعو إِلى دارِ السَّلامِ». ولكن هل يدعو الناطقون باسمه أيضا إلى دار السلام يا ترى؟ بل هم يصورون دعوتهم وكأنها دعوة الله، ويدّعون بذلك أنهم وحدهم من استحقوا أن يهديهم الله سواء السبيل، أو الصراط المستقيم، فهم المعنيون بالآية «وَيَهدي مَن يَّشاءُ إِلى صِراطٍ مُّستَقيمٍ»، ليكونوا هم بدورهم بهداية الله لهم كما يظنون، هداة للناس إلى الله، ولكن لطالما كانت دعوة الدينيين، أبعد ما تكون دعوة وهداية إلى الله وإلى السلام.
رسول الدين يقول: «ما أُريكُم إِلّا ما أَرى وَما أَهديكُم إِلّا سَبيلَ الرَّشادِ»، كما ويقول: «هذِهِ سَبيلي أَدعو إِلَى اللهِ عَلى بَصيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَني، وَسُبحانَ اللهِ، وَما أَنَا مِنَ المُشرِكينَ»، ورسول العقل يقول: «هذِهِ سَبيلي أَدعو إِلَيها عَلى بَصيرَةٍ ولا أقول قد أوحى إليّ ربي»، ثم يتابع رسول العقل: «وَسُبحانَ الله وَما أَنا مِنَ المُشرِكينَ، وَسُبحانَ الله وَما أَنا مِنَ المُدَّعينَ، وَسُبحانَ الله وَما أَنا مِنَ المُرسَلينَ، إن أنا إلا إنسان يوحى إليّ من لدن عقلي، وإني له لمن المنزهين».
أيعني فشل المشروع الديني فشل المشروع الإلهي؟
أي مشروع، يكون تأسيسه ورعاية خطط تنفيذه من قبل جهة عليا، متنفذة، حكيمة، ومهتمة بمشروعها وبنجاحه، لا بد أن تكون تلك الجهة قد وفّرت شروط نجاح مشروعها. وكلما كان المشروع مكلفا، ومحشَّدا له إمكانات هائلة، ومضحّىً من أجله بما لا يحصى من أرواح وأموال ووقت، كلما كانت أشد اهتماما في دراسة سبل نجاح ذلك المشروع، ودراسة العقبات التي يمكن أن تعتري طريقه، فتضع لكل حالة طارئة حلا لتجاوز الصعوبات وتلافي سقوط المشروع، وكلما كانت تلك الجهة صاحبة المشروع بعكس ذلك ملامة، إذا ما فشل ذلك المشروع، رغم كل الحكمة والخبرة والقدرة التي تتحلى بها تلك الجهة، ورغم كل التضحيات اللامحدودة، وعبر كل الزمن الطويل، والطاقات التي هدرت من أجل ذلك المشروع، لاسيما إذا أخذ مسار المشروع وطريق التحضيات في سبيله زمنا طويلا، كأن يكون عقودا، فكيف إذا استغرق قرنا أو قرونا؟
وكيف يكون الأمر، عندما يكون صاحب المشروع، المؤسس له، والراعي لتنفيذه، والمصطفي لقيادة عملية التنفيذ، من يُفترَض أن يكون أفضل الخيارات المؤهلة لذلك، عبر إحاطته بكل المرشحين للضلوع بمهمة قيادة المشروع وتنفيذه، ومعرفته الدقيقة التي لا يمكن أن تخطئ مثقال ذرة، بأحوال من أناط إليهم مسؤولية القيادة والتنفيذ، وخاصة عندما يمر على مشروعه ثلاثة آلاف أو ألفا سنة، أو ألف وأربعمئة سنة.
مشروع الله المفترَض، أو المدَّعى، أو المظنون، هو مشروع الدين، كوحي إلهي، وما يشتمل عليه من قاعدة فلسفية تمثل أصوله وأسسه وقواعده، ومن تشريعات تمثل فروعه المترتبة على تلك الأصول.
وهنا لنتساءل، هل حقق المشروع الديني ثمة نجاحا، أم إنه فشل فشلا ذريعا، أو إنه نجح بمقدار، وفشل بمقدار آخر، وعندها لِنَرَ هل نسبة النجاح هي الأكبر، أم نسبة الفشل. وهل النجاح إلهي، والفشل بشري، أو شيطاني، أو كلاهما يحسبان لله أو على الله.
لا نريد أن ننكر أن للدين ثمة منافع، كما لا يمكن أن ننكر أن له ثمة أضرارا. وسبق وأن عبرت عن ذلك فيما سلف من هذه المجموعة لكتب لاهوت التنزيه «يسألونك عن الدين، قل فيه منافع للناس»، ومن أجل أن أحتفظ بقدر من الموضوعية قدمت المنافع، عكس النص الأصلي عن الخمر والميسر حيث يتقدم الضرر، أو ما نعت بالإثم بقول «فيه إثم كبير ومنافع للناس»، بينما عبرت فيما يتعلق الأمر بالدين بقول «فيه منافع للناس وإثم كبير»، ثم أكملت العبارة، بنفس ما جاء في النص القرآني المتعلق بالخمر والميسر، إذ جاء «وإثمهما أكبر من نفعهما»، وهكذا قلت عن الدين «وإثمه أكبر من نفعه». وكلامنا عن الدين، بما هو في الواقع، بقطع النظر عما إذا كان هذا الواقع يمثل الدين في حقيقته، أم إنه مما صنع الناس من الدين على مر القرون.
مع هذا لنبدأ بمنافع الدين، وفي حديثنا عن منافعه، كما لاحقا عن مضارّه، سنسلم بفرضية أن الدين وحي إلهي وليس صناعة بشرية:
1.الإيمان بالله وما يلحق به: هنا نسأل، هل إن الله يا ترى بحاجة إلى أن يُعرَف ويُؤمَن به، أو حتى مع انتفاء حاجته تنزه عن ذلك، أيمكن القول إن له رغبة في أن يُعرَف ويُؤمَن به، كما يرد في الحديث القدسي «كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق، فعرفتهم بي، فعرفوني»، أم إن هناك فائدة من الإيمان تعود على الإنسان المؤمن نفسه؟ القول بحاجة الله إلى الاعتراف بوجوده، لا يمكن أن يكون مقبولا، وهو ما ينفيه حتى الكثيرون من لاهوتيي الأديان. وأما رغبة الله أو حبه بأن يعرف، مما جعله يخلق الخلق لهذا الغرض، وكأن كل الغاية من خلق الخلق، أو لنقل واحدة من أهم غايات الخلق، أن الله تفكر بنفسه، فأعجبته نفسه، بما يتحلى به من علم مطلق، وقدرة مطلقة، وحكمة مطلقة، فاستحيف ألّا يكون هناك من اطلع على عظمته وكماله، فجاءته فكرة أن يخلق خلقا، تكون شغلتهم الأولى أن يعرفوه ويؤمنوا به ويقروا بوجوده ووحدانيته وكل صفات عظمته ويعبدوه. أم معقول أن يعاني الله من عقدة أن يُعرَف ويُعترَف به؟ ثم الإيمان بأي فكرة، مهما كانت عظيمة، لا قيمة لها، إلا إذا انعكس ذلك الإيمان على صاحبها في فكره وسلوكه وأخلاقه. ربما يقال إنه انعكس على الكثير من المؤمنين، لكنه لم يفعل فعله هذا على من هم أكثر بكثير من الذين انعكس عليهم الإيمان إيجابيا. وسيرد الكثير من المدافعين عن الدين، إن الدين أكد على وجوب اقتران الإيمان بالعمل، وإذا لم يقرن الكثير من الدينيين إيمانهم بالعمل، والعمل الصالح على وجه التحديد، فهذا ليس ذنب الدين، وإنما ذنب أولئك الناس. إذن عدم اقتران الإيمان بالعمل عند الأكثرية الساحقة من المؤمنين بالدين، يدل على فشل مشروع الدين في مهمته هذه، ويشكك من حيث لا يشعر المشككون بعلم الله، حيث إنه توقع شيئا، ثم تبين عدم تحققه، تعالى الله عن ذلك.
2.عبادة الله: وكم يحب المسلمون ترديد العبارة القرآنية «وَما خَلَقتُ الإِنسَ وَالجِنَّ إِلّا لِيَعبُدونِ[ـي]». وبهذا يجعلون الغاية من خلق الله للناس والجنّ، إن كان للجنّ وجود أصلا، هو أن يعبدوه. وهذه هي الغاية الثانية، فالله تعتمل في داخله رغبات ملحة أن يُعرَف ويُعترَف به وبعظمته، وأن يُعبَد. أما إذا تكلمنا عن أثر العبادة على العابد، فقلة ضئيلة جدا استطاعت العبادة أن تهذب أخلاقهم، وتقوّم سلوكهم، وقد عرف مؤسس الإسلام وأهل بيته إن العبادة لن تؤثر في أكثر المزاولين لها. فالحديث النبوي يقول «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده إلا بعدا عن الله»، ويقول حفيده جعفر بن محمد الملقب بالصادق «لا تغتروا بصلاتهم وصيامهم، بل اختبروهم في صدق الحديث وأداء الأمانة» وهناك سلسلة أحاديث وروايات أخرى، مر ذكرها في بحوث عديدة في طيات كتب لاهوت التنزيه. وكلنا نعلم إن تحلي الإنسان بالصدق والأمانة وحسن الخلق لا علاقة له بالإيمان والعبادة، أي بالدين والتدين، فإننا نجد الطيبين الصادقين الأمناء في المتدينين وفي غير المتدينين، في المؤمنين وفي الملحدين، كما نرى السيئين الكاذبين الخائنين للأمانة وسيئي الخلق هنا وهناك. وقد خضصت فصلا عن العبادات وجدواها في هذا الكتاب. من هنا فمشروع الدين فشل أيضا في تحقيق الهدف من العبادة.
3.هداية الناس إلى ما هو أصلح لهم فيما يختلفون فيه: يقال دائما بما أن الناس يختلفون كثيرا، وفي الكثير من القضايا، فيما هو حسن وما هو سيئ، ولذا احتاجوا إلى الدين، وإلى الوحي الإلهي، والتشريع الإلهي، ليدلهم على ما تصلح به دنياهم وآخرتهم. لكن هذه المهمة لم تنجز من قبل الأديان، لاختلافها فيما بينها، ولاختلاف الرؤى والاجتهادات داخل كل واحد منها. من هنا فمشروع الدين في توحيد الناس فيما اختلفوا فيه قد أخفق هو الآخر.
4.التحلي بمكارم الأخلاق: الواقع عبر كل الزمن الذي تواجدت خلاله الأديان، ينبئنا، وكما مر في الكلام عن الإيمان والعبادة، أننا نجد كلا من حُسن الخلق وقُبحه في وسط المؤمنين وغير المؤمنين، وسط المتدينين وغير المتدينين. فالصدق، والعدل، والعفو، والتواضع، والعطاء، وإعانة المحتاج، وحب الخير للناس، ومعاملة الآخر بما يحب المرء لنفسه، وغيرها، كلها لا تأثير للدين والتدين عليها. إذن مشروع الدين أخفق في مهمته هذه أيضا، التي عبر عنها الحديث النبوي «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».
هذه كانت أهم فوائد أو أهداف ومقاصد الدين المفترضة، ووجدنا إنه كمشروع، يفترض أنه مشروع الله للإنسان، قد أخفق في تحقيق أي غرض من أغراضه.
وإذا ما قرأنا سورة الشعراء، نستطيع أن نعتبرها السورة التي تُقرّ بفشل مشروع الله، تعالى وتنزه عن ذلك. وهذا ما أتناوله في ختام هذا البحث.
بعدما تناولنا الفوائد المتوخاة من الدين، فإننا إذا أردنا تناول أضرار الدين، فهي تكاد لا تحصى، ولكن أشير إلى أهمهما:
1.كرس الاختلاف، فيما هو الاختلاف بين الأديان، بل الاختلاف داخل كل دين، مع فرض إن واحدا من هذه الأديان هو دين الله الحق، ساري المفعول وغير المنسوخ، وإن من بين كل طرق الفهم والاجتهاد لذلك الدين هناك طريق واحد واجتهاد واحد وفرقة ناجية واحدة تمثل مراد الله. ولم تقتصر المسألة عند الاختلاف المقبول فيما هو الاجتهاد البشري في التفاصيل، مع الاتفاق على الأصول، بل شمل الاختلاف في أهم أصول الديانات، هذا من حيث النظرية، أما من حيث الممارسة، فتعدى ذلك إلى العداء والتكفير المتبادل والاقتتال.
2.الحروب والعداوات وبحار الدماء والخراب والدمار، كل هذا الذي مورس عبر قرون باسم الله من قبل الديانات، وفرق الدين الواحد.
3.هدر القدر الهائل من الوقت والمال عبر الطقوس والشعائر والعبادات ومواكب الحجيج وغيرها، مما يعد هدرا لا حد له لطاقات الإنسان الفرد، وطاقات المجتمعات الإنسانية، التي أرادها الله أن تكون من أجل عمارة الأرض وتطوير الحياة، وليس هدر الوقت في عبادته، التي هو مستغن عنها.
4.معاداة العلم والعلماء في كثير من الأحيان، ومعاداة الفن والجمال في كثير من الأحيان أيضا.
5.تجميد الفكر بالمقدسات والنهائيات واللامسموح مناقشتها من الحقائق المدعى كونها مطلقة وإلهية المصدر، وتخريف العقول في كثير من الأحيان، وجعل الإنسان المتدين غالبا ما يستغرق بالغيبيات، معقولها ولامعقولها، فيفقده ذلك النظرة الواقعية للحياة.
6.إيجاب ما لم يفرضه الله، وتحريم ما لم ينه عنه الله، وإباحة ما لم يرخص به.
إذا قيل إن هذه الأضرار أو بعضها أو أكثرها، هي من أخطاء المتدينين، ولا يتحمل الدين الإلهي وزره، فهذا يؤكد فشل مشروع الدين، لأنه لم يستطع أن يصل إلى أتباعه، ناهيك عن سائر الناس، بصيغته الإلهية النقية، بل كان الله عاجزا عن حفظه، ولم تتحق مقولة «إِنّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ وَإِنّا لَهُ لَحافِظونَ»، ودليل عدم تنزيل الله له هو عدم قدرته على حفظه نقيا غير مشوب، مستقيما غير محرف، ولأن الله يتنزه عن العجز، حتى يعجز عن حفظ دينه وإنجاح مشروعه، ويتعالى عن الجهل، حتى يؤسس لمشروع لا يعلم أنه لن يحقق النجاح المرجو منه.
 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل