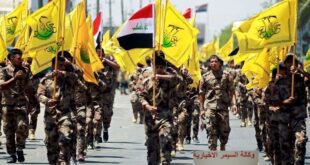الأربعاء 11 . 11 . 2015
نور أيوب
إنها الثانية فجراً. يفترش عبد الجليل، الشاب العشريني، أرض «روضة الحوراء زينب». يحتضن ضريح رفيقه الشهيد محمد حسين شقير، الذي استشهد في25 أيّار 2015. يشدّه لنفسه، وكأنّه يخبّئه، ويروح في سبات عميق.
■ ■ ■
لا يعلم أحد من روّاد «الروضة» متى غفا عبد الجليل، وكم من الوقت أمضى على هذه الحالة عند ضريح صديقه. لم يثر الأمر السؤال، بما أن الشاب لا يمثل حالة استثنائية هناك. لكلّ زائر للمكان «حبيب»، أو «أحبّة». يسهر معهم، يحضنهم، يحدّثهم، ويجدّد «الوعد» لهم.
محمد أحدهم. لا يعود إلى بيته قبل أن يمرّ على «الروضة»، ويمضي بعض الوقت فيها. يغيّر مع رفيقيه وجهة سهرتهم. يتوجهون إلى شمالي الضاحية الجنوبية لبيروت، بعدما كان مخططهم السهر في وسطها، في أحد مقاهيها. يبحثون عن مكانٍ يأنسون به، وينسيهم «هموم دنياهم»، فتكون الروضة ملجأهم.
منذ سبعينيات القرن الماضي، صبغت «روضة الشهيدين» المنطقة المحيطة بها، باسمها. فالبقعة الواقعة شمالي بلدة الغبيري، في الضاحية، احتضنت جثامين شهداء المقاومة، منذ الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن. مؤخراً، أُنشئت «روضة» جديدة، تبعد عن الأولى قرابة المئتي متر. يرقد فيها الشهداء المشاركون في «الدفاع المقدّس»، وتحمل اسم «روضة الحوراء زينب».
أنيسةٌ تلك البقعة. تضجّ روحاً برغم أن ساكنيها نيام. لم يخصّص الشهداء وقتاً لزياراتهم. أبوابهم مفتوحة طيلة الوقت، يستقبلون زوّارهم ويُنصتون جيّداً لمن يحدّثهم، ولمن يسألهم عن أحوالهم، وكأنهم اتخذوا من أضرحتهم عناوين لهم. باتوا مقصداً، و«كعبةً» يحجّ إليها «محبّوهم». ومع اختلاف المواسم والمناسبات، يزيّن «المحبّون» تلك الأضرحة أو «البيوت». فهم «كلّ مواسمنا» كما يقول محمود، الشاب الحريص على تزيين أضرحة رفاقه الشهداء.
زيّنت الأضرحة بعبارات عديدة. «هيهات منّا الذلّة»، «لبيك يا حسين»، «شهيد الدفاع المقدّس». مزركشة، مطرّزة، مموّهة، تمتد على أضرحة فاقت السبعين، جلّهم من شباب عرفوا طريقهم. وزاحموا موتاً قتلوه بصمتهم. تختصر ابتساماتهم وضحكاتهم الطريق إلى حتفهم، الذي اختاروه ولم يخترهم، وغلبوه ولم يغلبهم.
تتوسط «الروضة» صورة وحيدة كبيرة، وضعها رفاق الشهيد محمد إبراهيم. تقف صورته باحثة عن ضريح، أو عن جسد يدلّ على صاحبها «المفقود الأثر». تؤكد الصورة انتماء الشاب العشريني إلى هذا المكان، فطيفه حاضرٌ، وابتسامته تدلّك على شخصيته الهادئة والمحبّة. وألق عينيه يذيب الثلج الذي «ارتقى» منه.
تشرق شمس صباحٍ جديد. تزدحم «الروضة» بمحبّي الشهداء، كما في الليل. هنا أمٌّ تأتي كلّ صباح، تمسح ضريح ولدها، توقظه من نومه، وتحاكيه كأنه أمامها. «قوم يا أمّي… جيتك». تحدّثه، ويردّ عليها، وتدخل معه في عالم «تنقطع» فيه عن عالمنا. وعلى الطرف الآخر، تمعن النظر في وجه كلّ «مجالس» لضريح، فهو في نظر نفسه «مشروع شهيد»، ينتظر أن «يرتقي» ويلتحق «بسادة قافلة الوجود».
يمرّ الوقت بهدوء في «الروضة». يترجّل علي وحسين من على دراجتهما النارية. يقرآن الفاتحة على ضريح رفيقهما الشهيد محمد مهدي اللوباني. تقترب منهما، فترى دموعاً حُبست بين أجفانهما. تسألهما «هل تعرفانه؟» فيجيبان «نعم… ربيب حيّنا».
لم يكن علي منتسباً لـ«حزب الله»، إلا أن شهادة رفيقه كان لها وقعٌ خاص عنده. «منذ دفنه ونحن نأتي يومياً إلى هنا»، يجيب علي، الذي بات ينتظِر دوره اليوم ليلتحق بالدورة العسكرية. أما حسين، فقد لفّ يده بجبيرة. يأسف لوجوده هنا، إذ يرغب في العودة إلى موقعه. يُنهي اليافعان زيارتهما، يلقيان «سلاماهما»، ليعودا من حيث أتيا، مع وعد بتكرار رحلتهما اليومية.
على مقربة من ضريح اللوباني، انتخب بعض الشباب ضريح رفيقهم مكاناً للإلتقاء. يجتمعون عنده، «هو من يجمعنا، وثبّت الموعد كل أسبوع، كما كنّا».
عصر ذلك اليوم، كانت أم أحد الشهداء «العرسان» تتهيّأ لتوديع ابنها. تنثر ورداً وأرزّاً على التابوت الذي يحتضن جسده. تزفّه كأنها في ليلة عرسه. تهلّل وتزغرد له. توسّد التراب في لحده، وتودّعه، فقد أوصلته إلى حيث أحبّ.
تخرج أم الشهيد، يدخل «رفاق سلاحه»، ودربه. يحملونه على أكفّهم، وإن كان صامتاً. تكسر صيحاتهم وهتافاتهم ثقل الحزن، فيحيلونه عرساً. مضى «الحبيب»، إلى «كونٍ بأطراف الفضا». لن يروه جسداً، و«إن مسّه الفنا». بل سيكون طيفاً حاضراً عند كل زيارة.
■ ■ ■
لم يفترق عبد الجليل حمدان طويلاً عن «حبيبه». عاد إلى الروضة «عريساً» بعد 12 يوماً من استشهاد صديقه، واستقرّ بالقرب منه في 13 حزيران 2015.
الأخبار اللبنانية
 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل