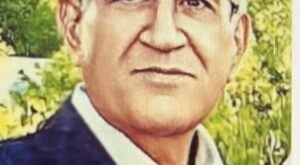السيمر / الاحد 10 . 12 . 2017
صالح الطائي
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في 18 ك1
في كل ثقافة إنسانية لابد في صميم أبجديتها: روح قتال، وفقر، وتعنصر، وعصبية، وخلافات فكرية، ومنافسة شديدة، وعالم أسفار وترحال وتنقل، وصحارى مقفرة، وسهول وجبال، ووحدة قاتلة، وروح ثأرية لا تهدأ إلا بالثأر، وتضييق في العلاقات، ووجع ومآسٍ، لابد وأن تجد سيلا عظيما من القصص والروايات والأمثال؛ التي تترجم كل مفصل من هذه المفاصل بسرد يرقى إلى عمق معناه، يرويها القصاصون أو القوالون، ليمجدوا من خلالها بطولةً، ونصرةً، وانتصارا لمنهج، ولحظة لقاء بحبيب، وشظف عيش، ومأساة، وفرح، سواء كانت تلك الوقائع صحيحة أم من صنع الخيال الجامح، أو من ادعاء فارغ لبعض الرجال الذين يفشلون أن يأتوا بمثلها على أرض الواقع.
وأرى أن تسمية القصة بهذا الاسم إنما جاءت لكونها تروي عادة حدثا ماضيا، قام الراوي بتتبع أثره، وتمحيص فصوله، وإعادة صياغته بتضمينه بعض التفخيم والتضخيم، ودمجه بالأساطير والأكاذيب والادعاءات، فهي تسمية مأخوذة من الفعل (قص)، والقص لغة كما قال الراغب الأصفهاني: “تتبع الأثر، يقال قصصت أثره: أي تتبعته”. جاء في الذكر الحكيم قوله تعالى: {قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا} (الكهف: 64) وقوله تعالى: {وقالت لأخته قصيه}(القصص: 11).
وهناك إشارات واضحة تشير إلى حقيقة هذا النحت المقصود والاقتباس اللفظي؛ بسلخ اسم القصة من فعل تتبع أثر الأقدمين (قص)، ففي كتب التفسير العديد من الإشارات الواضحة إلى أن القصص هي: الأخبار المتبعة، أي أخبار الأقدمين. قال تعالى: {إن هذا لهو القصص الحق}(آل عمران: 62) وقال: {لقد كان في قصصهم عبرة}(يوسف: 111). وهناك آيات كثيرة أخرى تؤكد هذا المعنى.
فضلا عن ذلك جاء في الذكر الحكيم قوله تعالى: {ولكم في القصاص الحياة}(البقرة: 179) و{والجروح قصاص}(المائدة: 45) والقِصاص هنا هو: تتبع الدم بالقود. أي تتبع أثر القتل بالقتل أو بالدية أو بكلاهما، وهو يدخل ضمن باب تتبع الأثر معنويا كان أم ماديا.
بل إن (القصيصة)، وهي شُجيرة صغيرة، تنبت عند حبة الكمأة، وهي التي يُستدل على الكمأة من خلال وجودها، أخذت أسمها من تتبع الأثر، لأنهم بتتبعهم لأثرها، يعثرون غالبا على الكمأة، فتتبع النبتة ييسر لهم أمر الحصول على الكمأة، ومن هنا، ولهذا السبب، أطلقوا عليها هذا الاسم.
المدهش في الأمر ان فن القص كان موجوداً عند العرب قبل الإسلام، ذلك المجتمع الذي يحمل الكثير من السمات التي عددناها في بداية الموضوع، حيث كانت لهم حكاياتهم وقصصهم وأساطيرهم؛ التي حاولوا من خلالها تمجيد أيامهم التاريخية التي عرفت باسم (أيام العرب)، حيث تحولت الايام على ألسنة الرواة الى مادة قصصية مشوقة، يجتمع الناس لاستماعها وهي تُتلى عليهم، ولاسيما وأن هناك الكثير من الأيام المشهورة في تاريخنا العربي لدرجة أن ابن الاثير عدد منها ما يناهز السبعين يوماً، والميداني ذكر مائة وثلاثين يوماً، ووضع معمر بن المثني كتابين في ايام العرب، اشتمل أحدهما على ألف ومائتي يوم، وهو عدد كبير تتشكل من وقائعه آلاف القصص، وتمد الفضاء الأدبي بمادة زاخرة بالحركة والمعنى. من هنا جاءت القصص التراثية عن (يوم حجر)، ويوم (ذي قار) ويوم (داحس والغبراء) وأيام (عامر وغطفان) وغيرها من أيام أجدادنا.
إن (القصص) منهج، استمر فاعلا بعد الإسلام، وإن كان قد خبا الكثير من وهجه في عصر البعثة بسبب طغيان مباني الشريعة على واقع الحياة العامة، حيث وظفه المشركون في الطور المكي كسلاح في محاربة الدين من خلال قصص سبق وأن سمعها من حولهم، وتأثروا بها، وخزَّنتها ذاكرتهم، حيث كان النضر بن الحارث بن كلدة يجلس إلى الناس، يقص عليهم أخبار الفرس، وقصص قادتهم رستم واسفنديار وغيرهم، ليصرفهم عن الدين الجديد.
ثم في الطور المدني، طور التشييد والبناء والتنظيم، لجا القرآن نفسه إلى سرد قصص بعض الأقوام البائدة لمناغمة رؤاهم العامة من جانب، واتخاذ القصص نفسها لدعم مواقف المسلمين من جانب آخر، عن طريق أخذ العِبرة من تلك القصص، التي نالت نوعا من القدسية بسبب ورودها في القرآن، فأسهم ذلك في ترسيخ نبذة عن تاريخ الأقدمين في عقول المسلمين، ابتداء من قصة الخليقة، إلى قصة عصيان إبليس، مرورا بقصة الهُدهد، ومن ثم النملة مع نبي الله سليمان (عليه السلام)، وقصة البقرة مع نبي الله موسى (عليه السلام) واليهود، فضلا عن قصة يوسف، وقصة ابراهيم، وقصة مريم.
قد يكون التحفيز القرآني سببا في إحياء هذا الفن في النفوس، حينما اعتقدوا أنهم بحاجة إلى محتواه، ولهذا السبب، عاد إلى الظهور في المجتمع الإسلامي في أواخر العقد الثاني وبدايات العقد الثالث من عصر ما بعد البعثة، وتحول إلى منهج إرشادي ديني في ظاهرة، وله مقاصد أخرى في السر والخفاء، يتولى القاص من خلاله إرشاد الأمة إلى بعض مواطن الحاجة عن طريق ذكر قصص الأقدمين سواء كانت حقيقية أم أسطورية، وقد تولى ذلك بداية ثلة من اليهود منهم كعب بن باتع الحميري وتميم الداري ووهب بن منبه؛ في زمن خلافة عمر بن الخطاب (رض)، وعن طريق هؤلاء، تسللت الكثير من قصص الإسرائيليات إلى الحياة الإسلامية.
ثم بعد عدة سنين، تكاثر عدد القصاصين مع مرور الأيام، ليتحول فن القصص في بداية عصر الدولة الأموية إلى منهج سياسي بحت، يتولى الترويج إعلاميا للدولة الجديدة ودعمها، وإضفاء الشرعية عليها، بعد أن استمر وهب بن منبه ومعه نعيم بن أوس الداري، في رواية قصص وأساطير الأولين عند جلوسهم في بلاط الأمويين في الشام، ثم من خلال التعاون المثمر بين القصاصين والأخباريين؛ الذين تكاثر عددهم في زمن الأمويين، ولاسيما بعد أن اتخذ معاوية عُبيداً بن شرية الجرهمي محدثا وقاصا، وبعد أن كان معاوية قد أمرهم بتدوين ما يقصه عبيد.
هنا بالذات، بدأ مزج الواقع بالخيال، والحقيقة بالأسطورة، وبدأ تشكيل تاريخنا الإسلامي من خلال هذه الهُجنة التي زرعت فيه الكثير من المناطق الرخوة التي من الممكن استغلالها للبناء أو للتخريب دون أدنى تعب أو جهد. فكانت السبب في ولادة ميثولوجيا الصراع التاريخي بين المسلمين فيما بينهم وبين المسلمين والأمم الأخرى!.
ثم بعد خفوت وهج الصراعات العقائدية، والانفتاح على الحضارة مع شبه انغلاق وابتعاد عن الدين، تحول فن القصة إلى منهج أدبي فلسفي عن طريق قصص إرشادية طويلة، ظن واضعوها أن الأمة بحاجة إليها لتعود إلى رشدها. كانت تلك القصص غاية في السباكة والمحتوى لدرجة أنها خلدت بخلود الأيام، مثل قصة (حي بن يقظان) لابن طفيل و(رسالة الغفران) للشاعر الكبير أبو العلاء المعري.
ثم، استمرت القصة تتوهج في ليل العرب، حتى بعدما أنشأوا دولتهم في الأندلس؛ التي نشط فيها فن قصص الفروسية، وفن المقامة، وهما فنان رائعان لهما قدرة التأثير على من يسمعهما، وقد تركا أثرا واضحا على القصة الإسبانية، وعن طريق الإسبان، دخل فن القصة العربية إلى الغرب، وأعانهم في تكوين منهج قصصي أدبي. وهذا ما أشار إليه المستشرق (جب) في قوله: “الأدب الإسلامي قد يظهر أنه بعيد عن الأدب الغربي بعداً شاسعاً، بحيث أن فكرة الاتصال بين الادبين قد لا تخطر على بال واحد بالألف من الغربيين المحدثين، إلا أن الباحثين الذين يدرسون تاريخ الأدب الأوروبي، يعرفون كم من عناصر هذا الأدب نسب حينا بعد حين إلى أصل شرقي”.
إن تأثر العالم الغربي بفن القصص العربي أمر لا يخفى على أحد، وقد أشار إليه الباحث الإسباني (أمريكو كاسترو)، بقوله عن فن القصة الأوربي بأنه: “يدين بالفضل في وجوده للحديث العربي(القصة) الذي كان يعني حكاية ما هو طريف. لقد كان الأوروبيون فيما بين القرنين الثامن والثاني عشر يقبلون في شوق وشغف على تلك الأحاديث التي يقصها العرب في مجالسهم وأسمارهم، من قصص تاريخية ونصف اسطورية”.
وهكذا أسهم العرب ولغتهم الجميلة في وضع أسس وقواعد فن القصص الغربي الذي أنتج لنا فيما بعد روائع الروايات العالمية؛ التي تأخذ حيزا كبيرا ضمن حياتنا سواء عن طريق القراءة أو عن طريق مشاهدة الأفلام. وقد وصل فن كتابة السرد الأدبي اليوم في العالم الغربي إلى درجة اجترار المعجزة وابتكار السحر وخلق فضاءات الدهشة، أما نحن فاكتفينا إما بسماع تفاهات (القصخون) البدائية، أو بالتفرج عليهم، وكتابة قصصنا بدم الأبرياء من قومنا وأهلنا وأقربائنا وشركائنا في الإنسانية، لنمجد دينا يأنف ان ننتسب إليه ونحن نحمل كل هذا الغل على الإنسانية، أو لنمجد لغة، تأنف أن ندعي أنها لغتنا!.
إن مجرد الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية يعني أن هناك أذرعا مفتوحة لإخوان لنا في الإنسانية والوجود، تريد أن تحتضننا، ونحن لا يمكن أن نرقى إلى مصاف الإنسانية إذا لم نتخل عن الكثير من مناهجنا البالية، ونفتح لها بدورنا أذرعا وقلوبا.
 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل