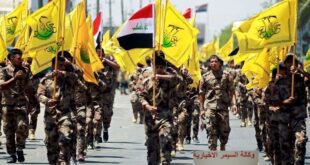السيمر / الثلاثاء 25 . 10 . 2016
عامر محسن / لبنان
من يذكر اسم الفلّوجة اليوم؟ هل تذكرون سيل «التضامن» والبكائيات والتحريض الذي هاج أيام معركة الفلوجة، وقد قاده أناسٌ يدّعون الحرص على أهل المدينة، والتماهي معهم، والتأثّر بألمهم؟ فكيف «اختفى» أهل الفلّوجة فجأة، وغابوا عن حساب «المتضامنين»، ما أن انتهت المعركة واستدارت آلة الدّعاية الى ميدان آخر؟
هل يعرفون أنّ الكثير من أهالي المدينة لم يعودوا بعد الى ديارهم وما زالوا مشرّدين، وقد لا يرجع العديد منهم قبل أشهر، اذ أن الكثير من أحياء الفلوجة ليس آمناً للسكن بعد؟ هل لمحتم أحداً من «المتضامنين»، حكومات وأفراداً، يجمع التبرّعات والمعونة لأهل الفلوجة المهجّرين، أو يساعدهم على العودة، أو يساهم في إعمار مدينتهم «الغالية» ــــ كما قالوا ــــ على قلوبهم؟
قبل هذا كلّه، هل أظهر الإعلام العربي الذي يدّعي الدّفاع عن شعب العراق، أو عن «العرب السنّة» فيه، أي اهتمام بالأوضاع الحقيقية، المُعاشة، لهؤلاء الناس، وللفروقات في أحوالهم وسياقهم، أم هم ينظرون اليهم كمحض كائنات ورموز طائفية، أو كجزءٍ من لوحةٍ سياسية يرسمها إعلام الخليج؟ هل يعلمون، مثلاً، أنّ هناك مدناً قد عاد أهلها اليها، ومناطق أخرى ما زالت فارغة؟ أنّ شمال بيجي وتكريت، مثلاً، قد دبّت فيهما الحياة (ولكن من دون صور ونُصُب صدّام وعائلته، آسف)، فيما الرّمادي مدمّرة؟ على الهامش: هناك تسجيل مصوّر من الجوّ يظهر حجم الدّمار الذي ألحقه الطيران الأميركي بمدينة الرمادي
، يصرّ صديقٌ عراقي على أنّ كلّ عربيّ يجب أن يشاهده، لا لفهم الكارثة فحسب، بل ايضاً حتّى يشهدوا على حجم المنشآت والخدمات التي كانت موجودة في الرّمادي، جسوراً ومرافق وجامعات ومباني عامّة، وأغلبها بُني في العشرية الأخيرة ولا تحلم بمثلها أي مدينة في سوريا أو مصر أو لبنان، اذ ربّما يعيدون النّظر في سردية «التهميش»، وأن الدولة كانت تهمل هذه المدن وتضطهدها، ولم تترك لأهلها خياراً غير «داعش».
تقول الهيئات العراقية ان ما يقارب ثلث اللاجئين قد عادوا، وظلّ ما يقارب الثلاثة ملايين مهجّر (نصفهم في كردستان). هل يعرف «المتضامنون» العرب أنّ العائلات النازحة الفقيرة تعيش حياةً صعبة، وكم من أولادها يتسوّلون اليوم في شوارع بغداد؟ ألا يطرح هذا التجاهل التامّ لأحوال النّاس وظروفهم ومشاكلهم الحقيقية، ونسيان القضية ما أن تُهزم «داعش»، تساؤلاتٍ حول صدقيّة هذا «التضامن» ونزاهته، وما إن كان ينطلق حقّاً من حرصٍ على هؤلاء الناس أو شعور بالشراكة معهم؟
الخلاصة الطائفية
على عكس الخطاب السياسي السائد في بلادنا، والذي يميل ــــ أقلّه في العلن ــــ الى ذمّ الطائفية و»تجريمها» وتصويرها على أنّها شكلٌ «سيئ» أو قاصر من أشكال الهوية السياسية، فإن الحقيقة الموضوعية والتاريخية تقول بأنّ الطائفية، بالمطلق، لا تختلف نوعياً عن أي مشروع هوية آخر، سواء كان اثنياً أو قومياً أو ايديولوجياً. لو سيطرت حركة طائفية على بلدٍ فهي قد تستحيل فكرةً «وطنية»، كالكنيسة الانغليكانية في بريطانيا. وقد تتعايش طوائف متعدّدة، تنظر الى نفسها كجماعات سياسية مختلفة، في بلدٍ واحد كما تتجاور الاثنيات، فتتعاون أو تتنافس أو تحترب. النظرة السلبية الشائعة تجاه «الطائفية» في المشرق العربي هي قيميّة وأخلاقية، وتتعلّق بالسياق العربي تحديداً (إذ أنّ الهوية الطائفية في بلادنا تنحو نحو التقسيم وليس الوحدة، والى خلق هويات متضادة في وطن واحد، فيما الهوية الكاثوليكية أو الأورثوذوكسية مثلاً ــــ وهي «طائفيات» على مستوى العالم المسيحي ــــ كانت عامل توحيدٍ على مستوى اسبانيا أو اليونان).
ولكنّ ما نرمي اليه هنا هو ليس نقاشاً حول نظريّة الطائفية والهويّة، بل توضيح أنّ الطائفية السياسية تأتي بأشكالٍ متعددة، وكلّ طائفية لها سرديتها وتراثها، وتتفاعل مع النظام السياسي و»الآخر» بطرقٍ مختلفة؛ ولعلّ اسوأ الطائفيّات هي من نمط «الطائفية السنّية» المحدثة، التي يعمل على ترويجها اليوم، حثيثاً، إعلام الخليج ومثقفوه: طائفية «غير واعية لنفسها» (على منوال الايديولوجيا التي لا تعي نفسها)، أو طائفية التي لا تعتبر نفسها طائفية، أو تظنّ أنّها طائفة «مختلفة»، «مميّزة» أو استثنائية ــــ ولكلّ طائفة في بلادنا، مهما صغرت، سردية عن كونها «مختارة» ومفضّلة. كما يرى الباحث المصري كريم محمّد، فإنّنا نشهد محاولة لبناء هوية طائفية «سنية»، ولكن تحت شعارات مضلّلة وتوريات وألعاب لغوية من نمط «غالبية الأمّة» أو «الأكثرية». تسعى هذه الشعارات الى تبرير الطائفية عبر تجهيلها، أو عبر تقديم الطائفة كـ»إسلام».
المشكلة هنا هي أنّه لا يمكنك أن تجمع النقيضين، أي أن تصطفّ في خطابٍ طائفي وتقسّم الإسلام الى فرق، وأن تسعى ــــ في الآن ذاته ــــ الى الإحساس بدفء الأمّة ورحابة دنيا المسلمين. الطّائفية «الكلاسيكية»، كما نجدها في لبنان والعراق، تعترف على الأقلّ بطبيعتها، وتقيم حوارات المحاصصة والتعايش والتكاذب مع الطوائف الأخرى، أمّا ما ينسجه الإعلام الخليجي وسماسرته اليوم فهو صنف من الطائفية لا ترى نفسها ولا تعترف بآخرين الّا كاستثناء طارىء أو كـ»هرطقة» أو «أقلية».
أكثر التجييش الذي أُقيم حول معركة الفلوجة، ويتكرر اليوم في الموصل وحلب، ما هو الّا رفدٌ لهذا التيار ولهذه السردية (مشكلتها ليست أنها طائفية فحسب، بل أنّها «نظرية» مجرّدة، دعائية جوفاء، ينهار منطقها أمام أوّل احتكاكٍ بالواقع). حتّى أنّ بعض مثقفي الخليج لا يتحرّجون من الدّعوة للطائفية عبر تقديمها كخيارٍ وحيد ودفاعيّ، وأنّ «السنة» يتعرّضون للإبادة في المشرق. الوقح في هذا الكلام ليس أنّه باطلٌ بالمعنى الموضوعي، بل أنّه ايضاً خطيرٌ يستحقّ العقاب القانوني؛ فلا يحقّ لأي كان أن يرفع راية «الإبادة» على هواه، ويمارس تحريضاً تحت دعوى الدّفاع والاضطرار، يبرّر هكذا لخطاب القتل و»الإبادة المضادة» (الوقاحة الكبرى هي أن يدافع المرء، في الموصل وحلب، عن حركات تجهر بمعتقداتها الإبادية بحجّة حقوق الانسان ومنع «الإبادة»).
الموقف «الحقوقي»
اكتشف الكثير من الليبراليين العرب، على ما يبدو، أنّ الحالة السياسية في بلادنا يسيرة التفسير، وأن الموقف المطلوب منّا جميعاً بسيطٌ وسهل: يكفي أن تدين «قتل المدنيين» في اليمن و»قتل المدنيين» في حلب، أن تكون ضد روسيا وضد السعودية وضد ايران، الأمر والموقف «الصحيح» هو بهذه البساطة، هل هذا صعب؟ المشكلة ليست في «صعوبة» هذا الموقف، بل في غبائه، ليس فقط لأنه يسطّح الوقائع ويخلق تكافؤاً ساذجاً بين حالاتٍ تختلف جذرياً عن بعضها البعض، ولكن لأنّه منطقٌ يلغي السياسة و»يعقّمها»، ويختزلها في تبنّي «المدنيين» فحسب، ويحوّل الفرد من عقلٍ نقدي سياسيّ مفكّر الى ما يشبه «مراقبي» حقوق الإنسان، ينحصر همّه في توجيه الإصبع و»الإدانة»، والموازنة بين اليمن والموصل، وبين حلب الشرقية والغربية…
فلنأخذ القصف السّعودي لليمن مثالاً، هل الإدانة واجبة حصراً لأن الطيران السعودي قد قصف دار العزاء؟ أم هي تتعلّق بالسياق السياسي للحرب، والمشروع السعودي في اليمن، وانعدام شرعية العدوان والغزو؟ هل أنّ العدوان السعودي، لو أنّه ــــ كافتراضٍ نظري ــــ لم يقصف دار العزاء، ولم يقتل الطيران حتى أي مدنيين، فهل يعني هذا أنّه صار مقبولاً وليست لنا مشكلة معه؟ لتوضيح الفكرة أكثر، أنا أدفع، مثلاً، بأنّ «جريمة الحرب» الحقيقية لا تنحصر في استخدام أسلحة «محرّمة»، أو كمّ الضحايا والأبنية المهدّمة، بل هي تشبه ما جرى في حلب منذ أعوام. انت تكون متّسقاً مع نفسك في «إدانة» الحرب في حلب وادّعاء الحرص على المدنيين لو أنّك أدنت، بالمثل، اجتياح المدينة من قبل مجموعات مسلّحة مدعومة من الغرب عام 2012. من قرّر أن يدخل الحرب الى حلب وأن يجعلها ميدان صراع كان يعرف جيّداً أنّنا سنصل الى هنا. كلّ صراعٍ على مدينة في التاريخ الحديث للحرب انتهى بمشهدٍ يشبه مصير غروزني وبيروت والرمادي. الأمر لا يحتاج الى تنبؤ وبعد نظر. وحلب، عام 2012، لم تكن تشهد مظاهرات أو مواجهات أو سببٍ للقتال، بل تمّ اقتحامها من خارجها بتنسيقٍ مخابراتي أجنبي، وهذا موثّق، وكان الهدف ــــ تحديداً وعن وعي ــــ ادخال ملايين الناس في أتون المعاناة وتدمير أكبر مدينة سورية. أن تحمي شعبك من القتل والتشريد والخراب لا يكون عبر عدّ الأبنية المهدّمة والتأثّر للضحايا وتدبيج مواقف «الإدانة»، بل عبر منع السّياق السياسي الذي يوصل بأهلك الى هذا المكان.
الثقافة السياسية السائدة، خاصّة في الغرب اليوم، تشجّع باستمرار على هذا المفهوم «الحقوقي» للسياسة، ولنموذج «المثقّف\الضّمير»، الذي «لا يدخل في صغائر السياسة» وخلافيّاتها، ولا يلتزم ولا يفاضل، بل يكتفي بالتعبير عن حبّ «المدنيين» والتأسّي عليهم، وينشغل (بدلاً من توليد خطابٍ مسيّسٍ عن الواقع) بدوزنة موقف «الإدانة» خاصّته وتوزيعه كما يجب، ثمّ يشعر بعدها بالرضا التامّ عن نفسه.
لا يكفي أن تكون لديك مشاعر وحماسة حتّى تكون على حقّ، النازيّون قاتلوا بحماسة وشغف وشعورٍ بالأحقية، حتّى الأميركيون يخوضون حروبهم حول العالم وهم مؤمنون بأنّهم في حالة «دفاع عن النفس». امّا إن كانت «المشاعر» على شاكلة الخطاب الطائفي وتحريض «الجزيرة»، فخيرٌ لك حينذاك أن تلتفت الى بلدك ومشاكله الكثيرة، وأن تعفي سكّان الموصل وحلب من «تضامنك»، وتترك المعركة لأهلها.
الاخبار اللبنانية
 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل