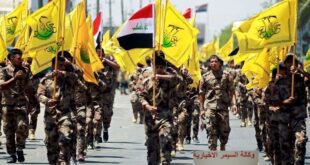السيمر / الثلاثاء 03 . 10 . 2017
د . إبراهيم الخزعلي
المستشرق الأنجليزي ادوارد براون
“وهل ثمة قلب لا يغشاه الحزن والألم حين يسمع حديثاً عن كربلاء؟ وحتّى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلّها.”
محمد علي جناح، مؤسس دولة باكستان
” لا تجد في العالم مثالاً للشجاعة كتضحية الإمام الحسين بنفسه واعتقد أن على جميع المسلمين أن يحذو حذو هذا الرجل القدوة الذي ضحّى بنفسه في أرض العراق. “
توماس كارليل، الفيلسوف والمؤرخ الإنجليزي
” أسمى درس نتعلمه من مأساة كربلاء هو أن الحسين وأنصاره كان لهم إيمان راسخ بالله، وقد أثبتوا بعملهم ذاك أن التفوق العددي لا أهمية له حين المواجهة بين الحقّ والباطل والذي أثار دهشتي هو انتصار الحسين رغم قلّة الفئة التي كانت معه.”
فردريك جيمس
” نداء الإمام الحسين وأي بطل شهيد آخر هو أن في هذا العالم مبادئ ثابتة في العدالة والرحمة والمودّة لا تغيير لها، ويؤكد لنا أنه كلّما ظهر شخص للدفاع عن هذه الصفات ودعا الناس إلى التمسّك بها، كتب لهذه القيم والمبادئ الثبات والديمومة. “
غاندي، زعيم الهند
“لقد طالعت حياة الإمام الحسين، شهيد الإسلام الكبير، ودققت النظر في صفحات كربلاء واتضح لي أن الهند إذا أرادت إحراز النصر، فلا بد لها من اقتفاء سيرة الإمام الحسين.”
في بادئ ذي بدء ، اود ان انطلق من نقطة مهمة ، وهي من طبيعة ألأنسان في تعامله مع ألأشياء بواسطة حواسه الخمس ، ومن خلال هذه الحواس تتكون صورة الشئ الذي أحس به . وكما نعرف أن مركز الجهاز العصبي هو المخ ، الذي يستقبل كل المعلومات الحسية ، فيتاثر بها ويؤثر فيها ، وتنتقل تاثيرات المركز العصبي الى سائر الجسم ، سلباَ او ايجاباَ .
فان كانت تلك التأثيرات أيجابية ، فالنتائج تكون بدورها أيجابية على جسم وكيان ألأنسان ، عضويا وسايكلوجياَ . وأن كانت التأثيرات المرسلة من مركز الجهاز العصبي سلبية ، نتيجة الشئ المحسوس سلباَ ، فسيكون ايعاز المركز العصبي للجسم ، ايعازاَ سلبياَ ، عضوياَ وسايكلوجياَ . فالشئ الذي تأثر به الأنسان سلباَ ، سيكون ذلك الأنسان في حالة تنافر مع ذلك الشئ المؤثرسلبا . وبالعكس من ذلك ، الشئ الذي تاَثر به ايجاباَ ، فسيكون في حالة تجاذب مع ذلك الشئ .
وبما ان البصر هو أهم الحواس الخمسة ، التي ندرك العالم به ، فنتأثر ونؤثر فيه . فنحن لانبصر الشئ فقط ، بل نكوّن تصوراَ معيناَ عنه . وفي قوله تعالى ( فلمّا جاءتهم آياتنا مبصرة)
والأبصار لايكون مجرد فعل ورد فعل ، وأنما هي عملية تصور متكاملة . فعندما نرى الشئ
ندركه ونحلله ونتأثر به سلباَ أو ايجاباَ ، وتسمى هذه الحالة بالأنفعال . والبصيرة في قوله
تعالى ( بل الأنسان على نفسه بصيرا ) . فلا نستطيع ان ندرك الشئ ، ألاّ من خلال الحواس الخمس مجتمعة . وبدون البصيرة لايمكن أن يكون الأنفعال منضبطاَ ومنسجماَ بالمستوى الذي أُبصرت به تلك المادة . قد ترى شيئاَ فتشعر بالخوف منه ، وتصاب برجفه ، أو سماعك لبيت من الشعر ، يهيّج فيك الجانب العاطفي ، والحنين لشئ ما ، فتشعر بالحزن والكآبة ، أو يدفعك الى البكاء والنحيب . وكذلك عند سماعك صوتاَ ، قد يطربك أو يرعبك
وربما هناك أشياء قد لاتؤثر في الأنسان ، لاسلباَ ولا أيجاباَ ،
بالرغم من تحسس الأنسان بتلك الأشياء ، والسبب في ذلك ، هو صحيح أن الأنسان يمتلك حواسه الخمس ، ولكن هذه الحواس تختلف من انسان لآخر . فالحواس الخمس عند الفلاّح ، هي ليست كتلك الحواس عند العامل . وكذلك الحواس التي عند الطالب ، هي تختلف عن تلك التي عند الأستاذ.
قد يتساءل البعض وما الأختلاف في ذلك ؟
فأقول ان الحواس تختلف في الأداء الوظيفي ، وليس في الشكل الخارجي . فالأداء الوظيفي متباين من شخص لآخر ، بحكم تطور تلك عن الأخرى . فعلى سبيل المثال ، ان حاسة السمع عند شخص موهوب ، أو متذوق لسماع الأيقاعات الموسيقية ، فهي تختلف عن سماع ذلك الشخص الذي لايفهم ماهو الأيقاع الموسيقي ، وذلك لعدم تطور سمع الثاني لهذا المستوى الوظيفي . وكذلك بالنسبة للقراءة والكتابة ، والفنون ، واللوحات ، والمشاهد الكثيرة من حولنا وهلمجرا .
أليست عند الأمّي حاسة السمع والبصر ؟
فلماذا يرى الكتابة ولا يفهمها ؟
ويسمع ولا يفهم كثيرا مما يقال !
وكما هناك حاسة أخرى ، غير تلك الحواس المعروفة لدى كل انسان . ولربما تكون هذه الحاسة عند الفلاح ، أو اي انسان بسيط ، بينما لاتوجد عند انسان آخر متعلم ، يحمل أعلى الشهادات الجامعية . وتسمّى هذه الحاسة بالسادسة ، أو ما يسميها العرب بالفراسة .
قال تعالى ( ان في ذلك لآيات للمتوسمين ) وذكر أهل العلم أن هذه الآية في أهل الفراسة . والفراسة نور يقذفه الله في قلب المؤمن الملتزم سنة نبيه ( ص ) يكشف له بعض ما خفي على غيره مستدلاَ عليه بظاهر ألأمر ، فيسدد في رأيه ، يفرق بهذه الفراسة بين الحق والباطل ، والصادق والكاذب دون ان يستغني عن الشرع . وهو يختلف عن الفراسة الذي هو حذق ركوب الخيل . واذا ما اجتمع بالمرء أمران ، الفراسة بالكسر والفراسة بالفتح ، فهذا نور على نور ، وذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء بصيرة في القلب وقوة في البدن لمنازلة أعداء الله في الجهاد . هذه الفراسة هي ما يسميه العلماء بالفراسة الأيمانية ، ويكون هذا حسب قوة الأيمان . فمن كان أقوى أيماناَ فهو أحدّ فراسة . ويستطيع المتفرس ان يقرأ ما في عينيك ، أو ما بين السطور .
فمن غرس الأيمان في قلبه وسقى ذلك الفراس بالأخلاص والصدق ، كان ثمره الفراسة .
عن أبي سعيد الخدري ( رض ) قال ، قال رسول الله ( ص ) ( اتقوا فراسة المؤمن فأنه ينظر بنور الله ثم قرأ قوله تعالى : ( ان في ذلك لآيات للمتوسمين ) .
بعد كل هذه المقدمة الطويلة وما احتوته من تداخلات وأيضاحات ، وتبيان أهمية دور الحواس في التعامل مع الأشياء ، وأختلاف وظيفتها من شخص لآخر ، فأعود الى صلب الموضوع الذي سأتناوله ، ومدى أهميته في تاريخ الأنسانية جمعاء .
فعندما نتحدث عن شئ أسمه التأريخ ، فأنما نتناوله ضمن منظومة المحسوسات ، وليس خارجاَ عنها ، بالرغم من الفاصل الزمني الكبير . وعندما لا نكون عن قرب الشئ ، أو لم نعشه أو لم يكن ذلك الشئ قريب من منظومة حواسنا ، فذا لا يعني انه غير موجود ، أو مشكوك في وجوده . فحين نرى ضوء المصباح الكهربائي ، لا نستطيع نفي التيار الكهربائي لعدم رؤيتنا اليه . وهكذا تقاس الأشياء بمنطق العقل . فكل شئ تحيط به عدة أحتمالات وافتراضات ، جيد وسيئ ، نافع وضار ، جميل وقبيح ، مهم وغير مهم ، قريب وبعيد ، كبير وصغير ، جديد وقديم ، واسع وضيق ، جذاب وغير جذاب ، رخيص وغالي ، حقيقي ووهمي ، جوهري وشكلي ، سليم وغير سليم . وعند التمعن والتفكر في الشئ والنظر في كل الأحتمالات والأفتراضات التي تحيط به ، ومن ثم الولوج في عالم ذلك الشئ ، عندئذ تتبين الحقائق ومدى صحة تلك الأحتمالات والأفتراضات والنسب القيمية لذلك الشئ . فهنا أركز على نقطة الولوج في عالم الشئ .
والولوج في الشئ هو التفاعل المتبادل روحيا وعقليا وعاطفيا وعضويا ، والذي يتمثل بمنظومة الحواس المتكاملة . بعد هذه العملية التفاعلية المتبادلة ، يمكن أستنتاج ماهية الشئ ، وما قيمته المادية والمعنوية ، وبالتأكيد أن العملية تحتاج الى جهد ووقت . ومن دون ذلك لايمكن الحكم على الشئ أطلاقاَ ، لأن الأحكام التي تأتي عن بعد ، هي أحكام غير دقيقة ، وكما يقول الشاعر :
لاتمدحنّ اِمرئ حتى تجربه ولا تذمنّه من غير تجريبي
وللأسف الشديد نرى في مجتمعنا وفي تاريخنا الكثير من السلبيات نتيجة تقيماتنا الخاطئة ، وأحكامنا على كثير من الأشياء أحكاماَ تعسفياَ وظالمة ، وتبنى على هذه الأحكام والتقيمات ، احكام وتصورات أخرى خاطئة ، فتقود الأمة الى متاهات وظلمات ، تجعله يتخبط ويتعثر في كل مجالات الحياة , فتولد الشكوك والظنون ، وتحدث الأصطدامات والعداوات والنزاعات الخطيرة والمهلكة .
فتعم الأنحرافات الضالة في الأمة . ويتم تسيس مع أدلجة تلك الأنحرافات في كيان الدولة والمجتمع
ويدعم ذلك النهج ، الحكام المتجبرين ، والفئات المستفيدة . وهنا بيت القصيد , فيما ينطبق على يوم
عاشوراء ، وماحدث في واقعة الطف العظيمة ، التي أسقطت عروش الطغيان والمستكبرين ، وأرست أسس العدالة والمساواة .
فأذا كان القرآن هو الكتاب الدستوري والنظري ، فأن واقعة الطف ، هي الكتاب العملي والتطبيقي الناطق والمرشد ، والنبراس المنير لكل الأجيال . فأذا كانت مشيئة السماء ، أن تكون هناك هجرتان للرسالة المحمدية ، فالأولى هي الهجرة النبوية الشريفة ، والثانية هي الهجرة الحسينية .
الكل يعلم أن الثورات في التأريخ الأنساني ، تبدء أولاَ بالتنظيم السري ، والتكوين الخلوي ، في التهيئة الصحيحة للأرضية المناسبة للعمل ، وبناء قاعدة صلبة . كي يمكن الأنطلآق منها ، حيث يكون العمل منظماَ ، ومبنياَ على أسس صحيحة . فلا تخبط ، ولا فوضى . أما القيادة فتقع عليها المسؤلية الكبرى . فما أعظم العمل والتخطيط ، حين تكون القيادة بيد أعظم أنسان في الوجود .
فأما الهجرة النبوية الشريفة ، فلم تكن نتيجة ضعف وخوف وهزيمة ، وانما أنطلاقاَ من موازين القوى أنذاك . حيث أجتمعت قريش في دار الندوة ، للتباحث في كيفية الأنتقام من تلك القيادة المتمثلة بالرسول الأعظم ( ص ) ، فأنبأ الباري عز وجل رسوله الكريم بالمؤامرة ، وأمره بالهجرة فجعل علياَ ( ع ) في فراشه تمويهاَ ، وتوجه هو والصديق الى جبل ثور . فبقيا هناك ثلاثة أيام ، بعدها توجها الى المدينة سرّاَ . أما أختياره لعلي بالذات كي ينام في فراشه ، فله عدة دلالات ومعاني .
أن شخصية علي ( ع ) كانت بمستوى المهمة والمسؤلية . فأيداع سر توجه الرسول ( ص ) ، لهي مسؤلية كبرى ، لا تناط لرجل آخر من الصحابة ، ألاّ لهذا الفتى اليافع الصنديد . فالصفات التي كانت في علي ، فهي النجوم التي تتحلى بالقمر . فأما الشجاعة ، فعلي كان أشجع الناس ، وأما الأيمان ، فهو الذي تغذى دمه على روح المبادئ . فتعطرت المبادئ ، وكل القيم الأنسانية بعطر علي . فسارت المبادئ والقيم والمثل في بدنه ، مجرى الدم في العروق . فروح الرسالة المحمدية ، هي روح علي ، وهيكل الأسلام , هو هيكل علي . فصفات علي ، هي صفات النبي . والرسول يشهد له بذلك ( انا وعلي من شجرة واحدة ) .
( من كنت مولاه فهذا علي مولاه . اللهم وال من والاه وعادي من عاداه وأنصر من نصره وأخذل من خذله وأدرالحق معه حيث دار ) .
( هذا أخي ووصيي وخليفتي من بعدي ) .
( أن علياَ مني وأنا من علي وهو ولي كل مؤمن بعدي لايردي عني الاّ أنا وعلي ) .
( لكل نبي وصي ووارث وأن وصيي ووارثي علي بن أبي طالب )
( علي مني بمنزلة هارون من موسى الاّ أنه لانبي بعدي ) .
( أنا مدينة العلم وعلي بابها ) .
فالهجرة النبوية كانت دفاعاَ عن الرسول محمد ( ص ) والأسلام ، أما الهجرة الحسينية فهي المعنى التطبيقي والأثباتي للرسالة المحمدية . فالهجرة النبوية كانت انطلاقاَ من موقع الحيطة والحذر من الخطر القريشي السفياني الرافض والمتصدي لهذه الرسالة الجديدة ، لما تحتويه من قيم العدالة والمساواة ، والتي بدورها تتعارض مع مصالحها المادية والمعنوية .
اما الهجرة الحسينية ، فهي هجرة ثورية ضد أنحراف في السلطة الحاكمة باسم الأسلام ، وهو الأخطر من العدو الخارجي أنذاك . فكان الحسين يمثل الحق كله ، ضد الباطل كله . وقد يقول بعض من أولائك الذين لم تستوعب حواسهم ، ولم يستقرؤا الواقعة بكل أبعادها ، فيقولون أو يتصورون أنه مبالغ فيها .
ولكن حقيقة عاشوراء أكبر بكثير مما يتصوره المتصورون . فمن كان عن قرب حسّي من تلك الواقعة والنظر الى قيادتها والتفكر فيها ، وفي ابعاد الهجرة الحسينية المادية والمعنوية ، فستتلاشى امامه الحجب الظلماء ، وتتفتح امام عينيه وقلبه أبواب كنوز المعرفة في ما يخص ثورة كربلاء .
فمن آمن بالرسول هاديا ومنقذاَ للبشرية من دهاليز الظلمات والعبودية الى نور المساواة والعدالة ، عندها ستكون الحقيقة أمام حواسه وقلبه وعقله وكيانه جلية متفاعلة مع روحه وعقله ، لأن الحقيقة هي الطاقة الخلاقة والمبدعة، كالشمس، لا حياة من دونها . ( حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا ). ( ان الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة ) الرسول الأعظم ( ص ) .
واقعة الطف هي أكبر من أن تكتبها الأقلام وأحر مما تغلي الصدور . واقعة الطف أوسع مساحة من كربلاء ، وأكبر من يوم عاشوراء . واقعة الطف ليست مجرد معركة وقعت في زمان ومكان محددين ، وشأنها شأن ماوقع قبلها او بعدها ، وتدفن في مقابر التأريخ .
كلاّ .. فلا يعني تقديم الدلائل تلو الدلائل ، والبراهين تلو البراهين من منطلق غلو وتعصب، او طاعة عمياء، فأن ما يعبرعن تلك الواقعة ، بالقول أو بالفعل، بالصورة أو بالحركة، أنما هو تعبيرعن رغبة جامحة تغلي في الصدور، وثورة وجدانية لتبيان حقيقة، وأزاحة غبار، وأسقاط وابعاد تهمة، وتصحيح لتشويه متعمد أو غير متعمد . فليس الدفاع و التضحية تعصباَ، أو من منطلق ضيق . فهناك الكثير من أديان ومعتقدات ومنابع وأصول وعوالم أخرى لا تمت بالواقعة بأية صلة، سوى نور الحقيقة، وألم الفاجعة، والنفس الأنساني الحر، الذي يربط كل بني البشر ذوي الضمائر الحية، والوجدان المتيقظ ، ودعاة الحرية والعدالة والمساواة .
أنظروا ما كتبه أنطون بارا كتابه ( الحسين في الفكر المسيحي ) .
( لم تحظ ملحمة أنسانية في التأريخين القديم والحديث ، بمثل ما حظيت ملحمة الأستشهاد في كربلاء ، من أعجاب ودروس وتعاطف ، فقد كانت حركة على مستوى الحادث الوجداني الأكبر لأمة الأسلام ، بتشكيلها المنعطف الروحي الخطير في مسيرة العقيدة الأسلامية ، والتي لولاها لكان الأسلام مذهباَ باهتاَ يُركن في ظاهر الرؤوس ، لا عقيدة راسخة في أعماق الصدور ، وأيمان يترعرع في وجدان كل مسلم ) . ( لقد كانت كربلاء هزة ، وأية هزة !
زلزلت أركان الأمة من أقصاها الى أدناها ، ففتحت العيون ، وأيقظت الضمائر على ما لسطوة الأفك والشر من أقتدار ، وما لظلم من تلاميذ على أستعداد لزرع ذلك الظلم في تلافيف الضمائر ، ليغتالوا تحت سُتر مزيفة قيم الدين ، وينتهكوا حقوق أهليه ) . ويتابع أنطون بارا ، فيستلهم المعاني من عمق التأريخ ليحلل الأحداث والوقائع فينغمر في أجواء عاشوراء ، فيكتب عنواناَ (المسيح .. هل تنبأ بالحسين ؟ )
“أيها القاتلون – جهلاَ – حسينا أبشروا
بالعذاب والتنكيل , قد لعنتم على لسان
أبن داود وموسى وصاحب الأنجيل ،”
ويستدرك يقول المسيح ( ع ) ( من ادرك ايامه ، فأنه ( أي المقاتل مع الحسين ( ع ) كالشهيد مع الأنبياء مقبلا غير مدبر ، وكأني أنظر الى بقعته ، وما من نبي الاّ وزارها وقال : أنكِّ لبقعة كثيرة الخير فيك يدفن القمر الزاهر ) . ويثبت أنطون ثلاث نقاط ذات دلالات وأهمية :
1- لعنُ المسيح لقاتلي الحسين ، وأمره لبني أسرائيل بلعنهم .
2 – الحث على المقاتلة مع الحسين ، بأيضاح أن الشهادة في هذا القتال ، كالقتال مع الأنبياء .
3- التأكيد على زيارة كل الأنبياء لبقعة كربلاء ، بالجزم التام على أن << مامر نبي الاّ وزارها >> . وفي بعض المصادر أن عيسى ( ع ) مرّ بأرض كربلاء ، وتوقف فوق مطارح الطف ، ولعن قاتلي الحسين ، ومهدري دمه الطاهر فوق هذا الثرى .
فهذا هو الدليل القاطع ان ثورة الحسين هي ثورة جده رسول الله ( ص ) . وهجرة الحسين وبيانه التأريخي ( ما خرجت اشراَ ولا بطراَ ، انما خرجت لأصلاح دين جدي ) .
فالحسين لم يتوجه للعراق سراَّ ، كما أنه لم يقم مؤتمرات سرية وراء الكواليس ، وما كان شاكّا او متردداَ في توجهه للعراق . بل كان كله ثقة وأيماناَ ، وهو الذي يقول :
سأمضي فما الموت عار على الفتى أذا ما نوى حقاَ وجاهد مسلما
وواسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبورا وجاهد مسلما
فأن مت لم أندم وأن عشت لم ألم كفى بك ذلاّ أن تموت وترغما
الحسين جسّد تلك العزيمة وذلك الأيمان بأصطحابه أهل بيته ، نساء وصغاراَ وشباباَ ورضعاَ. فلم يجلس هو ويبعث آخرين للقيام بالثورة ، ويتوّج نفسه بأنتصارات غيره. الحسين ليس من أؤلائك اللذين يتاجرون بدماء غيرهم، للحصول على المكاسب المادية. أنه ابن بنت الرسول وابن قاتل الأبطال من العتاة المردة. فصفاته هي من صفات جده، وهو الذي رضع تلك الصفات من فم جده وكيف لا، وقد قال الرسول بحقه وأخيه ( الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة )
( حسين مني وأنا من حسين )…
إذن اليست عاشوراء هي الحسين ؟
اليس الحسين هو قلب الأسلام النابض ؟ اليس انتصار الدم علي السيف ، هو انتصار الحسين على يزيد ؟ اليست ثورة عاشوراء حملت ما لم تحمله اية ثورة في التأريخ الأنساني من تضحية وفداء وصدق وحرية وعدالة وأيمان ويقين وصبر وأباء وأيثار وأشراق ومساواة وعزيمة ونكران ذات وتصميم وثبات وأرادة وعطاء وأخلاق ومحبة وعزة وكرامة وشموخ وحوار وفضيلة ودعاء وأخوة وتعامل حسن ودروس وعبر وتفاؤل وتوادد وتعاضد وأخلاص ونبل ومثل . فرسالة عاشوراء هي رسالات كل الأنبياء ضد الأستبداد والطغيان والأنحراف. ثورة الحسين هي ليست أسلامية أبدا، بل هي أنسانية تحررية، وأرث حضاري يستنير به كل الأحرار. ثورة عاشوراء، أعادة الكرامة المسلوبة للأنسان. ثورة عاشوراء هي ليست ثورة طائفة ضد أخرى، بل ثورة أنسانية حضارية، شكلاَ ومضموناَ أولاَ وقبل كل شئ. فمن سعى ليؤطرها بأطر ضيقة فقد ظلمها وظلم أبطالها . فالحسين ( ع ) قدم كل ثقل محمد ( ص ) وكل الرسالات السماوية في يوم عاشوراء. فترى تلك القرابين بين يديه صرعى، وهو يقول : ( إلهي ان كان هذا يرضيك فخذ) . فلا دمعة الآّ لعاشوراء. ولاحب الأّ للحسين. لان حب الحسين هو حب النبي ( ص ) . والدمعة هي مواساة النبي وأبنته فاطمة الزهراء ( ع ). كان سيف الحسين الحد الفاصل بين الحق والباطل . بين الكفر والأسلام . فصدق من قال :
الأسلام محمدي الوجود ، حسيني البقاء والخلود .
 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل