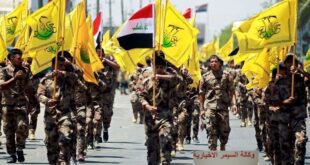السيمر / الاثنين 27 . 11 . 2017
د. ناجح العبيدي
ما أن أوشكت الحرب على داعش أن تضع أوزارها حتى سارع رئيس الورزاء العراقي حيدر العبادي للإعلان عن شن “حرب” جديدة عنوانها هذه المرة مكافحة الفساد. من الواضح أن العبادي يحاول استغلال الظروف المواتية وتزايد الدعم السياسي والشعبي له من أجل توجيه ضربة موجعة لأخطبوط الفساد. وإذا كانت المعركة ضد داعش صعبة نظرا لأن الإرهاببين كثيرا ما يتجنبون القتال وجها لوجه ويتخفون وسط السكان، فإن حملة مكافحة الفساد تتطلب صبرا أكبر، لأن الفاسدين يتسترون وراء شبكات واسعة من العوائل و القوى والأحزاب المتنفذة ويسبحون وسط عقلية وثقافة وتقاليد اجتماعية تُبرر الفساد.
من المؤكد أن أسرع النتائج يمكن تحقيقها، إذا بدأت الحملة باصطياد الرؤوس الكبيرة المتورطة بالفساد. مثل هذه الحملة تنجح عادة في استقطاب الاهتمام الإعلامي والشعبي وفي إخافة وردع الآخرين. ولا يستبعد أن يكشف العبادي قريبا عن بعض الأسماء لوزراء وسياسيين ونواب ومسؤولين حكوميين كبار تحوم حولهم روائح الرشوة والاختلاس. ولن يفعل العبادي ذلك لـ”وجه” الله ولصالح الوطن فقط، بل لإنه يعرف أيضا بأن ضرب الفساد بيد من جديد سيجلب له ولحكومته تأييدا شعبيا كاسحا. لكنه يدرك أيضا أن النصر النهائي لن يكون مجرد نزهة قصيرة.
كما هو حال معركة الإرهاب التي لن تتكل بالنجاح النهائي دون تجفيف منابعه الفكرية والمالية، فإن نتيجة معركة النزاهة ستتوقف في نهاية المطاف على تجفيف مستنقع الفساد الذي تتنفس فيه كائنات من مختلف الأحجام والتي تتنافس في التهام الفريسة المتمثلة في المال العام. ومن الواضح أن اصطياد الحيتان الكبيرة لن يكفي لوحده،لأن فتحات شبكة صيدها واسعة وتسمح بتسرب أسراب أسماك القرش الصغيرة والكثيرة. ومثلما يسود في الحرب مبدأ “الكثرة تغلب الشجاعة”، فإن تأثير “صغار” الفاسدين لا يقل ضررا عن القطط السمان، بل ويفوقه أحيانا.
لا يجوز النظر إلى الفساد على أنه قضية أخلاقية وسلوك اجتماعي ضار فحسب ، وإنما هو بالدرجة الأولى إضاعة لفرص النمو وهدر للموارد الاقتصادية المحدودة وتعطيل لعملية التنمية لأنه يُخلّ بمبدأ المنافسة العادلة والنزيهة. وهذا ما نلاحظه في العراق بكل وضوح. نتيجة الرشوة والعمولات والشللية والعلاقات المشبوهة تحال مشاريع بالمليارات لصالح مقاوليين وشركات ليست كفوءة الأمر الذي يتجسد في ارتفاع التكاليف وسوء التنفيذ وتعطل المشاريع الانتاجية والخدمية، ويؤدي إلى انتعاش الفئات الطفيلية. ونتيجة للمحسوبية ولمبدأ “الأقربون أولى بالمعروف” يحصل غير الأكفاء وغير المؤهلين على الوظائف المغرية في قطاع الدولة. بهذا تتدهور معايير الكفاءة الاقتصادية في استخدام الموارد المادية والمالية والبشرية في القطاعين العام والخاص على حد سواء، فضلا عن الانتهاك السافر لمعايير العدالة الاجتماعية.
يجب القول بكل وضوح بأن تبديد المال العام هو الفساد الأعظم في العراق. ولا ريب أن الرشوة والاختلاس وسرقة المال تأتي في مقدمة مظاهر هذه الآفة التي تنخر في مفاصل الدولة والمجتمع. ومع صحة القول المأثور “السمكة تتعفن من رأسها أولا!”، إلا أن من الخطأ التصور بأن هدر المال العام يقتصر على المسؤولين فقط.
أحد “أسرار” الدولة العراقية الذي لا يعرفه ربما حتى رئيس الوزراء نفسه هو العدد الفعلي للموظفين الحكوميين. هل هو 4 أو 5 ملايين أم أكثر؟ وهل من بينهم 1,3 مليون موظف في إقليم كردستان وحده؟ وهل تضم هذه الأعداد المنتسبين للحشد الشعبي؟ تحقق هذا “الإنجاز” بفضل فتح الأحزاب المتنفذة أبواب التعيين على مصراعيها على مدى سنوات عديدة حتى أصبح جيش الموظفين الحقيقيين والفضائيين الأكبر على مستوى العالم بالمقارنة مع عدد السكان. هناك أيضا ما يقارب 2,8 مليون متقاعد بحسب بيانات هيأة التقاعد العراقية. ومن المؤكد أن من بينهم أناسا في عز الشباب وعناصر تنتمي لداعش وآخرين يرقدون منذ سنوات بسلام في مقبرة السلام بالنجف. هذا الجيش الجرار من الموظفين والمتقاعدين الفعليين والوهميين يلتهم حاليا ثلثي الميزانية العراقية، بينما تراجعت الاستثمارات التي تعتبر العامل الحاسم لأي تنمية، لتصبح مجرد رقم هامشي. وهذا هو عين الفساد، وليس الأخبار الكيدية الملفقة والاتهامات الجزافية لفلان وعلان بسرقة “عشرات” المليارات من الدولارات، والتي توحي وكأن المليارات في العراق ملقاة على قارعة الطريق.
في نهاية عام 2014 رفع النائب الراحل والاقتصادي المرموق مهدي الحافظ مذكرة تفصيلية عن مظاهر الفساد في مجلس النواب العراقي. لم يلجأ الحافظ كعادته للمبالغة – ولم يكن أيضا في حاجة إليها – وإنما ذكر أرقاما ملموسة، منها مثلا بأن حمايات نواب الشعب تضم ما يزيد عن 14800 منتسب، أي ما يعادل فرقة عسكرية ونصف الفرقة. وهو عدد يقارب إجمالي عديد الجنود في جيوش دول “صغيرة” مثل الدنمارك التي يبلغ حجم ناتجها المحلي الإجمالي ضعفي العراق.
لكن كل ذلك لا يقارن بما يحدث في قطاع الكهرباء الذي يستحق بجدارة لقب “أكبر بؤرة” لتبديد المال العام والفساد. هذا الواقع المرير كشف عنه خطاب النوايا الذي أرسله العبادي إلى صندوق النقد الدولي في شهر تموز/يوليو 2017 الذي تشير بياناته إلى أن إيرادات جباية الكهرباء تبلغ 1,5 ترليون دينار فقط (نحو 1,3 مليار دولار) ، بينما تزيد المصروفات الجارية على المرتبات والوقود والصيانة وغيرها (بدون النفقات الاستثمارية) عن 11,5 ترليون دينار ( قرابة 10 مليارات دولار)، أي أن ما تجنيه وزارة الكهرباء من المستهلكين لا يزيد عن 13% فقط من التكلفة الجارية والباقي هو دعم من الدولة، فضلا بالطبع عن المليارات التي تُنفق لبناء محطات توليد الطاقة. من المؤكد أن سوء الإدارة وفساد قيادات عليا يلعبان دورا هاما في هذا الوضع الشاذ والذي ساهم بدرجة كبيرة في تفاقم مشكلة العجز في الموازنة العامة. غير أنه يشير أيضا إلى الأبعاد الخيالية لمشكلة التجاوز على شبكة الكهرباء المنتشرة في العراق. وهي ظاهرة يساهم فيها بالتأكيد المئات من موظفي الكهرباء وكذلك عشرات وربما مئات الآلاف من المتجاوزين على المال العام والذين يلحقون الضرر أيضا بالمستهلكين النزيهين. ومع أهمية ملاحقة أيهم السامرائي وزير الكهرباء الأسبق المتهم بسرقة عشرات الملايين من الدولارات، يتعين على الحكومة أيضا قطع دابر “صغار” الفاسدين واتخاذ الإجراءات لتجفيف الأرضية التي يعشعش فيها هذا الاستهتار بالمال العام وبهيبة الدولة.
لا يقتصر الأمر على شبكة الكهرباء، وإنما تحول الاستيلاء والتجاوز على ممتلكات الدولة والشوارع والأرصفة في المدن العراقية إلى رياضة شعبية من الطراز الأول يتنافس فيها المسؤولون مع أصحاب المحال التجارية والباعة المتجولين وأصحاب البيوت وغيرهم.
يتجسد الفساد بأوضح صوره أيضا عندما يرمي بعض “مستحقي” البطاقة التموينية حصتهم من الرز طعاما للدواجن، أو عندما يبيعونه للتجار بأبخس الأثمان. مع ذلك لا تتجرأ الحكومة على وقف هذا الهدر السافر للمال العام خوفا من “غضب” الشارع وتأليبه من قبل قوى وأحزاب ترفع شعار “الدفاع عن الفقراء” على الرغم من النتائج الهزيلة لهذا النظام البالي في مكافحة الفقر. وبدلا من الدعوة لاستخدام المليارات التي تنفق على تمويل البطاقة التموينية بطريقة فعالة في مكافحة الفقر، يتبارى السياسيون من مختلف التيارات في المطالبة بـ”تحسين مفردات البطاقة التموينية”.
تؤكد تجربة العراق بأن الدول الريعية هي الحاضنة الأولى للفساد. غير أن البعض يتصور بأن هذه الظاهرة تعني فقط الاعتماد الوحيد الجانب على النفط ، وليس توظيف هذه الموارد للتصدق على “الرعية” بهدف كسب التأييد الشعبي وشراء الولاءات وضمان تقديم فروض الطاعة وتكريس الهيمنة الاقتصادية والسياسية للدولة. من هنا يتعين على حيدر العبادي أن يعود مجددا إلى ورقة إصلاحاته التي أطلقها قبل أكثر من عامين والتي بقيت تراوح مكانها بعد أن نجح الفرسان الثلاثة (نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي) في العودة معززين مكرمين إلى مناصبهم وامتيازاتهم وحماياتهم.
ليس القصد من ذلك هو إدخال قضية الفساد في العموميات أو خلط الأوراق، وإنما التأكيد على أن النجاح في مكافحة الفساد سيتوقف في نهاية المطاف على عاملين: الأول هو تسمية الفاسدين وملاحقتهم وفقا للقانون ومعاقبتهم بحسب مقدار الضرر الذي تسببوا فيه، والثاني القضاء على الأرضية الاقتصادية والاجتماعية الملائمة لتفشي الفساد. بدون ذلك تتحول حملة مكافحة الفساد إلى مجرد فقاعة سرعان ما تنفجر ويتلاشى مفعولها.
 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل