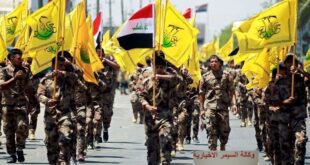السيمر / السبت 10 . 02 . 2018
عامر محسن / سوريا
«الحرب هي الشيء الوحيد الذي نفهمه حقّاً»
تاكيشي كوفاتش ــــ رواية «كاربون معدّل»
من الأساسي، حتّى نفهم سياق القرن التاسع عشر ومركزية الحرب والصراع في عقليّة ذاك الزّمن، أن نبدأ بالمفهوم الذي صاغه مايكل رينولدز لتوصيف السياسة الدولية في القرن الأخير للسلطنة: «الفوضوية التنافسيّة» (competitive anarchism). على عكس النظام الدّولي الحديث الذي اعتدنا عليه، حيث هناك جمعية أمم متحدة وقطبٌ واحد ــــ أو قطبان ــــ يؤمّنان استقرار منظومة الدول ويضمنان حدودها وسيادتها، نحن هنا في عالمٍ ليس فيه قانون دولي، ولا حقوق سيادة، ولا شيء سوى القوّة يمنع بلداً من التوسّع على حساب آخر.
في عالم اليوم، لو كان هناك بلدٌ طرفيّ صغيرٌ وثري (كالكويت) الى جانب بلدٍ طرفيٍّ أكبر وأقوى (كالعراق)، فليس من البديهي أن يلتهم الثاني الأوّل ــــ وهو ما كان سيحصل بالقطع في حقبة تشكّل الدّول. النّظام العالمي سيحمي «زبائنه» ويحافظ على الإجماع القائم حين يكون في مصلحته، ويسمح للدّول الفاشلة بأن تستمرّ ــــ وتتعفّن ــــ في كنفه، بل وسيدافع عنها ويصونها حين تواجه تهديداً عسكرياً من الدّاخل او الخارج (الدّول الوحيدة اليوم التي لا تزال تعيش وفق قواعد «الفوضوية التنافسية» هي «الدول المارقة» كايران وكوريا الشمالية، التي لا تعترف القوة المهيمنة بشرعيتها وتعتبر الحرب ضدّها مباحة حين تصير متاحة).
في عصر السّلطان عبد الحميد أو قادة «الاتحاد والتّرقّي» كانت القواعد مختلفة. أن تتراجع عسكرياً في ذلك العصر لم يكن يعني أن تخسر «هيبتك» أو ينحدر تأثيرك بين الأمم، بل كان يعني أنّ أرضك وأقاليمك ستصبح حلالاً لكلّ من يريد غزوها، وستستغلّ القوة المنافسة كلّ لحظة ضعفٍ لك، أو انكسارٍ بعد هزيمة، لالتهام بعضٍ من أرضك، أو حسم خلافٍ حدوديّ، أو فرض نفوذٍ ووصايةٍ عليك؛ ولن يعصمك هنا قانونٌ ولا شريعة. يقتبس رينولدز مؤرخاً معاصراً وصف اجتياح ايطاليا لليبيا، عام 1911، بأنّه من «أقلّ الحروب تبريراً في التاريخ الأوروبي»، بمعنى أنّ ايطاليا ضمّت آخر ولايةٍ عثمانية في افريقيا من غير أي حجّةٍ أو خلاف، بمجرّد أن سمحت بذلك موازين القوى (وقد حاولت إدارة «الاتحاد والترقّي» أن تنظّم دفاعاً عن ليبيا، وتمكّنت من إفشال حملة الايطاليين لأكثر من سنة. وخاضت روما ــــ ردّاً على ذلك ــــ حرباً بحريّة ضدّ الموانىء العثمانية في شرق المتوسّط، ثمّ وجدت الدّولة نفسها ـــ عام 1912 ـــ تواجه حرباً هائلة في البلقان في وقتٍ متزامن، وقد وصلت الجيوش البلغارية الى مشارف اسطنبول واعتقد الكثيرون أن تلك نهاية الامبراطوريّة).
من هذا العالم الصّراعي خرج التقسيم الحالي للدّول في اقليمنا، وهو الذي صنع أناساً مثل قادة «الاتّحاد والتّرقّي»، ولدوا من رحم الهزيمة العثمانية وخاضوا حروبها وحملاتها؛ فتجد سيرتهم وسيرة ضبّاطهم على مثال مصطفى كمال، الّذي قاتل في ليبيا، ثمّ قاسى حرب الغوار والعصابات في البلقان، وقاتل الرّوس في الشّرق ــــ كلّ ذلك قبل أن يلمع اسمه في الدّردنيل للمرّة الأولى. الجنود العثمانيون الذين هزموا بريطانيا في الكوت عام 1916، مثلاً، كان أغلبهم يقاتل الرّوس قبل أشهرٍ في جبال القوقاز، وكبار السّنّ فيهم قد خاضوا في حياتهم عدّة حملاتٍ، تمتدّ خريطتها من بلفنا الى كارس.
أن تنتصر أو أن تموت
في هذا السّياق، يكتب رينولدز، كان أمام الحكومات العثمانيّة المتأخّرة تحدّيان. أوّلاً، فإنّ نمط الامبراطورية اللامركزية القديم، وإن كان داعماً للإستقرار ولا يواجه تحدّيات داخلية جدية، الّا أنّه لا يخدمك في صراع الدّول الحديثة. المركز في امبراطورية كهذه ، يقول رينولدز، لا يطلب الكثير من الأطراف (فلا يفرض ضرائب عالية، إن وجدت، ولا يهتمّ ليوميات الحكم والقوانين، ولا يشرك الأطراف في مهام الدّفاع والحرب) ولكنّه ــــ في المقابل ــــ لا يحصل على الكثير منها. من دون الضرائب واستغلال الموارد والتجنيد الجماعي لا أمل للحكومات الشرقية في وجه الجيوش الأوروبية الضخمة. هذه المشكلة، يضيف رينولدز، ضاعفتها التغيّرات الديمغرافية، حين ارتفعت نسبة الولادات في اوروبا بشكلٍ كبير وأصبح عدد الرعايا المسلمين صغيرٌ وينحدر أمام المسيحيين (في اوروبا وفي جوار السلطنة وفي داخلها). فأصبحت مضطرّا على الاعتماد على كتلةٍ بشريّة أصغر لمواجهة تحدّيات متزايدة.
من هنا جاءت موجة الإصلاحات العثمانية والمركزيّة المتزايدة و«إعادة فتح» الأقاليم والأرياف وتثبيت الدولة فيها. بعد خسارة البلقان وانحسار مساحة الدولة، مثلاً، أصبح من الضروري للسلطنة أن تستثمر في اراضي الأناضول وتضمن زراعتها واستحصال الضرائب منها (شرق الأناضول كان من أكثر مناطق السلطنة تخلّفاً، واقليم الاسكندرون واللواء السليب كان قد تحوّل الى منطقة مستنقعات قليلة السكان يجوبها البدو الرحّل، فتمّ استغلالها بعد سقوط البلقان وتجفيف المستنقعات وتحويلها الى اقليم منتجٍ للقطن ومركزاً صناعياً هامّاً). المفارقة هنا هي أنّ محاولات المركزيّة هذه، تحديداً، هي ما خلق الاعتراض المتزايد وصعود مقاومات محليّة واحتجاجاتٍ في أرجاء السّلطنة (جرى في الغالب رعايتها واستخدامها من قبل الدّول الغربيّة). المفارقة ايضاً هي أنّ الكثير من هذه السياسات كانت تفشل فشلاً مزدوجاً: على سبيل المثال، تسبب الاصلاحات ثورة للآغوات الأكراد في شرق الأناضول ضدّ الدّولة، وينحاز الأمراء الأكراد الى روسيا لأن اسطنبول تريد حلّ جيوشهم العشائرية ومنعهم من ممارسة السلطة في الاقليم، و ــــ في الوقت ذاته ــــ لا تحوز الاصلاحات على رضى الأرمن وولائهم، بل تزداد النزعات الانفصالية بينهم قوّةً).
ما زاد الطّين بلّةً، بالطّبع، هو أنّ الدّولة العثمانية لم تكن سيّدة نفسها وقادرة على فرض سياسات حمائية وتنموية كما تريد، بل إنّ معاهداتها مع اوروبا كانت تفرض دخول البضائع الغربيّة وحرية التجارة، وتخلق اطاراً قانونياً استثنائياً للأجانب والأقليات يجعل جهود الإصلاح شبه مستحيلة، ويعطي نافذة لكلّ من يريد تحدّيها. في لقاءٍ بين مبعوثٍ عثمانيّ وآخر روسيّ، يروي رينولدز، نصح المسؤول الرّوسي ضيفه بتقليد روسيا في مجال الصّناعة والاكتفاء الذاتي، مشيراً الى أنّ كلّ الأدوات على المائدة أمامهم قد صنعتها مشاغل روسية، فيجيبه العثماني ببرودٍ ونزق أنّ ذلك واضحٌ وبديهيّ ولكنّه غير ممكنٍ، ببساطة، بسبب المعاهدات الاوروبيّة المفروضة.
اثار استغرابي، منذ سنوات، الاحتفاء الكبير للنّخبة المصريّة بأطروحة خالد فهمي عن محمّد علي. هم أكثرهم ليبراليّون محافظون على الطريقة الكلاسيكية، وتيارهم هو استمرارية لـ«مدرسة التحديث» في الستينيات، فالمفترض أن يكون محمّد علي مثالهم الأعلى؛ وذاك كتابٌ من عمق أدبيات ما بعد الاستعمار، يدعو الى قراءة التاريخ «من تحت» واستخدام فوكو، وأنّ مشروع الوالي التركي محمد علي يجب أن نراه من وجهة نظر الفلّاحين الذين قاسوا وماتوا بين رحاه. هذا موقفٌ تتوقّعه من «بعد حداثي» لا تهمه السرديات الوطنية وخطاب التقدّم والتحديث، وهمّه تفكيك خطابات السّلطة والأساطير الوطنيّة، ولكن ما الذي يفعله ليبرالي «تنويريّ» هنا؟ لا تريد التراث الاسلامي ولا تريد محمد علي وعبد الناصر، فماذا تريد تحديدا؟ تحديثٌ «ناعم»، من دون ضرائب وتجنيد، ومن غير نقل الفائض من الأطراف الى المركز؟ البديل المنطقي الوحيد هنا هو ان تطالب بانتدابٍ غربيّ، يقوم بالتحديث نيابة عنك ولا تضطرّ لأخذ أي خيارات (وهذا، حرفياً، موقفٌ يتلاقى عليه كمّ غير قليلٍ من نخب جيلنا في هذه الأيّام).
ما يجعل هذا السؤال أكثر حراجة هو أنّ «الخيار» الذي يتخيّله البعض هنا زائف ولم يكن موجوداً في الواقع. في القرن التاسع عشر لم يكن الخيار هو بين المشاريع المركزية السلطويّة وبين أن تظلّ في «حالتك الأصلية»، في عالمٍ ريفي «قبل رأسمالي»، وأن تعيش منعزلاً سعيداً كال «هوبتس». الخيار الحقيقي أمام محمّد علي وغيره كان بين أن تبني دولةً قادرة على التنافس العسكري، وبين الانهيار والاحتلال وتفكّك المجتمع، وربما الحروب الأهلية والإبادة. الفكرة المركزية هنا، يؤكّد رينولدز، هي أنّ كلّ تراجعٍ للجيوش العثمانية طوال القرن التاسع عشر كانت توازيه سيولٌ من اللاجئين المسلمين، ومجتمعات كاملة تتعرّض للتهجير والتدمير بقسوة، أو استعمارٍ يقتل نصف السكّان (كما في الجزائر وليبيا). هذه هي النكبات التي كانت ماثلةً أمام شعوب هذه المنطقة، واحتمالات المستقبل كانت ايضاً مخيفة. الإصلاحيّون هنا لم يكونوا مدفوعين بهوسٍ عسكريٍّ أو بارانويا أو حبّ الاستبداد، بل كانوا يحاولون التصدّي لتحديات رهيبة في ظروفٍ بالغة الصعوبة (ولكنّك، مع أصحاب التاريخ الانتقائي، لن تفوز مهما فعلت. لو تركهم العثمانيون في حالهم يقولون «تخلّف وظلامية ويستجلبون الاستعمار»، ولو حاولوا بناء دولة مركزية يقولون «مستبدون ظلمة، يرهقوننا بالضرائب ويسوقوننا الى التجنيد والسّخرة». وها اليمن والمغرب، بالمناسبة، لم يقعا تحت الحكم العثماني، فهل تجنبا «التخلّف» وانضما الى ركب الثورة الصناعية؟ هل نجوَا من الاستعمار والاحتلال الغربي؟ أم تعرّضا الى التأثيرات الدولية ذاتها التي أرهقت السلطنة وأسقطتها؟).
المهمة التاريخية
لو أردنا أن نذهب الى أبعد من كلام رينولدز، فإنّ في وسعنا أن نضيف أنّ التماهي بين الدفاع والحرب وبين الدولة من جهة، وبين الدّولة والقومية من جهةٍ أخرى، هو نتاج تجربةٍ اوروبيّة ترجع الى تأسيس «الدولة المطلقة» اثر الحروب الدينيّة، وهي لا تنطبق على اقليمنا بالضرورة. الدّولة في اوروبا لم تكن على طول التاريخ الميدان الوحيد الممكن للتحشيد وتجنيد النّاس، فقد كانت الكنيسة مثلاً تمارس هذا الدور بنجاحٍ خلال الحروب الصليبية، ومثلها مؤسسات عسكرية محلية واقطاعية. غير أن الدّولة المطلقة قد «علمنت» السياسة وركّزت السيادة في كيانها حصراً في القرن السادس والسابع عشر (وجرّدت الكنيسة والاقطاعي والنقابات وباقي مؤسسات المجتمع من هذه السلطات). فأصبحت الدولة، وايديولوجيتها الوطنية، هي الإطار الوحيد المتاح في اوروبا لتجنيد الناس ودفعهم للقتال. هذا هو الدّرس الذي يعلّمنا اياه الالماني كوزيليك، وهو أنّه لا يمكن تخيّل التنوير من غير الدّولة الاستبدادية ــــ لا لأنّ الدولة أعطت «هدفاً» للتنويريين يحاججون ضدّه فحسب، بل لأن فكرة التنوير والحقوق كانت مستحيلة في ظروف الحروب الدينية وحكم الكنيسة والاقطاع. تريد أن تدعو الى ليبرالية بين من؟ بين أناسٍ يذبحون بعضهم البعض؟ وتنادي بحقوقٍ مدنية بين رعايا لا يرون الآخرين مواطنين أو بشراً؟ وكيف تبني «دولة قانون» وتجري انتخابات في مجتمعٍ تنقسم السيادة فيه بين الكنيسة والطائفة والسيّد؟ ودرس كوزيليك الثاني هو أنّك، لو أردت أن تكون استشراقياً وتربط بين مسارك والتاريخ الاوروبي، فاعتمد أقلّه تأريخاً صحيحاً عن تجربة اوروبا.
أطروحة فيفك تشيبر في نقد دراسات ما بعد الاستعمار فيها مشاكل كبيرة وتعميمات، غير أنّها تحوي فكرةً جوهريّة مفيدة، وهي التحذير من تخيّل تواريخ مزيّفة واستخدامها معياراً في السياسة اليوم. يستخدم تشيبر مثال «البرجوازية الليبرالية» وفكرة أنّ هناك في التاريخ الاوروبي شيئاً اسمه «برجوازية متنوّرة»، تنثر الحقوق على النّاس وتشركهم في السياسة، ما يعني ضرورة استنساخها في العالم الثالث ــــ فيما، في الحقيقة، كانت البرجوازية دوماً رجعية ومعادية للديمقراطية، يشير تشيبر، وهي لم تعطِ حقوقاً جماعية الا تحت الضغط والاضطرار. الطبقة الوسطى العربيّة على الهامش، مهما كانت ادعاءاتها الليبرالية، قد سلكت سلوكاً مشابهاً في بلادنا، ووقفت الى جانب مصالحها وضد الأغلبية في كلّ امتحانٍ شعبي، ومصر دليلٌ ساطع (لا شكّ لديّ في أنّ «ليبرالي الاعلام الخليجي» يتخيّل نفسه في دور مشابه، حين يكتب عن الديمقراطية لحساب الأمير، وأنّه يسير على خطى مونتيسكيو، وهو لا يعرف أنّ المثال الذي يقلّده لم يكن موجوداً يوماً الّا في رأسه).
بهذا المعنى، لو تحررنا من القوالب التاريخية والقوانين الحتميّة، فإنّ حركات الهويّة التي نجحت في اقليمنا خلال العقود الماضية (سواء كان دورها سلبياً أم ايجابياً، وبغض النظر عن كونها دينية أم قبلية أم غير ذلك) كانت تحديداً تلك الأقدر على مهام الحرب وتحشيد النّاس، وتسليحهم أو الدّفاع عنهم. والسنوات القادمة، مع اهتزاز النّظام الدّولي، ستثبّت هذه المعادلة بشكلٍ أكبر. الهدف هنا ليس «تصحيح» التاريخ أو استعادته، بل منعه من أن يقيّدك ويكبّلك (فما معنى أن تنشىء دولة عربية قويّة وموحّدة، مثلاً، يكون هدفها النهائي محاربة الايرانيين والأتراك؟ وما معنى أن توحّد السنّة حتّى تحارب الشيعة؟ الخ). والهدف ايضاً أن تفهم كيف وصلنا الى سياقنا الحالي، وأن الخروج منه لا يكون الّا عبر مشروعٍ يربط أهل المنطقة بعضهم بعضٍ، وينظّم الفقراء فيها، ويدافع عن شعوبها ويحميها من التوسّع الغربيّ ــــ فالبديل مكلفٍ ومفجع. هناك أجيالٌ سبقتنا قد تكون تورّطت في تركةٍ ثقيلة وظلّت في حقبةٍ ماضية، وهي لن تغادرها، وآثار الحرب العالمية الأولى وثقافة الهزيمة والتقسيم تنضح من كلامهم وعُقدهم، وخرافاتهم التي يتمسّكون بها؛ غير أنّنا، على الأقلّ، جيلٌ جديدٌ لا حاجة له لحمل أثقال من سبقه، وخلفنا دروسٌ بليغة لا بدّ من تعلّمها، وأمامنا عالمٌ شرسٌ لا يرحم.
الاخبار اللبنانية
 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل