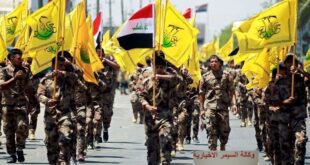السيمر / الاثنين 11 . 03 . 2019
سكت بن بلة، وهو يرتجف من الغيظ، فأكمل الهجمة محمد خيضر. أخذ الرجل يمسك رقبته بكلتا يديه، علامة على الخنق الذي تتعرض له الثورة الجزائرية: «أنتم تريدون تضييق الخناق علينا، ولكننا لن نترك لكم سبيلاً لذلك. لقد دخلت الثورة الآن مرحلتها الحاسمة، وقريباً جداً سننتصر. وبدل أن يساعدنا أشقاؤنا التونسيون، في هذه الفترة الحرجة من عمر الثورة، ها أنتم تتآمرون ضدنا مع الفرنسيين. يا للعار! حكومة تونس تقوم بمنع عبور الأسلحة إلى المجاهدين، من أجل إخماد الكفاح الجزائري». رد بلخوجة غاضباً، وهو متعجب من هذه الافتراءات القاسية التي تُكال ضد حكومته، فقال بحدة: «ليس صحيحاً! كل ما ذكرتموه ليس صحيحاً! اذكروا لي دولة أخرى صنعت معكم ما صنعته تونس؟! نحن الذين منحنا لكم أرضنا، وفتحنا أمامكم حدودنا، وقدمنا في سبيل قضية الجزائر أبناءنا… ماذا حدث في ساقية سيدي يوسف؟! ألم تختلط دماؤنا بدمائكم؟! قولوا لي: أين يوجد مقر الكولونيل بومدين؟! أليس في غار الدماء التونسية؟! وأين ينتشر جنود جيش التحرير الجزائري؟ أليسوا على أرضنا؟! وأين مقر فرحات عباس، رئيس حكومتكم المؤقتة، وأين يعيش وزراؤه؟! أليسوا في تونس العاصمة؟! تقول لي إننا نمنع عنكم السلاح؟! حسناً، ومن أين يأتيكم السلاح إذاً؟! هل ينزل عليكم من السماء، أم ينبت لكم من باطن الأرض؟!». قال خيضر بانفعال: «أنتم تمنعون إيصال شحنات سلاح قادمة لنا من دول الكتلة الشرقية. وتمنعون دخول مستشارين عسكريين تطوّعوا لمؤازرتنا، وجاؤوا من كوبا، ومن الصين». ردّ بلخوجة: «غير صحيح. شحنات السلاح التي جاءتكم من الصين، بعد مؤتمر باندونغ، أوصلناها إليكم». لوّح خيضر بيده ساخراً: «باندونغ! هذا منذ ست سنوات! أي قبل أن يأتي رئيسك العظيم إلى الحكم!».
«لا تُسِئ إلى رئيسي!»
أصبح الجدال التونسي الجزائري عنيفاً ومريراً، وحاول رابح بيطاط أن يهدئ من حدّة الحوار المتشنّج، فيما بقي محمد بوضياف، وحسين آيت أحمد يتابعان المشهد بصمت، ويرمقان بعيون ملؤها الريبة والشك، ذلك الموفد التونسي الذي جاء إليهم زائراً في مقر احتجازهم في «شاتو دي لا فيسارديير». قال بلخوجة للزعماء الجزائريين: «تتهمون بورقيبة بخيانتكم! لولا هذا الرجل الذي توسط لدى ديغول للتخفيف عنكم، لكنتم ما زلتم إلى الآن قابعين في حصن جزيرة إيكس». قال بن بلة متهكماً: «هل تظن حقاً أنّنا نهتم بتحسين ظروف سجننا؟! أبلغْ بورقيبة إذاً بأن اهتماماتنا أكبر بكثير من البقاء في سجن، بل أكبر كثيراً من البقاء على قيد الحياة». ساد الصمت الثقيل لبرهة من الوقت، قبل أن يُخرج بن بلة مظروفاً من جيب سترته، ويمدّه إلى بلخوجة، وهو يقول له: «هذا خطاب إلى رئيسك. كتبتُه البارحة، حين أعلموني بأنك قادم إلينا. أعطه لبورقيبة، من فضلك». رمق بلخوجة المظروف بعين قلقة، ثم مدّ يده وتسلمه. تردد قليلاً قبل أن يقرّر فتح الظرف، والاطلاع على ما يتضمنه. قرأ الدبلوماسي التونسي نص رسالة بن بلة بتمعن، ثم أعادها إلى كاتبها قائلاً له: «هذا أسلوب لا يليق أن تخاطب به رئيس الدولة التونسية. وأنا أرفض أن أحمل هذه الرسالة المسيئة إلى رئيسي». اكفهرّ الجو أكثر في بهو المنزل الريفي الضخم التابع لوزارة العدل الفرنسية، وصار الوضع ينبئ بمشادة لا تحمد عاقبتها. عندئذ، وقف الرجل الصامت رابح بيطاط، وتقدم بقامته النحيلة الطويلة نحو الضيف التونسي، وربّت كتفه، قائلاً له: «لا بأس. هوّن عليك، يا سي الطاهر. العلاقة بين تونس والجزائر أقوى من أن تنال منها كلمات عتاب قيلت بغضب». صمت بيطاط للحظات، ثم مدّ ذراعه، وهو يقول: «فلنتنزه في الحديقة، ونتحدث بهدوء». أحسّ المندوب التونسي بأنه يحتاج بالفعل إلى هذه الاستراحة ليسترجع صفاء ذهنه، بعد تلك الحملة القاسية التي شنّها عليه بن بلة ورفاقه.
«صفقة بورقيبة»
كان سبب الشجار الذي نشب، بين قادة جبهة التحرير الجزائرية ومبعوث الرئيس التونسي تراكم مخاوفٍ، وهواجس، وسوء فهم استمر طويلاً، وأثقل بوطأته العلاقات بين الحكومة التونسية والثوار الجزائريين. ولقد أدرك بورقيبة بحدسه سوء عاقبة هذا الجفاء إذا استقلّت الجزائر بعد حين، وصار المقاومون سادة للبلد الجار الكبير. ويبدو أنّ تلك الخشية من تسارع الأحداث في القضية الجزائرية هي ما دفعت بورقيبة إلى محاولة كسر هذه الجفوة مع القادة التاريخيين لجبهة التحرير الجزائرية. ومن أجل جسر هذه الفجوة، أرسل الرئيس التونسي، في يوم 15 حزيران/ يونيو 1961، مبعوثه الطاهر بلخوجة، القائم بأعمال السفارة التونسية في باريس، لمقابلة الزعماء الجزائريين الخمسة المحتجزين في الإقامة الجبرية داخل منزل ريفي عتيق، في منطقة توركان غربي فرنسا. هل ظنّ بورقيبة أنّ بإمكانه الاستنجاد بهؤلاء الرموز؟! هل حسب أنهم قد يكونون أليَن عريكة من رفاقهم الطلقاء؟! هل توهّم أنّ بمقدورهم أن يمنحوه مباركتهم ليمضي قدماً في جهوده التي يبذلها من أجل إيجاد حل سلمي للقضية الجزائرية؟! ربما. كان بورقيبة، في بداية عام 1961 يهيّئ صفقة تخصّ الجزائر، وقد عرضها بنفسه، في 27 شباط/ فبراير من ذلك العام، على الجنرال ديغول. ورأى الزعيم التونسي أنّ مبادرته تسوية تاريخية ترضي جميع الأطراف المتنازعة في الجزائر. كانت «صفقة بورقيبة» تتمثل في تقاسم الأرض بين الثوار والاستعمار، فينال الجزائريون استقلالهم المنشود، ويعلنون دولتهم في الأجزاء الشمالية من بلادهم.
ويستحوذ الفرنسيون على غنيمتهم الكبرى: الصحراء الغنية بالنفط والغاز والمعادن. ولا بأس، بعد ذلك، في أن يأخذ بورقيبة عمولته: نصيباً صغيراً من الكعكة الجزائرية. فلطالما اشتهى الرئيس التونسي توسيع حدود بلاده التي اعتبرها ضيقة عليه. وكان بورقيبة يتمنى أن يقبل الفرنسيون تغيير رسم الحدود الجنوبية الغربية للبلاد التونسية، فيقتطعوا أجزاءً من صحراء الجزائر، بالقرب من منابع النفط في حاسي مسعود، ويضمّوها إلى تونس. بيد أن تلك الأمنيات البورقيبية لم تجد لها تصريفاً في أرض الواقع، فبقيت حساباته مجرد أحلام يقظة! ولم يلبث الرئيس التونسي أن استيقظ من أحلامه على وقع مفاجأتين مزعجتين. الأولى سمعها من الطاهر بلخوجة، مبعوثه إلى معتقلي توركان. فقد أخبره رسوله أنّ الزعماء الجزائريين السجناء أكثر يُبْساً من رفاقهم المجاهدين الطلقاء. لكنّ خيبة بورقيبة الأخرى من ديغول كانت أشدّ مرارة، فالرئيس الفرنسي لم يظهر اهتماماً بأفكاره، ولم يأبه لـ«الصفقة الجزائرية» التي عرضها عليه، أثناء اجتماعهما، في قصر رامبوييه، غربي باريس. وكان اجتماع الزعيمين يومئذ حدثاً مهمّاً في حسبان بورقيبة. فقد جاء بمبادرة من الجنرال، بعد هجر وصدّ وإعراض استمرت لسنوات، وبعد التداعيات التي أحدثها عدوان فرنسا الوحشي على قرية ساقية سيدي يوسف الحدودية (2)، وكذلك بعد تصلب مواقف الحكومة الفرنسية، ورفضها إجراء مفاوضات مع نظيرتها التونسية للجلاء عن آخر قاعدة عسكرية لها في بنزرت، شمالي تونس. وظنّ بورقيبة أنّ ديغول حين دعاه لزيارته أخيراً، قد لان بعد طول تصلب واستكبار، بيد أنّ الرئيس التونسي وجد «الفيل» – كما كان يحب أن يسمّي ديغول في مجالسه الخاصة – ما زال أنوفاً متكبراً متشدداً. ولم يكتفِ ديغول بالإعراض عن صفقة بورقيبة لتقسيم الجزائر، وإهمال مقترحاته بخصوص إعادة ترسيم حدود تونس الجنوبية، بل تحاشى الخوض في قضية قاعدة بنزرت العسكرية. وبدا جلياً أنّ أهداف الرجلين ليست متطابقة بالمرّة. كان ديغول يريد من بورقيبة أن يؤدي دوراً آخر يختلف تماماً عمّا كان يسعى له الزعيم التونسي، ويحلم به. لم يرَ الجنرال في بورقيبة إلّا مجرد معين لفرنسا، مهمته هي شدّ وثاق الذبيحة، والقبض على قوائمها ليتسنى للذبّاح الفرنسي أن يمرر سكينه بسهولة على رقبة الجزائر الثائرة. ورغم أنّ ديغول أفاض في استرضاء بورقيبة، فأقام له مأدبة عشاء فاخر في قصر رامبوييه، وأسكنه في الجناح الملكي الذي كان يقيم فيه فرانسوا الأول، وكان يظن أنه بذلك يدغدغ نرجسية حاكم تونس، ويرضي غروره المشهور (3)، إلّا أنّ المطالب الفرنسية كانت كريهة ودنيئة إلى درجة أزعجت بورقيبة نفسه، وكدّرته.
الباحث عن دور
كانت خيبة آمال بورقيبة مؤلمة له. ولم يستسغ الرجل عدم استجابة الفرنسيين والجزائريين معاً لمساعيه، ولا تجاهلهم لمطالبه. وحزّ في نفسه أنّ الآخرين، وهو الذي لم يضنّ عليهم بشيء، يمنعون عنه دوراً يبرزه أكثر فأكثر في المسرح الإقليمي. ولا شك في أنّ بورقيبة كان يرى في نفسه زعيماً قديراً، ومحنكاً، وجديراً بالحصول على مكانة دولية لم تتحها له ظروف دولته الصغيرة الفقيرة. واعتقد الرئيس التونسي أنه مؤهلُ أكثر من غيره لكي يؤدي الدور البارز في حلّ قضية الجزائر. أليست دولته هي التي تتحمل أعباء لجوء عشرات الآلاف من النازحين الجزائريين، وعلى أرض بلاده يستقر ساسة الجزائر، ومن حدوده الغربية يواجه الثوار عدوهم الفرنسي؟ فمن أحق منه حينئذ، بأن يُفوَّضَ إليه تمثيل الجزائر؟! ومن أولى منه بأن يطرح مبادراتٍ لحلّ أزمتها، وإقامة السلام على ربوعها؟! وإذا كانت هذه هي الحقائق على أرض الواقع، فعَلامَ يتجاهله الآخرون، ولا يبجّلونه؟! ولماذا لا يعترفون له بفضل، ولا يقرّون له بقدر، ولا يقبلون منه أن يقوم بدور؟!
قرّر الحبيب بورقيبة أن يصعّد مواقفه ليحرج شارل ديغول، وليفرض احترام الجميع له، وخصوصاً أولئك الذين دأبوا على اتهامه من إذاعة «صوت العرب» بأنه عميل لفرنسا، وبيدق في يد الغرب، ومتاجر بقضيتي تونس والجزائر، ومفرّط في حقوق شعبه وأمّته. عزم بورقيبة على أن يواجه «الفيل»، ويروضه، ويجعله يجثو أمامه. وبدا الزعيم التونسي، وكأنه أصبح مسكوناً بهاجس إثبات نفسه أمام العالم أجمع. فإما أن يتضخم حجمه، ويصير زعيماً عالي القامة والمقام، مثل ديغول، أو أن يبقى سياسياً صغيراً قزماً مدى الدهر. ولعلّ بورقيبة، وهو يحسب حساباته قبل خوض معركة بنزرت، تأمّل ملياً في تلك المكانة العجيبة التي وصل إليها الرئيس المصري جمال عبد الناصر، بعد أن خاض معركة السويس ضد المعتدين. لم يكن عبد الناصر، قبل السويس إلا واحداً من ساسة العالم الثالث. ثم صار، بعد السويس، زعيم العالم العربي كلّه، بل زعيم العالم الثالث أيضاً. فلمَ لا يصنع بورقيبة كما صنع ناصر؟! ولمَ لا يغامر في سبيل المجد والعظمة؟! وهل ناصر أشجع منه؟! هل ناصر أصلب منه عوداً، وأقوى شكيمة، وأصلب موقفاً؟! كلا. وكذلك مضى بورقيبة يحشد شعبه من أجل خوض المعركة العظمى في بنزرت. ولم يترك الزعيم التونسي وسيلة دعائية، أو أداة تحريضية إلا استخدمها لتجييش الشعب من أجل القتال. استنفر بورقيبة الشعراء، والفنانين، والصحفيين، والرياضيين، ورجال التعليم، والحزبيين وخطباء المساجد، والخاصة والعامة جميعاً. وعلى مدى أيام متتالية في شهر تموز/ يوليو 1961، كان بورقيبة يؤذن في الناس بالجهاد، فيأتيه الرجال أفواجاً، من كل فجٍّ عميق. وفي أواسط ذلك الشهر اللاهب تجمّع في الثغر الشمالي للبلاد التونسية عشرات الآلاف من المتطوعين المتحمسين لمقاتلة المستعمر، وكنسه نهائياً عن أرض تونس. ولبس بورقيبة لباس الحرب، ووضع فوق رأسه قبعة عسكرية لأول مرة في حياته (وآخر مرة). ثم مضى إلى جبهة بنزرت ليرقص، مع الرجل الذي سمّاه فيلاً، رقصة الحرب.
* كاتب عربي
الهوامش:
(1) سرد الطاهر بلخوجة، مبعوث بورقيبة إلى الزعماء الجزائريين الخمسة، أجزاءً من الحوار الذي دار بينه وبين معتقلي «شاتو دي لا فيسارديير»، في الصفحات 62 و63 و64، من كتابه «الحبيب بورقيبة – سيرة زعيم» (الدار الثقافية للنشر، القاهرة 1999)
(2) سحبت الحكومة التونسية سفيرها من باريس، بعد أحداث يوم 8 شباط/ فبراير 1958 الدامية، وفي أعقاب المجزرة الشنيعة التي اقترفها سلاح الجو الفرنسي. فقد أغار على سوق مكتظ بالناس، وعلى مدرسة ابتدائية للأطفال في بلدة ساقية سيدي يوسف، غربي البلاد. وكانت تعلة الفرنسيين أنّ هذه القرية الحدودية يأوي إليها المقاومون الجزائريون. وبلغت حصيلة المجزرة اثنين وسبعين شهيداً، بينهم خمسة عشر تلميذاً، إضافة إلى مئات الجرحى. واللافت أنّ كافة الدول العربية تضامنت، يومئذ، مع تونس، فسحبت سفراءها من باريس احتجاجاً على المذبحة الفرنسية. ولم ينأَ بنفسه عن هذا الإجماع العربي سوى لبنان الذي خُيِّرت حكومته بين ألّا تأبه لدماء المدنيين التونسيين، وأن تُبقي على روابطها الوطيدة مع فرنسا.
(3) لا شك في أنّ بورقيبة كان رجلاً نرجسياً، وكان الرجل يصرّح جهاراً بأنه «هو الذي خلق تونس، وكانت قبله تراباً، وغباراً». وادعى، ذات مرة، أنه في مقام محمد نبي المسلمين، فهو يحق له أن يبدّل في شريعة الإسلام، وأن يغيّر، بحسب ما يجده من المصلحة. وقال بورقيبة مراراً إنه خامس خمسة عظماء أنجبتهم إفريقيا الشمالية، عبر تاريخها: حنبعل (هانيبال)، ويوغرطة (الملك النوميدي الذي قاد المقاومة ضد روما)، وسان أوغسطين (القديس أوغسطينوس)، وابن خلدون. ولقد تملك جنون العظمة بورقيبة، فجعل يبني له تماثيل في كل مكان ليخلّد ذكره وصورته. ثم صار الرجل، في آخر عمره، مهووساً بالخلود. ولقد أرسل، عام 1973، وزير خارجيته محمد المصمودي إلى ليونيد بريجنيف، طالباً من الزعيم السوفياتي أن يرسل إليه خبراء في التحنيط. وتعجب بريجنيف من هذا الطلب، فأسرّ له المصمودي بأن بورقيبة يريد من أولئك الخبراء أن يحنّطوا جثمانه إذا مات، ويحفظوا جسده من التحلل، لكي يُعرض أمام الملأ، كما هو حال لينين. ورمق بريجنيف وزير خارجية تونس باستغراب، ثم قال له متهكماً: «وهل يظن رئيسك بورقيبة أنه ولينين سواء؟!».
 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل