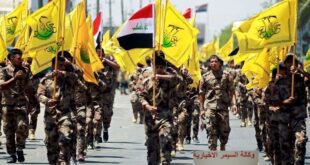فيينا / الأحد 22 . 12 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
بدر الحاج / لبنان
«إني أخشى أن تكون سوريانا آخذة في الانزلاق من أيدينا المتفرقة. ففي الجنوب تتراجع الحدود السورية أمام الحدود اليهودية وفي الشمال تتقلص الحدود السورية أمام الحدود التركية»
أنطون سعاده
الصراع على سورية ليس على من يحكم في دمشق فقط، بل هو أيضاً بين المتنافسين والطامحين إلى قضم المزيد من أراضيها وتقسيمها. فمنذ فجر التاريخ هي قلب بلاد الشام، ومن المستحيل تجاوز أو إلغاء أهميتها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية. إمبراطوريات عدة استولت عليها، وسادت لمدد طويلة ثم بادت.
مع سقوط نظام البعث وتدمير العدو الصهيوني للإمكانات العسكرية السورية، عادت من جديد إلى الواجهة مشاريع تقسيمها، وازدادت شهية العدو والأتراك لاحتلال المزيد من أراضيها. وبالفعل باشر الصهاينة في تنفيذ أطماعهم واستولوا على الجولان كاملاً. وكعادتهم في مشاريعهم التوسعية رفعوا شعار حماية الأقلية الدرزية، وسابقاً في لبنان رفعوا شعار المحافظة على المسيحيين. البعض من قيادات الحركة الاستيطانية الصهيونية أشار صراحة إلى أن الظروف قد أصبحت مؤاتية للاستيطان في سورية، وذكر بالاسم دمشق.
ومن الجانب التركي، ألقى إردوغان خطاب «نصره»، مشيراً (لتبرير تدخّله في سورية) أمام مؤيديه إلى أن مساحات شاسعة من سوريا كانت قد تصبح (إبّان ترسيم الحدود بعد الحرب العالمية) جزءاً من تركيا مثل كيليكيا والإسكندرون وعينتاب والرها، وذكر بالاسم مدن حلب وإدلب ودمشق والرقة إلخ…
هذا الواقع المأساوي المستجد والمعلن رسمياً وبصوت عالٍ أمام العالم أجمع، لا رد فعل عليه حتى الآن، لا من حكام سوريا الجدد ولا ممّا يُسمى جامعة عربية، أو من المؤتمر الإسلامي أو من الأمم المتحدة. والسبب ربما لأن ترامب سبق له أن أعلن أن إسرائيل دولة صغيرة لا بد من أن تتوسع، وبناء على ذلك استغلت كل من إسرائيل وتركيا الفرصة للاستيلاء على المزيد من الأراضي. تتكرّر اليوم مأساة سورية التي دفعت عبر تاريخها الطويل، وما زالت تدفع، ضريبة كونها في هذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي المفصلي. جميع القوى الكبرى المتنافسة عبر القرون تحكّمت بها وحققت مصالحها على حساب شعبها. فقد سبق لفرنسا أن منحت الأتراك لواء الإسكندرون بما في ذلك عاصمة المسيحية في الشرق مدينة أنطاكيا، وكذلك كيليكيا وأصبحت تلك المناطق نسياً منسياً مع الزمن. واليوم، لا مانع لدى الغرب إطلاقاً في أن يمنح العدو الصهيوني مناطق الجنوب السوري، بدليل التبرير الذي أعلنه وزير الخارجية الأميركية بلينكن الذي قال إن إسرائيل دخلت المنطقة العازلة لخشيتها من أن تسيطر المجموعات المتطرفة عليها، والأمر يسري أيضاً على تركيا للسيطرة على ما تريده من الأرض السورية.
من الصعب التكهّن بتطور الأمور في المستقبل، لكن الأكيد أن انهيار السلطة في دمشق، أية سلطة سواء البعث أو غيره، يعني بالدرجة الأولى تشظي الكيان الشامي. تجربة العراق واضحة أمامنا، حصار الغرب للعراق وتجويع شعبه، وحماية مناطق شمال العراق بحجة الحفاظ على الأكراد… كل ذلك أسهم في تفكيك الدولة العراقية بعد الاحتلال عام 2003. واليوم بدلاً من أن تكون أولوية العراقيين صيانة الأرض العراقية ورفض انفصال الشمال وطرد الاحتلال، نسمع كلاماً عن كيان سني وآخر شيعي.
المنازعات الطائفية والإثنية التي تعصف بسورية ليست جديدة، فقد كانت ولا تزال المدخل المفضل لدى الغرب منذ القرن التاسع عشر حتى اليوم لاختراق مجتمعاتنا وتفكيكها، ونشر ثقافة عدم وجود قواسم مشتركة بين الناس الذين يعيشون على هذه الأرض منذ فجر التاريخ. في الواقع الحالي، نحن نشهد في سورية اليوم ما سبق أن واجهته في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. ففي العشرينيات كشفت مراسلات الجنرال غورو حاكم سورية مع رئيس الوزراء الفرنسي الكسندر ميلران قبيل معركة ميسلون عن مشاريع عدة لتقسيم سورية. فقد اقترح ميلران على غورو تقسيم سورية إلى 13 شكلاً من أشكال الانفصال السياسي على أساس الانقسامات الطائفية والإثنية. في حين كان تصور غورو إقامة عدة دويلات فقط: لبنان الكبير، دويلة دمشق، دويلة جبل الدروز، دويلة حلب ودويلة العلويين. وفي ثلاثينيات القرن الماضي ألحقت فرنسا لواء الإسكندرون بتركيا مقابل تأييد تركيا لفرنسا في الحرب العالمية الثانية. أعتقد أن كلام أنطون سعاده في ذلك الزمن وموقفه المتقدم من ضياع الأرض السورية كان واضحاً وحاسماً وكأنه يعيش بيننا اليوم، إذ تتكرر وتتشابه الأحداث. ومما قاله: «وإذا كان على رأس الحكومة السورية رجال مسؤولون يحبون السلام أكثر من الاحتفاظ بالحياة ويقفون تجاه الأخطار المحدقة والمناورات الموجهة ضد سلامة الوطن ومصالح الأمة مكتوفي الأيدي لا يبدون ولا يعيدون فليس موقفهم معبراً عن رغبات الأمة وإرادتها. إن الأمة لا تريد أن تختنق بين الضغط التركي والضغط الصهيوني. إنها قد سئمت العقم الفكري والشلل السياسي اللذين يغمران موقف السياسيين الكلاسيكيين القابضين على زمام الأمور ولا يعرفون من طبائع الأمور السياسية سوى ما يدعون ويجادلون، وما يختلقون من أعذار للشلل المصابين به. إنهم يظنون الأمة مشلولة وليس الشلل إلا في نفوسهم». وكان سعاده قد حذّر في وقت مبكر، بعد عودته الأولى من المهجر في كلمة ألقاها في افتتاح نادي الطلبة الفلسطيني في الجامعة الأميركية في بيروت عام 1933، حيث قال: «إن الخطر التركي أيضاً يقوى ويستفحل. فإن المطامع التركية تتجه إلى سورية أولاً لأن سورية مجزأة ومفككة الأوصال ويسهل التلاعب بمآرب فئاتها اللاقومية العاجزة… فإني أخشى أن تكون سوريانا آخذة في الانزلاق من أيدينا المتفرقة. ففي الجنوب تتراجع الحدود السورية أمام الحدود اليهودية وفي الشمال تتقلص الحدود السورية أمام الحدود التركية».
من المستحيل على من يجهل تاريخه أن يتمكّن من بناء حاضره ومستقبله. الأنماط والكيانات السياسية في بلادنا فرضها الغرب علينا، والأكثرية تقبلتها وانصاعت لها فأصبحت من البديهيات. إن تقسيم ما قسمته اتفاقية سايكس – بيكو يتكرر بشكل علني ليثبّت حالة التفكك والتفسخ الاجتماعي والديني الطائفي التي أظهرت الأحداث الأخيرة أنها لا تزال متجذرة، ولم تنجح عملية نهضوية في اجتثاثها. لقد عجز تنظيم «الكتلة الوطنية»، والانقلابات العسكرية، وحزب البعث، عن إيجاد حل جذري لحالة التمزق في سورية، وهذا ما نحصد نتائجه اليوم.
للتفكك الحالي أسباب عدة منها الجهل، وانعدام الوعي الوطني، والقمع، والتسلط، والفقر، ومؤامرات الغرب والصهاينة، وهؤلاء يعملون لتعميق الانقسامات بهدف استعمالها للسيطرة. صحيح أن الكيان الشامي الحالي قاوم تفكيكه في زمن الاحتلال الفرنسي، ونجح جزئياً في إعادة اللحمة إلى بعض المناطق السورية عبر مقاومة المحتل الذي اضطرّ إلى إلغاء مخططات التقسيم الفرنسية. لكن قرار الإلغاء هذا لم يغيّر في نية المستعمر الفرنسي الذي أمعن في ارتكاب المزيد من تدمير المجتمع عبر اقتراحات متعددة لإقامة دويلات وتحريض فئة على أخرى كما يحدث اليوم. فقد استخدم الفرنسيون الآشوريين والأكراد في لواء الجزيرة للانتفاض على مركزية دمشق، واستخدموا الفرقة الشركسية المشهورة ببلائها في قمع الثورة السورية عام 1925. كما وعدوا بالسعي إلى إقامة دولة للسريان في شمال شرق سورية بقيادة المطران تبوني. وكذلك وعدوا بإقامة وطن قومي خاص بالشركس في منطقة الجولان إثر زيارة وفد شركسي دمشق في 29 حزيران 1939.
كل تلك المشاريع دفنت بسبب مقاومة السوريين، لكن نار الفتن بقيت تحت الرماد وانفجرت مجدداً. لذلك لا عجب إذا تقاسم الأتراك والصهاينة الجبنة السورية الآن، فالأطماع معلنة من الجانبين. هنا أختم بما ورد في يوميات يوسف فايتس مدير شعبة الأراضي والأحراش في الصندوق القومي اليهودي التي صدرت في القدس باللغة الإنكليزية عام 1965. يقول فايتس: «القدس 17 حزيران 1941، لقد ترتب علينا أن نقنع روزفلت وباقي زملائنا السياسيين أن أرض إسرائيل ليست صغيرة إطلاقاً، إذا ما خرج العرب منها، ولا سيما إذا ما وسعت حدودها بعض الشيء، حتى الليطاني في الشمال، وحتى قمم مرتفعات الجولان في الشرق، إذ يُضاف إلينا بمثل هذه العملية نحو مليون دونم من الأراضي الخصبة، وستتسع أرض إسرائيل الغربية عندئذ إلى ستة أو سبعة ملايين يهودي، حتى ولو جاؤوها دفعة واحدة، وهكذا تحل مشكلة أرض إسرائيل في آن واحد. أما العرب فينبغي ترحيلهم إلى العراق وشمال سوريا».
وهكذا يتأكد لنا مجدداً أن الجغرافيا السورية واللبنانية، شاء من شاء وأبى من أبى، يتهددها خطر وحيد هو ضياعها لمصلحة الإرادات الأجنبية. وللحيلولة دون فقدانها السريع، علينا أن نختار إما حماية الأرض والدفاع عنها أو حماية الكراسي والمناصب.
* كاتب لبناني
الاخبار اللبنانية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل