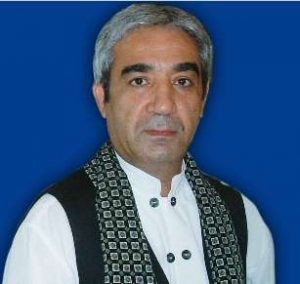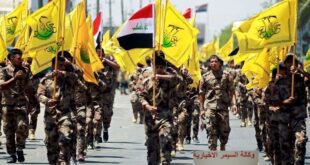السيمر / الاثنين 27 . 11 . 2017
بروفيسور ميثم الجنابي
لم يضع الغزالي فكرة حدود العقل في إطار نظرية متكاملة نسبيا إلا في كتاب (الإحياء). أما الآراء التي تشير إلى ضعف العقل واستحالة قدرته على إيجاد الحلول الشافية لكل المعضلات الفكرية، كما هو الحال في بعض مؤلفاته الأولى (ما قبل التصوف) مثل كتاب (تهافت الفلاسفة) و(الاقتصاد في الاعتقاد) وجزئيا في (ميزان العمل) فأنها تعبّر عن عناصر النقد العقلي للعقل، اي الصيغة المعتدلة لرؤية العلاقة الواقعية والنسبة الممكنة (المجردة) بين الحقيقة النسبية والمطلقة، بين الجزئي والكلي. وبهذا المعنى، فان بروز فكرة محدودية العقل تعكس مستوى من مستويات تطوره العقلي والروحي، أو إحدى الصيغ النموذجية لتجاوز العقلانية اللاهوتية التقليدية. وهو ما يظهره ليس شكل وصيغة ظهور القضية نفسها فحسب، بل ومضمونها ووظيفتها الاجتماعية الأخلاقية والمعرفية أيضا.
إن ارتباط أحكام الغزالي عن محدودية العقل بالمرحلة الصوفية يعكس طبيعة التحولات التي رافقت تطور العقلانية اللاهوتية في تجربته الفردية. فقد اتخذت مواقفه النقدية من العقل والعقلانية في بداية الأمر صيغة الشك المعرفي الذائب في أسلوبه الجدلي، أما في مرحلته الصوفية، فقد برزت ظاهرة “ما وراء العقل” أو حسب عبارته “طور الولاية”، بوصفها قضية فكرية، وأسلوبا للمعرفة، وأحد مستوياتها (المعرفة) في الوقت نفسه.
إن فكرة محدودية العقل التي نعثر على صياغتها العامة في كتاب (المنقذ من الضلال)، تستند إلى نظريته عن درجات المعرفة وترابطها كما بلورها في موقفه من مفهوم الشك والعلم اليقيني. فتكذيب العقل لبعض أحكام الحس، يجعل من بعض أحكام العقل مشكوكا بها أمام ملكة ما وراء العقل، لاسيما وأن حالات النفس (في اليقظة والمنام) يمكنها أن تقدم مادة “برهانية” للمقارنة بهذا الصدد. فقد واجه الغزالي في إحدى مراحل تطوره، شأن كل ممثلي النزعة العقلية الجدلية، إشكالية الإيمان من جهة، وقضية الشك بقدرات العقل على اكتشاف الحقيقة والبرهنة عليها من جهة أخرى. فإذا كان الشك عنده مبنيا على أساس تحليله لصيرورة المعرفة كما هي، بوصفها عملية ارتقاء من الحسي إلى الوهمي إلى العقلي، فان الإيمان يستند إلى ما اسماه بالمعرفة الضرورية. ذلك يعني، أن وحدة الشك والإيمان تبقى على الدوام احد الحوافز الجوهرية القائمة وراء البحث عن الحقيقة كما هي. وبالتالي، فان الإقرار بما وراء العقل، كان يتضمن أيضا الإقرار بعدم نهاية المعرفة.
لم تكن فكرة اللاأدرية وعدم إمكانية المعرفة الحقة جزء من تفكير الغزالي. إذ إننا لا نعثر عليها في جميع مراحل تطوره الذهني والروحي. أما العناصر المتناثرة أحيانا للسفسطة واللاأدرية الصريحة والمبطنة في بعض مواقفه الفكرية، فأنها كانت جزء مما يمكن دعوته بالنتاج الطبيعي الملازم للروح الجدلي المميز لخلافات العصر وأساليبه النقدية واختلافاته المذهبية والعقائدية. ولا يغير من هذه الحقيقة شيئا أيضا أفكاره (خصوصا في مرحلته الصوفية) عن انه لا يعرف حقيقة الشاعر إلا الشاعر، ولا حقيقة النبي إلا النبي، ولا ذات الله إلا الله، وذلك لأنها كانت جزء من موقفه المشدد على أهمية التجربة الفردية والرقي الذاتي، بوصفها أسلوبا لإدراك حقائق الأشياء كما هي. لقد أبقى على ما يمكن دعوته بالجزئية النسبية للأشياء في ذاتها، لكنه لم يجعل منها حقائق خارج المعرفة وإمكاناتها غير المتناهية. بصيغة أخرى، انه شدد على عدم تناهي المعرفة لا على عدم إمكاناتها. وبهذا المعنى، فان “ما وراء العقل” هو في الوقت نفسه تجاوز “لحدود العقل”، وأسلوب جديد “ماوراعقلي” لرؤية الحقائق. ففي معرض حديثه عن درجات المعرفة، اعتبر درجة العقل (الدرجة الثالثة بعد الحس وقدرة التمييز) طورا آخرا يدرك الواجبات والجائزات والمستحيلات وأمورا لا توجد في الأطوار التي قبله . ذلك يعني أنه نظر إلى العقل على انه طور في أطوار المعرفة أو مستوياتها. فإذا كان العقل يدرك الأمور الحقيقية (الضرورية، البديهية)، بحيث نراه يطابق بينها وبين مضمون العقل، فان هناك طورا آخر تتفتح فيه “عين أخرى يبصر بها الغيب وما سيكون في المستقبل وأمور أخرى، العقل معزول عنها كعزل قوى التمييز عن إدراك المعقولات، وكعزل قوة الحس عن إدراك التمييز” . من هنا يبدو واضحا، بأنه في نظرته إلى حدود العقل، ينطلق من مقدمات وأسس معرفية، تعتبر حدود العقل هي الدرجة التي يكف فيها العقل عن الإحاطة بحقائق الأشياء كما هي، وما بعدها تظهر ملكة القوة القادرة على الإحاطة بحقائق الأشياء كلها، والتي يطلق عليها الغزالي أحيانا عبارة “القوة النبوية” وأحيانا أخرى “روح القدس”.
لا تتطابق فكرة حدود العقل عند الغزالي مع اللاعقلانية أو معاداة العقل أو تعجيزه. أنها تشير إلى محدودية العقل التقليدي ومستواه النظري، بما في ذلك المنطقي منه (الشكلي، الصوري). فقد شدد الغزالي على الفرق بين ما اسماه بقدرة العقل المعرفية وبين ما يستحيل إدراكه بالعقل، بين ما هو محال في نفسه وبين محدودية العقل في معرفته. فعندما يتكلم، على سبيل المثال، عن معنى البعث والنشور على أساس تحليل مفهوم الاسم الإلهي (الباعث)، فانه حاول البرهنة على أن الموت هو ليس العدم، وأن البعث هو ليس إيجادا مثل الإيجاد الأول. بصيغة أخرى، انه لم يتطرق إلى هذه القضايا بمعايير العقل اللاهوتي أو الفلسفي (الاستدلالي، البرهاني) بل بذوق المكاشفات الصوفية ومقاييس “الروح القدسي” و”«النبوي”. إذ لم يعد الإنشاء أو البعث عنده مفهوما لاهوتيا قطعيا، أي إيمانيا وعقائديا، بل يتحول إلى صياغة ظاهرية لكينونة الإنسان الوجودية والمعرفية. بحيث يتحول البحث عن “الإنشاء الدائم” إلى أسلوب لتتبع ظهور وتطور الجسد والروح وخصائص المعرفة، بما في ذلك ارتقاؤها إلى اعلي المراتب، كالولاية والنبوة .
أما في إطار الوجود الإنساني، فان الإنشاء والبعث يصبحان الصيغة المجردة لتطور المعرفة وأشكالها من الجهل إلى العلم. لقد أراد الغزالي القول، بأن الصيغة المنطقية العقلية في تعاملها مع الوقائع والحقائق لا تتقبل في الأغلب إلا ما يقع ضمن قواعدها الخاصة. وذلك لأنها تخضع كل قضايا المعرفة لأسلوب إدراكه فقط. بينما نراه يعتبر هذا الأسلوب “تضييقا للرحمة الإلهية”، كما تقول المتصوفة.
أما في مجال المعرفة، فان هليس كل ما لا يدركه العقل محال في نفسه. وبغض النظر عن انه تناول هذه القضية في مجرى تأمله ومناقشته لقضايا الدين الماورائية، وبالأخص قضايا ما بعد الموت، إلا أن المبدأ المجرد العام ظل يحتوي على الكثير من العناصر العقلانية. انه حاول البرهنة على ضرورة التفريق بين البعيد والمحال بالنسبة للمعرفة. لهذا أكد على أن الشرع قد يحتوي على عجائب هي ليست مستحيلة وإنما هي مستبعدة .
إن محدودية العقل تكمن أساسا، بنظر الغزالي، في عدم قدرته على تخطي حدود قواعده الخاصة. فعندما تناول في (مشكاة الأنوار) مسالة قدرة العقل وصفاته الجوهرية مقارنة بالحس، فإنه حاول إبراز خصائص القدرة المعرفية للعقل ومحدوديتها في الوقت نفسه. فالعقل كما يقول لغزالي، يدرك نفسه ويدرك غيره. ويتساوى أمامه القريب والبعيد، بل انه يتصرف “في العرش والكرسي وما وراء الحجاب” . كما يتغلغل العقل إلى بواطن “الأشياء وأسرارها، ويدرك حقائقها وأرواحها، ويستنبط أسبابها، وعللها وحكمها، وكيف حدثت وخلقت، وعلى اي مرتبة في الوجود نزلت، وما نسبتها إلى سائر مخلوقاته” . فالعقل بهذا المعنى لا يدرك أعماق الأشياء وحقائقها، أسبابها وعللها فحسب، بل ومصدرها وكيفيتها وكمها ونوعها ونسبتها إلى بعضها البعض. وبقدرته يمكن التصرف أيضا بالعرش والكرسي، اي كل مكونات وعناصر الوجود وأشكالها. فالموجودات كلها “مجال العقل” كما يقول الغزالي . إضافة لذلك، إن تصرف العقل في الموجودات بنظره يعني أيضا قدرة العقل على بلوغ الحكم اليقيني الصادق عليها. فالأسرار الباطنة ظاهرة عنده، والمعاني الخفية عنده جلية، كما يقول الغزالي . والعقل بهذا المعنى، لا يتعامل مع الوجود بمختلف ظواهره وأسراره الباطنة تعاملا تأمليا بحتا، بل وقادر أيضا على بلوغ الحكم اليقيني الصادق تجاهها. وفي هذه العملية العقلية (من إدراك المعقولات) لا يحدّه حدّ. ولا يغير من ذلك شيا الحقيقة القائلة، بأن العلوم المتحّصلة هي متناهية على الدوام، بينما في قوة العقل إدراك ما لا نهاية له . من هنا يبدو واضحا، بان تحديده لفكرة محدودية العقل لا تتطابق أيضا مع فكرة محدودية المعرفة.
إن محدودية العقل من وجهة نظر الغزالي، تقوم أساسا في رفض العقل أو عدم إدراكه محدوديته الذاتية. ولا تعني هذه الأخيرة سوى عدم إقرار العقل نفسه بالطور الأرقى في رؤية الأشياء، أو ما عبّر عنه أحيانا باحتجاب العقل. فالحقائق كلها لا تحجب عن العقل، و”إنما حجاب العقل حيث يحجب نفسه بنفسه بسبب صفات مقارنة له” . ذلك يعني أن الغزالي لم يسع لبناء أسس القطيعة التامة بين مستويات أو أطوار الإدراك، بل لتأسيس تداخلها الدائم، باعتبارها أنوارا تلتهم بعضها البعض في وهجها المعرفي صوب المطلق. لهذا أكد في(مشكاة الأنوار) على انه إذا كان الروح الحسي والخيالي والعقلي والفكري كلها أنوارا بعضها فوق بعض، فبالحري أن تكون نورا على نور . ولم يقصد هو بذلك سوى وضع الأساس الفكري لإمكانية المعرفة اليقينية الحدسية، التي ترتكز في جوهرها على المعرفة العقلية المذابة في تذوق الحقائق. لهذا شدد منذ مراحل مبكرة نسبيا، في كتاباته الصوفية، على انه “لا يجوز أن يظهر في طور الولاية ما يقضي العقل باستحالته. نعم يجوز أن يقصر العقل عنه، بمعنى انه لا يدركه بمجرد العقل. ومن لم يفرّق بين ما أحاله العقل وبين ما لا يناله العقل فهو أخسّ من أن يخاطب” . وهي ذات الفكرة التي يوردها في (مشكاة الأنوار) عن ضرورة تأويل كلمات الصوفية بالشكل الذي تكون مقبولة للعقل . حيث أكد على أن فكرة الاتحاد لم تكن حقيقة، إذ بعد الصحو، أي بعد أن يرجع المرء إلى سلطان العقل الذي هو “ميزان الله في أرضه”، يعرف أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد، بل شبيه الاتحاد .
من كل ما سبق نستطيع القول، بان “طور الولاية” أو طور ما وراء العقل لا يعني ولا يتضمن ما يقضي العقل باستحالته. ولكن يجوز أن يظهر في “طور الولاية” ما يقصر العقل عنه، بمعنى انه لا يدركه بمجرد العقل. وما يمكنه أن يكون مادة للذوق، أو أن يكون التذوق والمكاشفة هما الأسلوب الأعمق والأدق لرؤية الحقائق. وقد حاول الكشف عن آرائه هذه في (المنقذ من الضلال) على مثال تحليله لمفهوم ومضمون النبوة. انه أراد القول، بأن رفض طور ما وراء العقل، مبني في الأحكام العقلية العادية على أساس عدم وجوده. وهو الأساس الفكري، الذي فنّده في (الإحياء) عندما برهن على أن الانطلاق من مقدمة غياب الشيء لا يمكن أن يشكل أساسا حقيقيا للبرهنة على عدم وجوده. تماما كما أن الجهل به لا يمكنه أن يشكل أساسا حقيقيا ومقنعا للبرهنة على عدم معرفته (وجوده). من هنا استنتاجه القائل، بان أولئك الذين رفضوا طور ما وراء العقل واستبعدوه، لم يستندوا في الواقع إلا على “انه طور لم يبلغه، ولم يوجد في حقه، فيظن انه غير موجود في نفسه” . و اعتبر هذا الموقف هو عين الجهل. وذلك لأن ما وراء العقل بنظره هو الأسلوب الذي يجري به إدراك حقائق الأشياء إدراكا مباشرا كما هي عليه. ويتطابق ذلك في فكر الغزالي مع معرفة الحدس اليقيني، أو المستوى الذي صاغه في (المنقذ من الضلال) بعبارة: “الطور الذي يحصل فيه عين لها نور يظهر في نورها الغيب وأمور لا يدركها العقل” .
غير أن الغزالي لم يجعل من “ما وراء العقل” كيانا مستقلا قائما بحد ذاته له قواعده الخاصة. فهو ينظر إليه، إن أمكن القول، كما لو انه حالة تضمحل فيها وتذوب مقدرات المعرفة، وخصوصا في مستواها العقلي النظري، فيما اسماه “بالروح القدسي النبوي”. فهو المستوى الذي تتجلى فيه “لوائح الغيب وأحكام الآخرة وجملة من معارف ملكوت السموات والأرض، بل ومن المعارف الربانية التي تقصر دونها الروح العقلي والفكري” .
لقد أعطى لهذا الطور طابعا معرفيا ــ أخلاقيا، يتطابق مع أسلوب خاص في المعرفة النظرية والسلوك العملي. أما الصيغة المباشرة لادراكات ما وراء العقل، فهي انكشاف الحقائق انكشافا جليا. وهذا بدوره غير ممكن دون ذلك الجهد، الذي يفرضه تطور “الروح النبوي القدسي”، الذي تلازم في وعي الغزالي مع مضمون الطريق الصوفي نفسه.
 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل