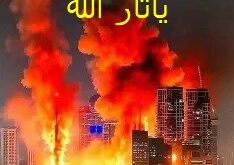السيمر / الثلاثاء 18 . 09 . 2018
جعفر البكلي / تونس
لُفّت جثة عبد الكريم قاسم المضرّجة بالدماء في بطانية، وحملها الجنود إلى خارج قاعة الموسيقى في إذاعة الصالحية. بحثوا عن حبل يشدّون به وثاق قتيلهم حتى لا تنزلق أطرافه من البطانية الصغيرة، فلم يجدوا. لمح أحد الجنود وشاحاً أخضر، في شكل ضفيرة من النسيج، يتدلى من بذلة الزعيم العسكرية المتسخة، فقطعه بسكين، وربط ساقي قاسم به.
ثم تشاور المسلحون في ما بينهم: أين ينبغي أن يدفنوا عدوّهم ويتخلّصوا منه؟! أمرهم قائدهم بأن يتخلصوا من جثث قاسم ورفاقه، تحت جناح الليل، وأن يرموهم في حفرة بعيدة. ثم أضاف قائلاً: «وديروا بالكم، لا حد يحس بيكم».
جنّ الليل، فحملت مفرزة من الجنود جثامين رئيس وزراء العراق السابق ورفاقه إلى بقعة نائية تقع بين بغداد وبعقوبة. وحينما اقتربت الزمرة من معامل الطابوق، في الطريق، أمر قائد المفرزة أعوانه بالتوقف. حفر الجنود حفرة عريضة، ورموا جثث قتلاهم فيها، ثم أهالوا عليهم التراب، وغادروا المكان. كان القمر في تلك الليلة الباردة من شهر رمضان مستديراً. وانتبه بعض الساهرين ممن يقطنون بجانب معامل الطابوق إلى ما حدث في تلك الليلة الغريبة، فاسترابوا في الأمر. ومضى بعضهم إلى المكان البعيد الذي تحلق حوله الجنود، فوجدوا التراب فيه غير سَوِيّ. نبشوا الأرض، فبرز لهم وجه «كريم». أضاء نور البدر في السماء معالم وجهه النحيل. كان الدم لا يزال نديّاً على ثيابه العسكرية. بكى بعض الرجال ألماً على مصاب حبيب الكادحين والمساكين. وحمله الفقراء على أكتافهم إلى أحد البيوت، وغسّلوه، وكفّنوه. سرى خبر اكتشاف جثمان الزعيم بين الناس، فتقاطروا ليلقوا نظرة أخيرة عليه. في الصباح الباكر، صلّى مريدو قاسم على جثمانه، وواروا جسده في قبر صنعوه له بأيديهم. ثمّ إنّ ما صنعه الفقراء لقاسم ترامى إلى مسامع أعوان السلطة الجديدة في العراق. فجاء الجنود على عجل، وألقوا القبض على بعض من اشتبهوا فيهم. عرفوا بعد الاستجوابات أين يقع المدفن الجديد، فمضوا إلى الزعيم ثانية، واستخرجوه من تربته. قرّروا هذه المرّة أن يتخلصوا منه إلى الأبد، وأن يرموه في مكان لا تصل إليه أيادٍ، ولا تتطلّع إليه قلوب. وضعوا الزعيم في كيس، وأثقلوه بقطع من الحديد، ورموا جثته من على جسر نهر ديالى لتأكله أسماك القاع الجائعة.
تلك كانت الخاتمة الأليمة ليومين عصيبين أدمَيا العراق، وطويا صفحة حكم زعيم عربي تضاربت فيه الآراء بين مَن فُتِنوا بتواضعه، وتعففه، وانحيازه إلى المحرومين والبائسين، ومَن استنكروا استبداده، واستفراده، وبطشه. لكننا إذا وضعنا معياراً للحاكم الصالح يتمثل في مقدار تعلق شعبه به، واستفادته من إنجازاته، وتماهيه مع خياراته، بان أنّ عبد الكريم قاسم نسيج وحده بين حكام العراق في العصر الحديث.
«هذي داوركيسة مدسترة!»
نام عبد الكريم قاسم بعد ليلةٍ سهر فيها حتى موعد السحور وهو يسامر خلّانه في بيت صديقه يحيى الجدة في الأعظمية. ومع أذان فجر لجمعة 8 شباط/ فبراير 1963، عاد الرئيس مع طاقم حمايته إلى بيته في منطقة العلوية ليغفو ساعات قليلة. في التاسعة، أيقظه مرافقه المقدم قاسم الجنابي ليخبره أنّ انقلابيين يبثون بياناً مناوئاً لحكمه عبر الإذاعة. اتصل الزعيم قاسم بالعقيد عبد المجيد جليل، مدير الأمن العام. بدا له صوت الرجل، في الهاتف، متوتراً قليلاً. أبلغه جليل بأن مسلحين استولوا على مركز شرطة المأمون، وقطعوا الطريق الدولي الغربي، وأنّ عملية مشابهة حدثت في الباب النظامي لمعسكر الرشيد. وسأل قاسم مدير أمنه: «منو اللي ورا هالطلايب (الحوادث)؟!». رجّح جليل أن يكون طلّاب بعثيون وقوميون هم الذين يناوشون السلطات. فتح قاسم الراديو ليسمع بنفسه ما يقوله المتآمرون. كانت إحدى الموجات تبث بياناً تقرأه بكل حماسة سيدة جهورية الصوت. وظلت طوال الوقت تردد أنه «خائن، وعدو الشعب، وطاغية، وعميل قام الشعب والقوات المسلحة لتخليص العراق من شروره وآثامه». وبين فينة وأخرى، كانت المحطة تذيع نشيداً مصرياً حماسياً، تغنيه أم كلثوم: «والله زمان يا سلاحي». كان قاسم يعلم أنّ هذا هو النشيد الذي اتخذه جمال عبد الناصر سلاماً وطنياً للجمهورية العربية المتحدة. زفر عبد الكريم زفرة حارّة تنمّ عن غضبه ووجيعته، ثم تمتم بصوت خافت: «أخاف هو نفسه اللي ورا هالمؤامرة الجديدة؟!». وأخذ قاسم يفكّر: ألم يكفِ عبد الناصر ما غرق فيه العراق من الدم نتيجة مؤامرة الشوّاف في الموصل؟ هل يريد أن يعيد الكرّة مرّة أخرى؟ فجأة، انقطعت روابط أفكار الزعيم وهواجسه، فقد أذعره سماع انفجار مدوٍّ في مكان غير بعيد عن مسكنه. نادى مرافقَه وصفي طاهر، وصاح به: «إش ديصير برّه؟». أجابه الرجل: «أكو طيارة د تقصف. الوضع خطر، سيدي، لازم نعوف (نغادر) البيت، ونلقى موقع آمن». بدا الغضب عارماً على وجه قاسم، وزمجر قائلاً: «شنو هالخربطة؟! خابر لي جلال الأوقاتي هسّة، بساع (بسرعة)». بعد دقيقة، كان جرس الهاتف يرنّ في بيت آمر القوة الجوية العراقية. رفعت سيدة باكية السماعة، وأخذت تنوح. لم يفهم قاسم ما دهى هذه المرأة هي الأخرى، وقال لها: «انطيني الزعيم جلال، أريد أحكي معاه». صاحت السيدة المفجوعة: «الزعيم جلال! هو بقى زعيم جلال؟! الزعيم جلال مجذوع بالشارع، ودمه يسيل». سكت قاسم وقتاً، ثم تمالك نفسه، وقال للسيدة: «مع الأسف، أختي! البقية بحياتك». وأغلق السماعة.
وضعوا الزعيم في كيس أثقلوه بقطع من الحديد، ورموا جثته من على جسر نهر ديالى لتأكله الأسماك
في العاشرة إلا ثلثاً، من ذلك الصباح، وصل إلى بيت قاسم رفيقه طه الشيخ أحمد مدير الخطط والحركات العسكرية في وزارة الدفاع. أنبأه أنّ طائرتين من نوع «هوكر هنتر» انطلقتا، على الأرجح، من قاعدة الحبّانية، وقصفتا مدرج الطائرات الحربية في معسكر الرشيد، فخرّبتاه لكي لا يعود صالحاً لانطلاق الطائرات أو استقبالها. جلس الاثنان يسمعان الأخبار من المذياع. وكان الخبر الرئيسي الذي يكرره الانقلابيون، كل حين، يقول إنّ عبد الكريم قاسم لقي حتفه، وإنّ كلّ أعوانه انهزموا، فهم الآن بين هارب ومستسلم. وأمّا قادة وحدات القوات المسلحة، فهم جميعاً يؤيدون الثورة الجديدة. وكان على رئيس الوزراء العراقي، حينئذ، أن يفنّد بنفسه تلك الشائعات، لكي لا تنال من عزيمة الجنود أو الجماهير. وقرّر قاسم أن يظهر إلى الملأ. وطلب من طه أن يرافقه فوراً إلى وزارة الدفاع، ليقود من هناك عمليات التصدي للمتآمرين. سلك موكب الزعيم قاسم شارع السعدون، ووصل إلى شارع الجمهورية، ثم استدار قرب باب المعظم، ودخل إلى وزارة الدفاع. وظلّت الجماهير تحتشد أمام الوزارة، وهي تهتف بحماسة: «ماكو زعيم إلّا كريم». حيّا القائد الناس، وأشار لهم بإصبعيه، بما معناه أن المسألة ستحسم خلال ساعتين اثنتين. ثم دخل إلى مقره. شرع عبد الكريم قاسم يكلّم عبر الهاتف قادة وحدات جيشه، ليتأكد من ولائهم له. وعلم أن بعض المعسكرات تشهد حركات تمرد وعصياناً وقطع طرقات. وفكّر مدير الخطط في الجيش العراقي طه الشيخ أحمد قليلاً، ثم اقترح على قاسم أن يقود بنفسه القوات الموالية له، التي تتمركز داخل وزارة الدفاع، ثم ينطلق بها إلى معسكر المنصور، فيجمع القطعات الموالية له من الفرقتين الثانية والثالثة، ويزحف على بغداد، فيبيد بعساكره المتآمرين. كانت تلك خطة منطقية، لكنّ قاسم لم يجد حاجة في أن يقود الجنود بنفسه. فقد اعتقد اعتقاداً راسخاً أنّ القضاء على الانقلابيين سهل المنال، وأنه تكفيه خطبة واحدة يبثها من الإذاعة كي يبدد شملهم، ويزرع في قلوبهم الاضطراب.
كان قاسم واهماً، ولم يكن يقدّر قوة خصومه حقّ قدرها! بدا له أن التمركز في وزارة الدفاع خطوة كافية، فهي قلعة محصّنة حُشِد فيها مئات من الجنود المزوّدين بالمدرعات، وبالمدافع المضادة للطائرات. وظل طه يلحّ على قائده، فاقترح عليه أن يستجيب لمطالب الناس المحتشدين حول الوزارة، ويفتح لهم مخازن السلاح، ويوزعه عليهم، وينظّمهم ضمن قوات شعبية رديفة لجنود الجيش. وضحك قاسم من هذا المقترح العجيب، وقال لمخاطبه: «هيچ رح تصير حرب أهلية! هذي داوركيسة مدسترة (مؤامرة شريرة). وآني ما رح أفتح باب الحرب الأهلية، حتى لو رأسي يروح بيها». في تلك الأثناء، كانت الجماهير تهاجم إحدى الدبابات التي وجهت نيرانها نحو وزارة الدفاع. وصعد رجل إلى برج دبابة، وتبعه متظاهرون آخرون. أخرجوا الجنود من جوف المدرّعة، وانهال العشرات عليهم ضرباً مبرحاً إلى أن ماتوا. كان المتظاهرون يهتفون بهيستيريا: «ما كو زعيم إلّا كريم». تراجعت بقية الدبابات المهاجمة قليلاً، أمام هذا المشهد المروّع. ثم اتخذ قائد المدرعات عبد الكريم مصطفى نصرت قراراً حازماً. أمر نصرت جنوده بتوجيه مدافع المدرعات نحو الحشود، ودعاهم إلى إطلاق النار. استجاب بعض الجنود المستثارين، جراء مقتل زملائهم، لأوامر قائدهم. وتطايرت أشلاء المدنيين في كل مكان. وساد الرعب!
«آني لهسّه صايم، يا أخي!»
كانت اجتماعات عبد الكريم قاسم مع قادة جيشه في غرفة مكتبه، في الطابق العلوي من وزارة الدفاع. وبدا لهم ذلك المكان الذي اختاروا التحصن فيه آمناً. لكن اعتقادهم سرعان ما بان أنه خطأ، فقد ظلت الطائرات المهاجمة تقصف موقعهم حتى هدّمت أجزاءً كبيرة من الوزارة الحصينة. مات كثيرون من العسكريين جرّاء القصف العنيف. وساد الاضطراب والهلع والفزع صفوف البقية الباقية من الموالين لقاسم. ولم يلبث الجنود طويلاً حتى هرب معظمهم، أو استسلموا، أو بدّلوا ولاءاتهم. وأحسّ عبد الكريم بأنّ الأمور تكاد يفلت زمامها من يده. فغادر مكتبه في الطابق العلوي، ونزل بنفسه إلى ساحة المعركة. وأخذ يصدر تعليماته إلى جنوده لكي يستبسلوا في الدفاع. لم يعد الوقت كافياً لتحفيز المقاتلين، فقد استمر قصف الطائرات لهم من الجو، وتكاثرت الدبابات المهاجمة على الأرض. وتفرق المتظاهرون المؤيدون لقاسم – ومعظمهم من الشيوعيين المتحمسين – بعدما نال منهم التقتيل والترويع.
صار الموقف مائلاً بشدة إلى البعثيين، فقد استولوا على كتيبة الدبابات الرابعة في معسكر أبو غريب. وسهّل المقدم خالد مكي الهاشمي مهمة العقيد المتقاعد أحمد حسن البكر للاستحواذ على المدرعات، وقيادة جنود الكتيبة. وسيطر العقيد طاهر يحيى على اللواء الـ19، واتخذ منه مقراً لقيادته. وفي قاعدة كركوك، انضم قائدها حردان التكريتي بسرعة إلى «الثورة». وفي الحبّانية، استطاع العقيد المتقاعد عبد الغني الراوي قيادة اللواء الثامن بكل ما فيه من ضباط وجنود متمردين. وقبل ذلك، تحرك المقدم عبد الستار عبد اللطيف، ومعه أمين سر «حزب البعث»، حازم جواد، ورفيقهما طالب شبيب، نحو مرسلات أبو غريب الإذاعية، فسيطروا عليها، وأذاعوا منها بياناتهم العسكرية الأولى. وانطلق مسلحون من ميليشيا «الحرس القومي» إلى سجن بغداد، فأطلقوا سراح القياديين البعثيين علي صالح السعدي وصالح مهدي عمّاش. ومضى هذان الاثنان ليلتحقا بعبد السلام عارف وصحبه الذين اتخذوا من إذاعة بغداد في الصالحية، مقرّاً لما سمّوه «المجلس الوطني لقيادة الثورة».
غطّى رداء الليل بغداد بالسواد في ذلك الشتاء القارس. ولم يبقَ من المقاومين في وزارة الدفاع سوى جنود الانضباط العسكري بقيادة الزعيم عبد الكريم الجدة. وفُجِع قاسم بمقتل مرافقه وصفي طاهر. ثم زادت أوجاعه عندما طلب منه رئيس أركان جيشه أحمد صالح العبدي السماح له بالانصراف ليستسلم للمتمردين. وتبعه مرافقه النقيب حافظ علوان إلى الخارج. لم يبقَ مع الزعيم في ذلك الليل سوى بضع عشرات من الجنود الأوفياء. ولم يعد هناك مجال للمكابرة: لقد حُسمت المعركة! رفع عبد الكريم قاسم سماعة الهاتف، واتصل بعبد السلام عارف. قال قاسم مستعطفاً نخوة رفيقه القديم: «آني صايم، ولهسّة ما فطرت». ردّ عبد السلام ببرود: «كلنا مثلك. شتريد يعني؟». قال عبد الكريم بخضوع: «هاي هيّه. كل شي خلص. آني قابل أطلع من الحكم، ومن العراق كله». قال عبد السلام بنبرة متشفية: «اسمع كريم. آني مو عبد السلام مال 14 تموز. وإذا تريد تستسلم، فشرطنا: تطلع وحدك، وجماعتك وراك، وكلكم نازعين رتبكم، وإيديكم فوق روسكم، وتسلمون نفسكم بالباب الرئيسي مال الوزارة». قال عبد الكريم بحزن: «ليش هالشرط؟ ترى هاي إهانة!». أجابه عبد السلام، بقسوة: «هذا شرطنا، إذا تريدون تبقون عايشين». كانت معركة احتلال وزارة الدفاع في مراحلها الأخيرة، وصار القتال يدور من ركن إلى ركن. وأخذ بقية جنود قاسم يفرّون متسللين من الطريق المحاذي لنهر دجلة. وزاد الموقف ارتباكاً بعدما قُتِل عبد الكريم الجدة الذي ظل يقود قوات قاسم ببسالة. تسلّم الزعيم بنفسه قيادة جنود الانضباط العسكري. وتراجع مع مرافقيه إلى قاعة الشعب المجاورة لمقر وزارة الدفاع. ثم اتصل ثانية بعبد السلام عارف عارضاً عليه أن يستسلم له ويحقن الدماء، ولكن بطريقة تليق بكرامة قائد سابق للقوات المسلحة العراقية، وبالقيم العسكرية. رفض عبد السلام عارف بكل عناد، لكنه قبل أن يمنح المحاصرين في وزارة الدفاع هدنة حتى السابعة من الصباح لكي يقرّروا موقفهم النهائي.
«أعتز بشرفي»
انبلج ضوء النهار، وأسقط في يد عبد الكريم قاسم. ذهب إلى الحمّام، وأخذ يحلق ذقنه. وحينما دخل أعداؤه إلى قاعة الشعب وجدوه جالساً ينتظرهم بهدوء. كان بجواره جهاز راديو صغير يستمع منه إلى أخبار إذاعة بغداد. نزع الرئيس أول عبد الكريم مصطفى نصرت رتبة الزعيم العسكرية عن كتفي قاسم، واقتاده إلى إحدى ناقلات الجند. أُجلس الزعيم طه الشيخ أحمد، مدير الحركات والخطوط العسكرية، بجانب قاسم. واقتيد العقيد فاضل عباس المهداوي، رئيس «محكمة الشعب» ، ومعه مرافقا قاسم: كنعان حداد، وقاسم الجنابي، إلى ناقلة جنود أخرى. وصل الموكب إلى إذاعة الصالحية، وخرج الجميع إلى البهو ليشاهدوا الأسير ، ودوّت في سماء دار الإذاعة الطلقات النارية ابتهاجاً بالظفر. أخذ بعض الجنود يعتدون بالضرب على موكب الأسرى. ونال المهداوي النصيب الأكبر من الضربات. واندفع الأسرى ليصعدوا إلى سلم دار الإذاعة، مبتعدين عن الجمهور الذي يحاول الفتك بهم. وأدخِل قاسم ورفاقه إلى قاعة الموسيقى، وكانت أول ما اعترض سبيلهم بين استوديوهات الإذاعة. التحق المنتصرون سريعاً بهم. بدا التشفي غير خافٍ ولا مستتر. لم يُخبّئ عبد السلام عارف شماتته. وأمّا أحمد حسن البكر، فظلّ بارداً وهو يتصنع الهدوء. وأخذ علي صالح السعدي يشتم طه الشيخ أحمد، ويصفه بـ«اليهودي ابن اليهودية». واستمرّ صالح عماش يتأمل أعداءه بحقد. وبقي حردان التكريتي وطالب شبيب صامتين، ينظران إلى الفرائس من بعيد. قال عارف لكريم: «تحلف بالقرآن، إنّه إلك علاقة بالبيان الأول لثورة تموز؟». قال قاسم: «إي. هذا البيان كتبناه سويّة». ردّ عارف بغضب: «چذب (كذب). آني كتبت البيان كله، وأنت غيّرت بيه بس كلمة أو كلمتين». أضاف عارف موجهاً سؤاله الجديد إلى قاسم: «تحلف بشرفك العسكري – وبيناتنا القرآن – إنه احنا ما اتفقنا، وباقتراح منك انت، على إعلان الوحدة الفورية ويّة (مع) الجمهورية العربية المتحدة، خلال شهر؟». لم يجب عبد الكريم قاسم، ولعله خشي من عاقبة ردّ فعل رفيقه الأسبق، إن هو كذّبه من جديد أمام الملأ. وجّه أحمد حسن البكر سؤالاً إلى قاسم، فقال له: «چانت (كانت) عدنا محاولة انقلاب عليك، قبل شهرين، بس فشلت. منو اللي قال لك؟». صمت البكر قليلاً ثم أضاف مستفسراً عن هوية الخائن الذي أفشى سرّ البعثيين لقاسم: «العقيد خالد الهاشمي؟». كان الهاشمي موجوداً بين الحاضرين، فنظر إليه عبد الكريم قاسم بإشفاق، وقال: «لا، مو الهاشمي. بشرفي اللي وصّل لي الخبر ضابط اللاخ (ضابط آخر)». صرخ علي صالح السعدي متهجماً على قاسم: «شرفك؟! انت منين لك شرف؟». غضب قاسم وقال له: «عندي شرف. وأعتز بشرفي».
خرج الجميع من القاعة ليتداولوا في الحكم الذي سيصدرونه على أعدائهم. قال عبد السلام عارف: «آني أقول نعدمه. إذا ما يموت هذا الطاغية، رح يبقون جماعته الشيوعيين يتأملون برجعته للحكم مرة اللخ». قال عبد الغني الراوي: «آني مع إعدامه». قال السعدي: «وآني هَم». وافقهم عماش، والبكر، وحردان، وجواد. قُضِي الأمر. دخل عبد الغني الراوي إلى قاعة الموسيقى ومعه جنديان، وأطلقوا رشاشاتهم على الأسرى.
الاخبار اللبنانية
 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل