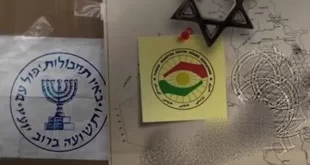السيمر / الثلاثاء 26 . 09 . 2017 — يستعد أكراد العراق للتصويت، الإثنين ، 25 أيلول الجاري، على استفتاء الانفصال عن بغداد، رغماً عن المحاولات الدولية والإقليمية لثني القيادة الكردية عن تلك الخطوة، ولكن يبدو أن الواقع الداخلي للأكراد أنفسهم هو الذي يطرح خياراً اجتماعياً جديداً، حتى لو تحقق حلم الانفصال، وهو مغادرة الإقليم “المستقل” ليصبحوا لاجئين!
وأمام موجات اللجوء الراهنة والمتوقعة بعد إجراء الاستفتاء، يظهر سؤال حول الأسباب التي قد تدفع مواطني الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي إلى ذلك، وهو السؤال الذي تحاول صحيفة (فورين أفيرز9 الأميركية الإجابة عنه في السطور التالية.
أكسبت مشاركة القوات الكردية العراقية في الحملة ضد تنظيم داعش على مدار السنوات القليلة الماضية قيادات الإقليم دعماً عسكرياً غير مسبوق، ووسَّعت سيطرتهم على المناطق المختلطة عِرقياً، المتنازع عليها بطول حدود الإقليم الداخلية مع باقي العراق. لكن مع بلوغ الحملة ذروتها بالسيطرة على الموصل هذا الصيف، قد يتراجع الدعم العسكري الخارجي والاهتمام الدولي.
فعلى سبيل المثال، أقرَّت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مؤخراً، أنَّه بالرغم من إمكانية توقُّع البقاء في العراق بعد هزيمة داعش، فإنَّ حضور الولايات المتحدة سيكون أصغر ويتضمَّن قواعد أقل.
ولذلك يعتقد بعض القادة الأكراد أنَّ لديهم نافذة لفرصةٍ محدودة من أجل تنظيم الاستفتاء، الذي يمثل المحاولة الثانية من نوعها منذ عام 2005.
لماذا الأكراد منقسمون تجاه الاستفتاء؟
وأثار الاستفتاء المقترح ردود فعلٍ متباينة للغاية بين الأكراد العراقيين. فمع أنَّ بعضهم، خصوصاً في صفوف الجيل الأكبر، يؤمنون بأنَّ الاستفتاء سيُمثِّل مكافأة للأكراد على نضالهم الممتد لعقودٍ من أجل الاستقلال، ينظر آخرون، خصوصاً من الجيل الأصغر، إليه باعتباره خدعة ساخِرة من جانب القادة الأكراد للبقاء في السلطة.
ويشعر الكثيرون -وربما الأغلبية- بعدم الارتياح، وأنهم مُمزَّقون بين رغبةٍ في اغتنام الفرصة التي يزعم الاستفتاء توفيرها، وبين انعدام ثقةٍ في القيادة التي طرحته.
وعارضت قيادات بارزة في المجتمع المدني، بما في ذلك بعض الصحفيين والناشطين، علناً هذا الاستفتاء، والتزمت بعض القوى السياسية الصمت حياله أو قدَّمت دعماً مشروطاً فحسب.
وبالفعل، يبدو واضحاً أنَّ الحرس القديم -وهم جيل القادة الذين قادوا الكفاح المسلح من أجل تحقيق الاستقلال الكردي قبل عقود- قد تمسَّك بالسلطة لفترةٍ أطول من اللازم، وأنَّه يُمثِّل الآن العقبة الرئيسية التي تعترض سبيل نشأة كردستانٍ قوية ومستقلة.
وحصد هؤلاء القادة ثمار قتالهم بعدما سحب صدام حسين قواته من شمالي العراق عام 1991. وفي تلك المرحلة، بدأت الأحزاب السياسية الكردية في ترسيخ الحكم الذاتي. فنظَّموا انتخابات، وأنشأوا حكومة إقليم كردستان، وبدأوا في إضفاء الطابع المهني على قوات البيشمركة العسكرية.
لكن حقيقة أنَّ تلك الأحزاب هي من أوجدت مؤسسات الإقليم قد تحوَّلت لتصبح نقطة ضعفٍ كبيرة، إذ خلقت حالة من التبعية غير الصحية بين الطرفين. وبعد فترةٍ قصيرة، قاد الصراع الداخلي بين الحزبين الرئيسيين -الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني- إلى ظهور إداراتٍ متنافِسة داخل كردستان، قسَّمت الإنجازات التاريخية إلى قسمين.
إذا كان الأكراد يريدون كردستان فلماذا يتركونها ويصبحون لاجئين؟
وبعد سقوط صدام حسين في 2003، حقَّق كردستان العراق الكثير من المكاسب، التي عزَّزت التعاون بين الأحزاب فضلاً عن تعزيز درجةٍ من احترام الحريات الديمقراطية. لكنَّ بعض القادة الحزبيين قاوموا التنازل عن سيطرتهم إلى المؤسسات، التي ظلَّت رهينةً لعلاقاتهم المُتغيِّرة باستمرار. فعلى سبيل المثال، يجري تقويض وزارة شؤون البيشمركة، المسؤولة عن قضايا الدفاع، عن طريق عددٍ كبير من القوات الأمنية التي تعمل بصورةٍ مستقلة عنها، وتستجيب بدلاً من ذلك لرموزٍ حزبية متنافسة. وقد أصبحت قوات الأمن تلك أكثر قوة من وحدات البيشمركة المشتركة بين حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني الخاضعة للوزارة. وظهرت قوى سياسية جديدة، لكنَّها لم تنجح في إزاحة الاحتكار الثنائي للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، أو أن تطرح مساراً للإصلاح المؤسسي يمكن تطبيقه.
وفي عام 2012، أبطلت الفوضى الإقليمية أي تقدُّمٍ أُحرِز بين الحزبين. وترك صعود داعش الأحزاب مُنقسِمة داخلياً وأكثر اعتماداً على رعاياها الإقليميين المتنافسين: تركيا بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وإيران بالنسبة للاتحاد الوطني الكردستاني. وقد أفاد ذلك الدعم العسكري بشكلٍ متباين الأحزاب على حساب المؤسسات، وفاقم مشكلة الإقليم الأساسية. ولم ينعقد برلمان الإقليم، الذي عطَّله الخلاف حول حدود الفترة الرئاسية، إلا مؤخراً للمرة الأولى منذ سنتين تقريباً.
وبالتوازي مع ذلك، تراجع اقتصاد كردستان العراق بسرعة: فمنذ الانخفاض الحاد في أسعار النفط عام 2014، أُفيد بأنَّ حكومة إقليم كردستان، التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد تأخَّرت في دفع رواتب القطاع العام الضخم في الإقليم. وفي هذه الأثناء، تقلَّص كلٌّ من الاقتصادين الخاص وغير الرسمي. وانضم آلاف الشباب الأكراد إلى موجات الهجرة إلى أوروبا بحثاً عن حياةٍ أفضل، طارحين بذلك تصويتاً بسحب الثقة من النظام الذي بناه قادتهم.
وبدلاً من معالجة أزمة الشرعية، يُصرّ القادة الذين يقفون وراء حملة الاستفتاء على أوراق رديئة. ويزعم الاستفتاء أنَّه يطرح خياراً، لكنَّه في الواقع يقوم بالعكس. فبإثارة قضية الاستقلال الكردي التي لا تقبل الشك، يضع داعمو الاستفتاء خصومهم -سواء كانوا سياسيين أو شباباً أو مجتمعاً مدنياً أو محللين- في موقفٍ صعب: إمَّا دعم الاستفتاء، وبالتالي القيادة التي اقترحته، وإما معارضته وتعريض أنفسهم للاتهامات بخيانة القومية الكردية. ويشعر بعض أولئك الذين تجرَّأوا على معارضة الاستفتاء بأنَّهم بالفعل تحت التهديد. وقال لنا ناشطٌ من هؤلاء مؤخراً إنَّه يشعر أنَّه سيضطر لمغادرة البلاد، خوفاً من الانتقام من المُصوِّتين بـ”نعم”، إذا ما نجح الاستفتاء.
الاستقلال ربما يكون بداية لمأساة كردية جديدة!
ويخاطر الاستفتاء أيضاً بتكثيف التهديدات الخارجية، التي بدورها ستُقلِّص مساحة المعارضة الداخلية بصورةٍ أكبر. ومع أنَّ القادة الأكراد أشاروا إلى أنَّ الاستفتاء لن يقود تلقائياً إلى الاستقلال، فإنَّها تنشر التصوُّر بأنَّ حكومة الإقليم تحاول الانفصال، وهي السابقة التي ستكون الدول المجاورة، التي تُعَد موطناً لعددٍ كبير من السكان الأكراد، عازِمة على عكس مسارها.
وقد تستغل تركيا وإيران هشاشة إقليم كردستان العراق الأمنية والاقتصادية، لتأليب حلفائهم الأكراد ضد بعضهم البعض. فعلى سبيل المثال، ربما تمارس طهران نفوذها على القيادات المناوئة للحزب الديمقراطي الكردستاني في السليمانية وبغداد، مُؤلِّبةً إيَّاهم على الحزب الديمقراطي الكردستاني والشخصيات الداعمة له في دهوك وأربيل، الذي يتمتع بعلاقاتٍ قوية مع أنقرة. وقد يفاقم تدخُّلٌ كهذا الضغوط المُتشظِّية داخل الأحزاب، الأمر الذي يجعل الانقسامات الداخلية أكثر احتمالاً.
وبعد نضالٍ طويل من أجل إقامة دولة، تلك هي المخاطر التي قد يكون القادة الأكراد على استعداد لخوضها. لكنَّ أولئك الذين طرحوا هذا الاستفتاء ليسوا هم الأشخاص الذين سيتعايشون مع نتائجه. فقد يُعظِّم الاستفتاء الضغط الخارجي، ومعه مشكلات كردستان الداخلية، وكلها تؤثر بشكلٍ رئيسي على الجيل الأصغر. وفي أسوأ السيناريوهات، قد يتذرَّع بعض القادة الأكراد بالتهديدات الخارجية لتبرير حكم أكثر قمعاً في الداخل، ومن جديد سيكون ذلك بشكلٍ أساسي على حساب الشباب الذين سيشعرون بالعجز عن تحدي الوضع الراهن الذي لا يخدمهم.
وقد يضع الاستفتاء أيضاً شركاء إقليم كردستان، لاسيما الولايات المتحدة، في مأزق. فإذا ما استخدم القادة الأكراد نتيجة “نعم” لتشجيع مطالبهم المتعلِّقة بالمناطق المتنازع عليها، قد لا تبقى خياراتٌ كثيرة مطروحة أمام رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، سوى الاعتماد على الفصائل الشيعية المدعومة من طهران، والتي تحظى بوجودٍ عسكري قوي في تلك المناطق، من أجل تحدي يد أربيل العليا. وفي هذا السيناريو، قد تصبح المناطق المتنازع عليها أرضاً خصبة لفصلٍ جديد من الصراع ما بعد داعش. وقد تبرهن الفصائل الشيعية مصداقيتها كمدافعةٍ عن وحدة العراق في تلك المعركة، وتُقوِّض بذلك سلطة بغداد بدرجةٍ أكبر. ومن شأن حدوث تغيُّر في موازين القوى داخل البيت الشيعي العراقي لصالح طهران أن يترك للولايات المتحدة حلفاء قلائل بخلاف الأكراد، الأمر الذي يلائم القادة الأكراد.
الهوية الكردية ليست في رسم الحدود
إنَّ إقليماً قوياً ومستقلاً لكردستان العراق هو الذي يمكنه الوقوف على قدميه بغض النظر عمَّا يفعله جيرانه. وكي يتحقَّق ذلك، يجب على القادة الأكراد، بدعمٍ من الولايات المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين، أن يسلكوا المسار الذي بدأوه بعد عام 2003، وأن يُعزِّزوا المؤسسات بدلاً من مكاتبهم السياسية.
ويجب عليهم ضمان أن يصبح البرلمان وحكومة الإقليم، بما في ذلك وزارة شؤون البيشمركة، منصةً للتعاون الكردي-الكردي، والرقابة على سلطة الحزبين المهيمنين. وفي الوقت نفسه، سيكون من المهم للإقليم أن يُنوِّع اقتصاده، على سبيل المثال إعادة الاستثمار في الزراعة وتشجيع مجال ريادة الأعمال الذي يقوده الشباب، من أجل الخروج من ديناميات الدولة الريعية غير الفعَّالة، التي تُعزِّز الانقسامات الداخلية، وتُنتج التبعية للقوى الخارجية.
أمَّا الأمر الأكثر إلحاحاً فهو أنَّه يتعيَّن على القادة الأكراد أن يكونوا على استعدادٍ لتسليم السلطة إلى جيلٍ أصغر. فالقومية الكردية لم تكن أبداً مُتعلِّقة بمجرد رسم حدود دولة، بل، وكما يفهم قادتها الحاليون جيداً، وكما دافعوا طويلاً، تتعلَّق بتأسيس القيم الأساسية المؤسِّسة للدولة. ويُعَد وجود إحساسٍ مشترك بالدولة لدى مختلف المناطق والأجيال شرطاً مسبقاً لنشأة كردستان عراقٍ قادر على توفير الحكم والأمن لشعبه، سواء كان ذلك الإقليم مُعيَّناً بحدودٍ صلبة أم لا.
الموقف العراقي
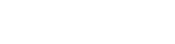 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل