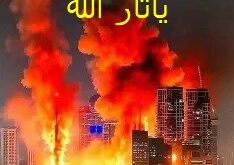السيمر / الأربعاء 24 . 05 . 2017
ضياء الشكرجي
هذه هي الحلقة الثالثة والتسعون من مختارات من مقالات كتبي في نقد الدين، حيث نكون مع مقالات مختارة من الكتاب الرابع «الدين أمام إشكالات العقل».
الدين وجدوى حركات الإصلاح والتنوير والتجديد
نشرت باسمي المستعار (تنزيه العقيلي).
منذ نشأت الأديان، والمصلحون والمأوّلون والمجدّدون والمصحّحون والتنويريون، في حراك فكري مُضنٍ، يحاولون صياغة دين بعيد عن الخرافة والتعصب وثقافة كراهة الآخر، دين يواكب العصر، دين يساوي بين الناس، دين يعتمد العقلانية، دين يقر بحقوق الإنسان، دين يؤمن بالعلم، دين يحترم (المرأة/الإنسان) مساوية مئة بالمئة في قيمتها الإنسانية لـ(الرجل/الإنسان)، دين يقر بالديمقراطية، دين يعتمد النسبية، وينأى عن دعاوى المطلقات والمقدسات والمسلَّمات والنهائيات واللامناقشات، دين يقر بالحريات، ولا يقيدها باسم الله، غالبا من غير مبرر معقول للتقييد، إلَّم نقل القمع للحريات.
كثير من هذه الجهود المضنية حققت ثمة نجاحا، وكثير من المصلحين والتنويريين الدينيين والناقدين للفكر الديني والمصححين والمأولين والمجددين، كانوا متهَمين في دينهم، ولطالما حُكِم عليهم بالتكفير، فأُعدِموا معنويا، وكثير منهم أعدموا جسديا. ولعل أكثر دينَين مارسا القمع الفكري، وسجنا العقل، وصادرا الحريات، وأعدما أهلهما المخالفين/ إما جسديا، وإما معنويا، أو نفيا لهم إما من أوطانهم وإما من الحياة، أو من الحياة الاجتماعية بالعزل والمقاطعة، هما الدين المسيحي والدين الإسلامي، على قدر اطلاعي حتى كتابة هذه الأسطر. ولاحقا وجدت في العهد القديم عشرات عمليات الإبادة الجماعية التي قام بها أنبياء وملوك وقضاة بني إسرائيل، وكذلك ما جرى من قمع للمصلحين اليهود في القرون الوسطى بل والمتأخرة، بل وما يجري حتى يومنا هذا. وجاءت العلمانية والحداثة لتعقلن الكنيسة، أو تحد من صلاحياتها، لترجع إلى دائرة الدين، بعدما أبعد الدين عن السياسة، والعلم والثقافة والاجتماع، وانحصر في الكنيسة والحياة الفردية للمتدين.
وبقي الإسلام أرضية صالحة للخرافة والتعصب والتطرف والإرهاب. نعم هناك إسلام آخر، إسلام العقل، والإنسانية والحداثة والديمقراطية. وما زالت الجهود تبذل في إصلاح الدين الإسلامي، وما زال التنويريون يبذلون ما يبذلون مشكورين من أجل تحديث الإسلام، وربما عَلمَنته ولَبرَلَته ودَمقرَطَته. هناك إعادة نظر في أكثر الفتاوى ثباتا عند المسلمين، لجعلها من الأحكام المتغيرة بتغير الزمان والمكان. نعم يمكن تأويل كل النصوص، حتى نستطيع مشاهدة إسلام، يقر للمسلمة أن تتزوج رجلا من دين آخر أو لادينيا، ويساويها في الإرث وفي تعدد الأزواج، أو يساوي الرجل بها بواحدية الزوجة للرجل، وواحدية الزوج للمرأة، على حد سواء. سنجد عندئذ إسلاما يؤمن بالديمقراطية بالمطلق، ويلغي حكم الردة، ناهيك عن حكم الجزية وعموم أحكام أهل الذمة، ويعطي كامل الحرية للمولود من أبوين مسلمين أن يكون على أي دين يشاء، أو يكون بلا دين. ولكن هذا الإسلام لن ينهي الصور الأخرى للإسلام، فإسلام الخرافة سيبقى، وإسلام التطرف والغلو سيبقى، وسيبقى إسلام تقديس الصحابة والسلف الصالح، وكذلك إسلام تأليه الأئمة، سيبقى الإسلام السياسي، وإسلام تحريم الديمقراطية، الإسلام السلفي والوهابي سيبقى، إسلام التعصب السني، وإسلام الغلو الشيعي سيبقى أيضا، سيبقى إسلام حكم الردة والجزية والجلد والرجم، والرق، وسيبقى إسلام العنف، ويبقى إسلام الإرهاب. سنجد إسلاما لا يحرم السفور، ولا يحرم الزواج المتنوع دينيا، ولا يحرم الانتقال من الإسلام إلى دين آخر، أو إلى اللادينية، أو إلى الإلحاد، سنجد إسلاما منفتحا متطورا ليبراليا عقلانيا إنسانيا، وسنجد النقيض منه.
لذا أقول ليس الحل في إصلاح الدين، ولا في تأويله تأويلا حداثويا، ولا في تنويره، أو تحديثه، بل الحل للإنسانية لا يكون إلا بإنهاء دور الدين، وطيّ ملف الأديان، وإطلاق مشروع العقل، والحداثة، والمثل الإنسانية، والعلم، والإبداع، والنسبية، والتعايش، والحب، والسلام، والعدالة، والرفاه، والتنوع، والتعددية، والحرية التي لا يحدها حد، سوى حدود حريات وحقوق وكرامة الآخر. وإلا فلا نفع في أن ينطلق التنويريون في جهود مضنية في إصلاح ما لا يُصلَح، وتصحيح ما لا يُصحَّح، وتنوير ما لا يُنوَّر، ثم يبذلون الجهود إلى جانب ذلك في درء تهمة الكفر عن أنفسهم، بل نكون على الطريق الصحيح، عندما يكون الواحد منا كافرا بالإسلام الذي ولد عليه، ومُفصِحا عن كفره، ومدافعا عنه، وأن يسمي أحدنا الإسلام نفسه كفرا أو شركا ووثنية، ذلك عندما يرى إيمانه اللاديني هو الأكثر تعبيرا عن حقيقة الإيمان، كما يفهمه، لكن دون دعوى أنه يمتلك تمام الحقيقة، وبالتالي فرؤيته تمثل الإيمان والهدى والحق والاستقامة، ورؤية غيره تمثل الكفر والضلال والباطل والانحراف، إلا بما يراه من نسبية كل ما ذكر. هذا كله لا يعني جواز عدم الالتزام بواجب الاحترام لقناعة الآخر، الذي يرى الإسلام أو غيره من الأديان إيمانا وتوحيدا، وبوجوب الدفاع عن حريته، حتى لو لم يدافع هو عن حريتي.
فنتطلع إلى عالم الإنسان الإنساني والعقلاني، سواء آمن أو كفر، عالم الإنسان النسبي، الإنسان الذي يعيش قلق البحث عن الحقيقة، دون دعوى اكتشافه لتمام ومنتهى الحقيقة، ودون دعوى احتكاره لامتلاكها دون غيره. ونطوي ملف العصبيات الدينية، وملف الحركات التصحيحية والإصلاحية والتنويرية، إلا من آمن بإلهية الإسلام من جهة، وبوجوب مواصلة مساعي التنوير والإصلاح والتصحيح من جهة أخرى، على أن يكون هناك عقد اجتماعي ألّا يُكفِّر أحدنا الآخر، وأن يؤمن كلٌّ بما يؤمن، ولا يؤمن بما لا يؤمن، دون أن يتعسف أحد بحريته، لكن تبقى هناك مشكلة، وهي كيف نلغي نصوص التكفير وثلث كتاب يعتقد أتباعه أنه وحي إلهي هو تكفير للآخر ودعوة لقتاله ووعيد بإخلاده في النار، ونحن لا نملك أن نقول لهم: اتركوا ثلث كلام الله أو نصفه أو ثلثيه؟ أنلام إذا قلنا كفى هدرا للطاقات والجهود فيما لا نفع فيه ولا جدوى منه من محاولات الإصلاح والتنوير؟
27/01/2010
بين إلهية وتاريخية الدين
أكثر من صديق حاورني في نقدي للدين، مسجلا ملاحظة على طريقة تناولي لنقد الدين، هو أني أحاكم الدين بمعايير هذا العصر، من ديمقراطية، ومساواة، وحقوق إنسان، وغيرها، بينما يفترض بي ألا أغفل عن البعد التاريخي، أو لنقل عن وجوب مراعاة ظرفي الزمان والمكان، أو ما يسمى بتاريخية النص.
من حيث المبدأ محق تماما كل من يسجل هذه الملاحظة المهمة. فكيف يا ترى غفلت عن ذلك؟ أو لنقل هل إني فعلا غفلت عنه، أو إن لي ما يبرر استبعاد تاريخية الدين في تناولي له؟
لست مبررا، ولا أنا من النوع الذي لا يتراجع إن اكتشف خطأً منهجيا في تناوله لأي موضوع من هذا النوع. كما إني أعيد تأكيد أني لا أدعي امتلاك أو اكتشاف الحقيقة النهائية التي لا حقيقة بعدها. لكني أقول مراعاة البعد التاريخي لأي نظرية، وأي قانون، وأي ثقافة، أمر لا يجوز إغفاله، عندما يمثل كل ذلك نتاجا بشريا، وبالتالي نسبيا، وقابلا للنقد. وهنا قد يتسرع معترض بقوله: أو لست أنت القائل ببشرية الدين؟ بلى، إني حقا قائل بذلك. إذن؟ مع هذا لا آخذ بتاريخية الدين. لماذا؟ أهو عناد، أم هو إصرار على دحض مقولات الأديان ونفيها؟ لا هذا ولا ذاك. بل هناك قاعدة، وضعها سادس أئمة الشيعة جعفر الصادق، وإن كنت لا أعتمد المقولات الدينية مرجعية لي، لكن هذه المقولة تمثل قاعدة عقلائية، بقطع النظر عمن صدرت. أعني ما يسمى بقاعدة الإلزام، التي لخصها جعفر بن محمد بقوله مخاطبا شيعته «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم»، ويعني بقية المسلمين من المذاهب الأخرى، لاسيما مذاهب أهل السنة.
من هنا فأنا ألزم الدين بما ألزم به نفسه، أو بما زعمه عن نفسه. فلو كان الدين قد طرح كرؤية بشرية، لا تدعي نسبتها إلى الله، أي كون الله (المطلق) هو الموحي بها والمنزل لها، لكان مراعاة تاريخية تلك الرؤية أمرا لازما في تقييمها ونقدها. ولكن كونها تدعي إلهيتها، لا بد من محاكمتها بمعايير فرض إلهيتها. ولأن معايير (المطلق) عابرة لعنصري الزمان والمكان، فيكون من الخطأ محاكمتها بمعايير زمانها ومكانها، لأن الدين يدعي صلاحيته لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة. وبالتالي فالمطلق في حكمته، والمطلق في علمه، واللامحدود زمانيا ولا مكانيا، قادر على صياغة رسالته الموجهة لكل البشرية، من يوم نزول تلك الرسالة إلى آخر ساعة من عمر البشرية قبل فنائها، صياغة صالحة لها لكل أزمنتها وكل أمكنتها.
هناك رأي، هو إن رسول الإسلام على سبيل المثال، لم يدّعِ ما ذكر، فأقول لا يهمني إن ادعى ذلك أو لم يدعه، وإنما أحاكم الدين بما يؤمن به 99,9999% من أتباعه المؤمنين به.
 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل