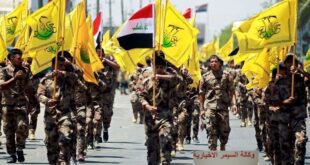الخميس 26 . 11 . 2015
مازن بلال / سوريا
أعادت أحداث باريس ترتيب الحدث السياسي، وشكلت محوراً أساسياً للنظر من جديد إلى طبيعة الصراع مع الإرهاب، فخلال أقل من شهر ضرب الإرهاب مناطق مختلفة ما بين سيناء ولبنان وباريس، وكانت “داعش” هي المسؤول الوحيد عن هذه الأحداث، لكن “الرعب” لا يستطيع التمييز ما بين تنظيم إرهابي والثقافة المشكلة له، ومن الصعب، على المستوى الاجتماعي على الأقل، عزل التشكيلات مثل “داعش” و”القاعدة” عن التصور الذي يتشكل تجاه الإسلام عموماً؛ الأمر الذي دفع إلى العودة مجدداً إلى الحديث عن “الوسطية” و”الاعتدال”، وإعادة إنتاج ثقافة لا تشكل سوى جزء من الأزمة التي تعيشها “الثقافة الإسلامية” وتنعكس بشكل دائم على التكوين الاجتماعي لشرقي المتوسط عموماً.
عملياً فإن “الاعتدال” و”الوسطية” ظهرا مع سقوط ما يسمى “دولة الخلافة”، فمع انهيار السلطنة العثمانية بدأ الجدل الفكري بشأن مقاربات الحداثة داخل البلاد العربية والإسلامية، وكان تطويع أحكام الشريعة بما يتوافق مع “الدولة” وطبيعتها الحداثية أساساً لإيجاد فكرة “الاعتدال” عموماً، فهي بالأساس محاولة لإيجاد محتوى ثقافي وفكري يساعد على التأقلم مع الحالة الجديدة، وظهور دول لا تربطها “مركزية الخلافة”، ورغم تواجد فكرة الوسطية في نص القرآني (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً) لكنها موجودة في إطار تاريخ الشرائع السماوية، فإعادة استخدامها منذ بداية القرن العشرين يختلف جذرياً ويمتلك وظائف جديدة أيضاً.
والتطور الجديد الذي ظهر على مصطلحي “الاعتدال” و”الوسطية” كان مع بروز الإسلام السياسي، وذلك بغرض خلق فصل واضح بين ما هو “ديني” وبين العمل السياسي عموماً، ولكن كافة الأدبيات لم تمنع الاجتهادات التي ينظر إليها البعض على أنها متطرفة، مثل مسألة “الحاكمية” ولم توقف حركة الإسلام السياسي وصراعه العنيف، وهناك حدثان متزامنان أثرا في التعامل مع المصطلحين:
– الأول هو الحرب الأفغانية التي أعادت فكرة “الجهاد” إلى الواجهة، وشكلت محوراً معاكساً لثقافة “النضال” التي عبر عنها اليسار العربي عموماً، فكانت الحرب في أفغانستان تعيد جمع كل الموروث الحديث ابتداء من حسن البنا وأبي الأعلى المودودي وسيد قطب وغيرهم؛ لتنتج ثقافة أكثر تشدداً قدمها عبد الله عزام ثم ظهرت بعد ذلك الكثير من الاجتهادات وصولاً إلى كتاب “إدارة التوحش” الذي مثل ذروة التنظير في الحرب مع “الدولة” بمفهومها الحديث.
– الثانية هي انتصار الثورة الإسلامية في إيران التي أوجدت دولة “ولاية الفقيه” ولكن ضمن نظام سياسي مختلف تماماً عن كافة الاتجاهات التي سادت حركات الإسلام السياسي، وخلقت مفارقة حادة مع الدول التي تتمثل الشريعة الإسلامية بالكامل كالمملكة العربية السعودية.
الحدثان السابقان شكلا صداماً حقيقياً على مستوى “الثقافة الإسلامية”، وساعدا على العودة بشكل قوي إلى فكرة “الاعتدال” و”الوسطية”، ولكن المفارقة الحقيقية هي أن الأحداث الأفغانية كانت بدعم سعودي واضح، فخطت اتجاهاً ما يزال حتى اليوم يجد محتواه الفكري وقوته في مسائل التكفير، بينما سارت الثورة الإيرانية في سياق آخر مرتبط بمصطلح “الاستكبار” وهو في عمقه له علاقة بسياسة الدول، فليس هناك “تكفير” للولايات المتحدة بل وضعها ضمن دول “الاستكبار” وهو المصطلح الرديف لـ”دول المركز” التي أوجدت كل مفاهيم الاستعمار.
في المقابل ظهر مصطلح آخر خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، فـ”الإسلام المحمدي” عبر عن محتوى القيم أكثر من كونه تكريساً لاتجاه محدد في الصراع مع “الثقافة الغربية”، فبينما كان “الاعتدال” و”الوسطية” تفسيرات لمواجهة موجات الحداثة في بداية القرن العشرين، فإن “الإسلام المحمدي” هو تحفيز للقيم ضمن نسق ثقافي مختلف؛ لأنه يريد استيعاب جملة تيارات ظهرت منذ منتصف ثمانينات القرن العشرين، فـ”الإسلام المحمدي” عموماً لم يكن مصطلحاً أطلقه “الإمام الخميني” أو قبله بعقود أنطون سعادة عبر كتابه “الإسلام في رسالتيه المسيحية والمحمدية”، بل تأسس ضمن مشهد “أخلاقي” عام يحاول ترميم ما خلفته الصراعات السياسية تحديداً مع الإسلام السياسي، فهو حمل ثلاثة أمور أساسية:
– الأول عدم تمثيله تياراً سياسياً محدداً، لأنه في النهاية يفتح أفقاً مختلفاً ما يزال بحاجة إلى قراءة وتكريس على المستوى الفكري.
– الثاني يتجاوز فكرة التسامح التي خلفها الكثير من الصراعات التي برزت محاولة فرز المكونات الاجتماعية داخل المنطقة، فنظرته لا تريد محاسبة الآخر بل تكريس “رمزية” للإسلام والشخصية الثقافية ضمن سياق الدول القائمة.
– الثالث الخروج من ازدواجية التطرف – الاعتدال، لأن الفكرة هي عدم وجود “نص مذنب”، أي نص يبيح التطرف، فـ”الإسلام المحمدي” هو انسجام مع حالة قائمة سواء كانت “المقاومة” أو “اعتماد العقل” أو غيرها من المفاهيم التي تتخطى إشكالية إثبات الذات التي برزت بعد انهيار الدولة العثمانية.
ربما تطرح الأحداث اليوم النظر بشكل جدي إلى التعامل مع “حزمة القيم” التي يقدمها الدين، أكثر من البحث في شرعية الأحكام التي سار عليها معظم الباحثين لمواجهة ما سمي”خطر التغريب”، ففي زمن العولمة ربما لم يعد مجدياً “تبرئة الذات”، بل تجاوز أطر التفكير السابق وهو ما يدفع “الإسلام المحمدي” إلى تكوين “رؤية مختلفة” لن تكون في مواجهة “الغرب” أو “الحداثة” بل “التكفير” الذي يضرب مجتمعات شرقي المتوسط، والمجتمعات الإسلامية عموماً، أكثر مما يصيب أوروبا وغيرها من الدول.
الازمنة
 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل