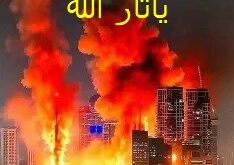السيمر / الخميس 29 . 06 . 2017
ضياء الشكرجي
هذه هي الحلقة العاشرة بعد المئة من مختارات من مقالات كتبي في نقد الدين، حيث سنكون مع مقالات مختارة من الكتاب الرابع «الدين أمام إشكالات العقل».
مناقشة توزيع الناس إلى مؤمن وكافر ومنافق
لا بد من الأخذ بنظر الاعتبار بأن هذه المقالة كتبت في 18/07/2007، أي قبل ما يقارب العشر سنوات من الآن، وبالتالي في بداية تحولي إلى المذهب الظني، أي قبل اعتمادي للاهوت التنزيه، الذي يمثل الإيمان العقلي اللاديني. لذا أرجو أن يأخذها القارئ بالحسبان، واستغنيت عن وضع التعليقات المطولة، فيما لي رأي آخر به بعد تحولي إلى لاهوت التنزيه، واكتفيت بإشارات محدودة ومقتضبة جدا بين مضلعين [هكذا] وغيرت كلمات قليلة جدا، وحذفت أقل منها، دون أن يمس ذلك بالنحو العام طريقة تفكيري آنذاك.
وأنا أطالع كتابا للمفكر الليبي الصادق النيهوم «إسلام ضد الإسلام»، وفي سياق رد التكفيريين المتحجرين على مقالات للمؤلف نشره في كتابه المذكور، وجدت مدى الإرهاب الفكري الذي مارسه معظم هؤلاء الرادّين عليه، وأكثر ما أثار اشمئزازي رد أحدهم، حيث رأيت أن هذا الرجل ككثير من رواد الإرهاب الفكري من أصحاب دعوى احتكار الحق، واحتكار الحقيقة، واحتكار الشرعية، واحتكار الإيمان، واحتكار العلم، يوزع الناس إلى فريقين؛ أهل جنة وأهل نار، مؤمنين (بالإسلام والقرآن ونبوة محمد) في جنة عرضها السماوات والأرض، وكافرين بالإسلام في نار جهنم خالدين فيها لا يُفَتَّر عنهم. فيكتب مُروِّج الإرهاب الفكري هذا
«فَأَمَّا الَّذينَ آمَنوا»: «فَيَعلَمونَ أَنَّهُ الحَقُّ مِن رَّبِّهِم»، «وَلا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنونَ»، «وَأَمَّا الَّذينَ كَفَروا فَيَقولونَ ماذا أَرادَ اللهُ بِهذا مَثَلًا يُّضِلُّ بِهِ كَثيرًا وَّيَهدي بِهِ كَثيرًا وَّما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الفاسِقينَ». ونحن لا نعلم تجاه كتاب الله فئة أخرى إلا المنافقين، «وَإِذا لَقُوا الَّذينَ آمَنوا قالوا آمَنّا، وَإِذا خَلَوا إِلى شَياطينِهِم قالوا إِنّا مَعَكُم، إِنَّما نَحنُ مُستَهزِئونَ؛ اَللهُ يَستَهزِئُ بِهِم وَيَمُدُّهُم في طُغيانِهِم يَعمَهونَ»، «أُولئِكَ فِي الدَّركِ الأَسفَلِ مِنَ النّارِ». ويقول فيهم تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: «وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِّنهُم مّاتَ أَبَدًا». ويقول: «اِستَغفِر لَهُم سَبعينَ مَرَّةً، فَلَن يَّغفِرَ اللهُ لَهُم». انظر كيف يسخط الله على هؤلاء والعياذ بالله.
بالرغم أني قد لا أتفق مع الأستاذ النيهوم في كل التفاصيل، لا من حيث النتائج، بل من حيث طريقة الاستدلال على بعض ما ذهب إليه، مما أتفق معه، ولكني لا أتفق معه في الدليل أو طريقة الاستدلال التي استخدمهما، ولكنه في كل الأحوال زميل لي – أنا النوعي – في كونه ضحية من ضحايا الإرهاب الفكري الممارَس ضده من قبل المُنغَلِقين والنَّصِّيين والقَوالِبيين والمُتَزَمِّتين والتَّكفيريين. لست [آنذاك] بصدد تخطيء القرآن، باعتبار أن هذا الرادّ المُتعسِّف التكفيري استخدم آيات القرآن في توزيع الناس على هذه الجبهات الثلاث، وأكيدا إنه لن يُدخِل الجنة حتى كل من ينطبق عليهم عنوان المؤمنين بالمصطلح القرآني، أي المؤمنين ليس بالله واليوم الآخر وربما بالرسل والأنبياء وحسب، بل المؤمنين بالذات بالإسلام دينا شرعه الله، وبالقرآن كتابا أنزله الله، وبمحمد رسولا بعثه الله، بل سيوزع حتى هؤلاء («الَّذينَ آمَنوا» بالإسلام) إلى ثلاثة وسبعين فرقة، يبعث باثنتين وسبعين منهم إلى نار جهنم، خالدين فيها أبدا، لا يُخَفَّف عنهم العذاب، ولا هم يُستعتَبون، ولا هم يُنصَرون. أقول لست [آنذاك] بصدد التشكيك بما جاء به القرآن بهذا الصدد، ولست بصدد تأويل هذه الآيات، التي لي [آنذاك] فهم خاص لها، لا أنفرد به، بل يشاركني فيه عدد غير قليل من مُفسِّرين وعلماء كلام ومفكرين إسلاميين وأساتذة حوزويين وأساتذة أزهريين، ذلك أن الإيمان نسبي، كما إن الكفر نسبي، وليست القضية بهذه البساطة في جعل من لم يؤمن بالإسلام من أهل النار، وهناك الكثير من نصوص القرآن والحديث مما يؤيد ما أذهب ويذهب من ذكرت إليه [اكتشفت لاحقا خطأ فهمي ذاك قرآنيا، مع صحته فلسفيا]. وإنما أردت فقط أن أشير إلى أن التقسيم بحسب الموقف من الإسلام ليس ثلاثيا، بل هو رباعي. فالتقسيم الثلاثي يقول أن من الناس في موقفهم من الإسلام بشكل خاص، وليس من سائر مفردات الإيمان الأخرى، إما مؤمن بالإسلام، وإما كافر به، وإما منافق، أي يضمر الكفر ويظهر الإيمان. أما الفريق الرابع هو المؤمن الظني، وأقصد بـ (المؤمن الظني)، أو (المُوقِن الشاكّ)، أو المؤمن على نحو الاحتمال، راجحا كان الاحتمال، أو متساوية فيه كفة الثبوت مع كفة النفي، أو حتى مرجوحا عليه. هؤلاء (المؤمنون الظنيون) [أو اللاأدريون الدينيون] وقد انفتح عليَّ بعضهم باسمه الصريح تارة، أو تارة أخرى باسم مستعار، من خلال الحوارات عبر الإيميل، فإنهم [كحالي آنذاك] يؤمنون بدرجة اليقين بالله واليوم الآخر، أي البعث والجزاء، لكونه من لوازم العدل الإلهي، ولكون العدل من لوازم الكمال الإلهي، ويحتملون صدق نبوة الأنبياء وبعث الرسل، بما في ذلك نبوة محمد، وبالتالي يرتبون الأثر على هذا الإيمان الظني، أو الاحتمالي، وإلم يكن يقينيا قطعيا، وإلى جانب ذلك يحاولون أن يفهموا الإسلام على ضوء العقل النظري منه والعملي، والعدل الإلهي منه والإنساني، والقيم الأخلاقية، والمثل الإنسانية، ويحتاطون في ما يمكن فيه الاحتياط بين إيمانهم الظني بنبوة محمد من جهة، وشكِّهم من جهة أخرى بكون الإسلام نتاجا بشريا، وإن كان قد لا ينفصل كليا عن ثمة بُعد إلهي، فيما هو الإلهام للنبي، الذي جمع بين الإيحاءات الذاتية عبر عمق العلاقة الروحية له بالله [ولو في المرحلة المكية]، والإلهامات الإلهية التي قد يكون الله سدده بها، أو هكذا يستوحي من كل تفاعلات واعتمالات الإيمان في عقله وقلبه وروحه [محاولة فهم لي آنذاك تغيرت جذريا]. هؤلاء ليسوا بكافرين، ولا هم بمنافقين، ولكنهم – صحيح – يمارسون التقية في عدم البوح بإيمانهم الظني، خشية أن تُسدَّد إليهم سهام التكفير من التكفيريين، وهذا ليس بنفاق ولا باطنية، بل هو لون من الحكمة، ثم إنهم ولتقواهم لا يريدون أن يتحملوا مسؤولية نقل إيمانهم الظني إلى غيرهم، لعله يتحول عند هؤلاء الغير إلى شكّ، قد يكون أقرب لنفي الدين – من أجل ألا أقول الكفر – منه إلى الإيمان. ومن يرى أن الإيمان الظني المقترن بحسن الإيمان وروحانية العلاقة مع الله والتخلق بمكارم الأخلاق، من يراه نفاقا، فلمرض في قلبه، أو لقصور في عقله، وربما لجهل منه بالقرآن [يوم كنت ما أزال أحتمل إلهيته]، فالقرآن يحدثنا عن الظن كدرجة من درجات الإيمان، يمتدح الله أصحابها بقوله تعالى: «وَاستَعينوا بالصَّبرِ وَالصَّلاةِ وَإنَّها لَكَبيرَةٌ إِلّا عَلَى الخاشِعينَ الَّذينَ يَظُنّونَ أَنَّهُم مُّلاقوا رَبِّهم وَأنَّهُم إلَيهِ راجعونَ»، وهنا يُعتبَر الإيمان بالمعاد بدرجة الظن، وليس بدرجة اليقين، مقبولا وممتدحا أيَّما امتداح من الله، بالرغم من أن المعاد [يفترض أن يكون] من الواجبات العقلية، وبالتالي مما ينبغي الإيمان به بدرجة اليقين، بينما الإيمان بالنبوة التي هي ممكن عقلي، وإن ثبتت بأدلة أخرى، هذا الإيمان بدرجة الظن يكون حسب فهم هؤلاء مرفوضا، لكنه ليس مرفوضا من الله، تعالى برحمته وعدله عن ذلك علوا كبيرا، بل من أولئك الذين نصبوا أنفسهم مُتحَدِّثين رسميين عن الله، ولعله مُستشارين لله، تعالى الله عن ذلك، وتوهموا أنهم يملكون مفاتيح الجنة ومفاتيح النار، فيُوصِدون أبواب الجنة دون كل من يخالفهم في جزئية من جزئيات فهمهم للدين، ويفتحونها لاستقبال من هو على ذوقهم، ويفتحون أبواب جهنم كلها على أوسع ما تُفتَح على كامل مصاريعها، ليزجّوا فيها أولئك الذي لا يروقون لهم. إنني مع حواري مع هؤلاء (المؤمنين الظنيين)، وإن حاول البعض أن يقدم لهم الأدلة على صدق الإسلام، لم يستطيعوا أن يقتنعوا بها، وبقوا على مراوحتهم بين التصديق وعدمه، وجدتهم مع ذلك يعيشون حالة من العلاقة الروحانية الرائعة مع الله، ويحاولون أن يعيشوا الدين [واليوم أقول الإيمان] في بعده الأخلاقي والإنساني على أروع ما يُعاش، فلم أجد ما يبرر لي زجهم في خانة غير المؤمنين بالإسلام [لنقل غير المؤمنين بالله]، ولا في خانة المنافقين، خاصة إنهم يعتقدون إن الله يرضى منهم صدقهم معه ومع أنفسهم ويرجون أن يثيبهم عليه «لِيَجزيَ اللهُ الصّادِقينَ بصِدقِهم» وسيغفر لهم خطأهم في بعض ما آلوا إليه من نتائج في قناعاتهم، بحكم إن «اللهَ لا يُكلِّفُ نَفسًا إِلّا وُسعَها». هذا بقطع النظر عما كتبته مرة في مفهومين مهمين، هما مفهوم «الملحدون الإلهيون»، ومفهوم «المرتدون المتدينون». إن التأسيس لهكذا نوع من فهم للدين عموما، وفهم للإسلام خصوصا، لا يعبر عن ترف فكري، ولا عن الخوض فيما يُفَضَّل عدم الخوض فيه، كما يعتقد البعض، بل هو ضرورة لبعث ثقافة دينية جديدة، تنبذ التزمت، والتطرف، والتعصب، والتكفير، ودعوى احتكار الحق، وكراهة الآخر، والانغلاق، والجمود النصي، وتقديم (شكل) التدين على (جوهر) التدين [أو الإيمان على الدين]، لأن هذه الثقافة ضرورة من ضرورات التعايش بسلام مع الآخر الديني، والآخر المذهبي، والآخر المدرسي، والآخر الفكري، والآخر الثقافي، والآخر السياسي. فالإنسانية في حاجة إلى تأصيل السلام والمحبة فيما بين أفرادها وجماعاتها وشعوبها وأممها وحضاراتها، لأنه «لا يَنهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذينَ لَم يُقاتِلوكُم فِي الدّينِ وَلَم يُخرِجوكُم مِّن دِيارِكُم أن تَبَرّوهُم وَتُقسِطوا إلَيهم، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقسِطينَ، إِنَّما يَنهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذينَ قاتَلوكُم فِي الدّينِ وَأَخرَجوكُم مِّن دِيارِكُم وَظاهَروا عَلى إِخراجكُم أَن [تَـ]تَوَلَّوهُم، وَمَن يَّتَوَلَّهُم فَأُولئِكَ هُمُ الظالِمونَ»، فهناك صنفان من الذين لا يدينون بدينكم، صنف نهاكم الله [حسب القرآن] حصرا – أي لم ينهكم عن غيرهم – أن تتولوهم أي أن تتخذوهم أصدقاء، وهم 1) الذين قاتلوكم في الدين، أي بسبب أنكم تدينون بغير دينهم، و2) أخرجوكم من دياركم، أي من بيوتكم وأوطانكم، و3) ظاهروا على إخراجكم، أي ساندوا عملية الإجلاء والتهجير والتشريد [مع إن الآية تعتبر واحدة من المنسوخات بآيات السيف المدنية، إلا أن هناك من القلة ممن لا يرى أنها نسخت]. أما الذين لم يمارسوا معكم مثل هذه الممارسات التعسفية الظالمة، وقبلوا أن يتعايشوا معكم، رغم اختلافكم معهم في العقيدة، فإن الله [حسب القرآن، وبالتالي حسب عقيدتكم] لم ينه عن توليهم، أي اتخاذهم أصدقاء تربطكم وإياهم روابط إنسانية من برّ، أي مودة وتعاون وحسن معاشرة، وهذا يمثل أخلاق الحد الأعلى، ولا عن أن تعاملوهم بالعدل، وهذا يمثل أخلاق الحد الأدنى. وإذا اعترض معترض على ذهابي إلى هذا المعنى، لأن الآية تكلمت عن عدم النهي عن معاملتهم بالبر والقسط، ولم تذكر شيئا عن عدم النهي عن التولي، بينما هناك آيات تنهى بشكل واضح عن حرمة تولي غير المسلمين، فأقول إن الآية التالية لها التي تتدارك بقول «إِنَّما يَنهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذينَ قاتَلوكُم فِي الدّينِ وَأَخرَجوكُم مِّن دِيارِكُم وَظاهَروا عَلى إِخراجكُم أن [تَـ]تَوَلوهُم» واضحة الدلالة بـ (إنما) التدارك والحصر وبالمقابَلة، ولي دراسة سابقة مستفيضة في مسألة النهي عن التولي، لعلي أعيد تقديمها، لأنها كتبت قبل سنوات، وقبل أن يلتفت كثيرون إلى كتاباتي. [آخر سورة (التوبة) نسخت كل ما قبلها من آيات السلام والتسامح.]
أرجع فأقول كفى تقسيم الناس إلى ثنائية (أسود/أبيض)، أو إلى (مؤمن/كافر)، أو إلى (أهل جنة/أهل نار). اتركوا ذلك لموازين الله، موازين العدل المطلق والرحمة التي كتبها على نفسه، والتي وسعت كل شيء، ثم إنما الرحماء يرحمهم الله، كما في الحديث النبوي، فكيف ينتظر رحمة الله من انتزع الرحمة من قلبه تجاه كل آخر مغاير، حتى لو كان آخر قريبا، ومغايرا مغايرة جزئية.
فإن التقسيم الثنائي (مؤمن-كافر)، أو التقسيم الثلاثي (مؤمن-كافر-منافق) لا يؤخذان بهذه السطحية، ففي كل إيمان يختزن ثمة كفر، ولعل الذي يختزنه من كفر في إيمان التكفيريين أكثر بكثير مما يختزنه في كفر الشاكّين في العقيدة، أو المتسامحين في الالتزام. وحتى المنافقين، فليسوا كلهم من أهل النار [مع فرض وجودها]، فالنفاق مستويات ودرجات، وهذا ما يصدح به القرآن نفسه بقول «وَيُعَذِّبَ المُنافِقينَ إِن شاءَ، أَو يَتوبَ عَلَيهِم، إِنَّ اللهَ كانَ غَفورًا رَّحيمًا»، وإن من الإسلاميين من تنطبق عليهم صفة النفاق أكثر بكثير مما تنطبق على العلمانيين، كما يحاول معظم الإسلاميين أن يروجوا له، وإن من المتدينين من ينطبق عليهم النفاق أكثر بكثير من غير المتدينين، إذا كانوا من المرائين، والرياء كما هو معروف هو النفاق الأصغر والشرك الأصغر، وما كان صغيرا، يمكن أن يكون كبيرا، والعكس بالعكس. وكذلك من النفاق الذي يمارسه الكثير من المؤمنين هو التناقض بين القول والفعل، بين المدعى والسلوك «يا أيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لِمَ تَقولونَ ما لا تَفعَلونَ، كَبُرَ مَقتا عِندَ اللهِ أن تَقولوا ما لا تَفعَلونَ».
والشك في كل الأحوال خير من النفاق، لأن الشك حالة غير إرادية على الأغلب، حيث «لا إِكراهَ فِي الدّينِ»، لكن النفاق حالة إرادية واعية. علاوة على أن الشك ليس كله سيئا ومدانا، فالشك، كما يعبر المفكر مطهري، إما إيجابي، وهو شك البحث عن الحقيقة، وما أسميه بقلق المعرفة، وإما سلبي، وهو شك العناد والمكابرة. أما الظن فهو كما بينا درجة من درجات الإيمان، ومن فسر من المفسرين أن المقصود بالظن الوارد في الآية بقول «الخاشِعينَ الَّذينَ يَظُنّونَ أَنَّهُم مُّلاقوا رَبِّهم وَأَنَّهُم إِلَيهِ راجعونَ» هو اليقين، فهذا تعسف باللغة لا مبرر له، فالقرآن يتكلم عن اليقين بشكل واضح، وبلغة لا تقبل الشك عندما يقول «وَبِالآخِرَة هُم يوقِنونَ»، فلماذا يريد الله في هذه الآية اليقين، ويستخدم لها مفردة الظن؟ [هذا إذا سلمنا بأن القرآن كتاب الله، لكن يختلف الأمر إذا كان المؤلف إنسانا.] والقرآن أورد الظن بمعناه السلبي المرفوض، عندما يُراد له أن يَحِلَّ مَحلّ الحق، بعدما يتبين الحق بشكل يقيني، فالظن وإن كان أعلى درجة من الشك، إلا أنه غير مقبول عندما يقابل اليقين، لمن وصل إلى اليقين في شيء، من هنا جاء «إنَّ الظَّنَّ لا يُغني عَنِ الحَقِّ شَيئًا»، وليس كل ظن مرفوض ومدان. وأذكر بموقف القرآن الرافض للتعميم والإطلاق بتعبيره عن أهل الكتاب الذي رفضوا دعوة الإسلام وبقوا على دينهم بأنهم «لَيسوا سَواءٌ» [واليوم أميل إلى أن مؤلف القرآن أراد بالآية آنفا غير المعنى الذي أولتها إليه آنذاك].
لكن التكفيريين إنما يختارون من القرآن ما يؤيد نزعتهم التكفيرية، وروحيتهم المحتقنة بالحقد والكراهة والغيظ تجاه كل مغاير ديني، أو أحيانا كثيرة تجاه كل مغاير مذهبي، بل كل مغاير لفهم الدين على ضوء نفس الدين (الإسلام)، ونفس المذهب الذي ينتمون إليه، سواء كانوا من التكفيريين السنة، أو من التكفيريين الشيعة. وإذا قيل أن التكفيرية في الوسط السني أشد ظهورا وأكثر تجذرا تاريخيا وفقهيا وعقائديا، بحكم ما ورثوه من إسلام السلطة القمعي التعسفي المدعي لاحتكار الحق والشرعية، فإن الشيعة ليسوا كلهم مبرئين من مرض التكفيرية القاتل لكل المعاني الجميلة، لمعاني الإيمان، للعلاقة الروحية بالله، للسلام، للإنسانية، لاسيما أولئك الذي يتحركون في خط التزمت الديني، أو التدين السياسي، أو التعصب الطائفي، وكله غريب على روح وجوهر الإيمان، بكل ما ينبغي أن يزخر به من محبة ورحمة وتسامح ومسالمة.
18/07/2007
 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل