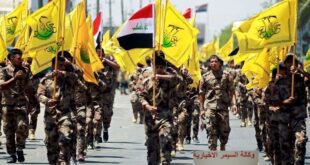السيمر / الخميس 06 . 07 . 2017
ضياء الشكرجي
هذه هي الحلقة الثالثة عشر والمئة من مختارات من مقالات كتبي في نقد الدين، حيث نكون مع مقالات مختارة من الكتاب الرابع «الدين أمام إشكالات العقل». وتشتمل الحلقة على ثلاث مقالات.
انتهاك الآباء المسبق لحقوق أبنائهم
الآباء والأمهات من المتدينين – بقطع النظر عن أي يدين يدينون ويتدينون به – يمارسون في أغلب الحالات في إطار عملية وقائية استباقية السلب والانتهاك لحقوق أبنائهم وبناتهم، حرصا منهم على أن يكون أبناؤهم مؤمنين بما هم به مؤمنون، وملتزمين بما هم به ملتزمون. وينطلقون في ذلك إما من حرص على أبنائهم، أو من أنانية ذاتية، وإن تمظهرت بمظاهر التدين والورع والتقوى، من حيث يشعرون، أو من حيث لا يشعرون بأنانيتهم تلك. الحرص ينطلق من خوفهم على أبنائهم من الانحراف، ومن ثم من سوء العاقبة، وبالنهاية من أن ينالهم غضب الله في الآخرة، فيكونوا من الأشقياء والبؤساء والمعذبين إلى أبد الآبدين، ومن الطبيعي أن يحرص الأب، وتحرص الأم من موقع الحب لابنهم وابنتهم ألا يكونا من أصحاب الجحيم والعذاب الأبدي طبقا للتصوير القرآني، أو تصوير بقية الكتب (المقدسة) لذلك العذاب. أما الأنانية بوعي أو بغير وعي من ممارسها، فهي إن الأب المتدين والأم المتدينة لا يريدان من أبنائهما أن يكونوا متدينين حرصا عليهم، بل حرصا على وجاهتهما الاجتماعية، وحفظا لماء وجهيهما، إذ لا يليق بالأب أو الأم المتدينَين في الوسط الاجتماعي المتدين ألا يكون ابنهم أو تكون ابنتهم ملتزمين بالصلاة والحجاب وغيرهما. أو تتجلى الأنانية أحيانا أخرى، وهذا لا يختص به المتدين، بل يشمل كل مؤدلج منغلق متعصب، في عدم تحمل صاحب قناعة ما أن يرى من هو على غير قناعته، ولذا فهو لو أوتيت له السلطة السياسية أو الاجتماعية أو الدينية، لقام بقمع الحريات، وأخطر أنواع القمع هو القمع المقدس، أو ما يراه ممارسه مقدسا، أو يدعي قداسته. وعندما لا يملك الإنسان سلطة سوى سلطة الأسرة، كأب أو زوج أو أخ، فسيمارس قمعه وتعسفه تجاه ابنه أو ابنها، أو ابنته أو ابنتها، أو تجاه زوجته أو أخته. وقمع الحريات يكون تارة عبر العرف الاجتماعي، وأخرى عبر الدين. ونحن هنا بصدد تناول قمع الآباء والأمهات لحريات أبنائهم وبناتهم، وانتهاكهم لحقوقهم الأساسية في الاختيار الحر لعقائدهم ولحياتهم. هذه المصادرة للحرية وذلك الانتهاك للحقوق الأساسية يبدأ باختيار الاسم، ويمر بالتربية الدينية، وبفرض الحجاب على البنت، غالبا وهي في ذروة طفولتها، وانتهاءً باختيار الزوج لها في كثير من الأحيان، رغم أن الدين يعتبر الزواج الإجباري باطلا شرعا، ومع هذا يمارس الإجبار بشكل مباشر أو غير مباشر باسم الدين، مع إن اختيار شريك الحياة يعدّ من أخطر وأهم الاختيارات في الحياة.
يبدأ السلب الاستباقي للحقوق الأساسية باختيار اسم الوليد أو الوليدة، فيجري طمغ أو بصم الأطفال من قبل آبائهم وأمهاتهم بطمغة أو بصمة، قد تكون خلاف اختيارهم الحر لاحقا، وخلاف قناعاتهم المستقبلية، الدينية والإيديولوجية والسياسية. فطمغ أو بصم الطفل (الإنسان والمواطن والشخص المستقبلي) دينيا باختيار الاسم الديني له، هو من أشد أنواع التعسف والانتهاك لحقوقه الأساسية، والأسوأ منه اختيار الاسم المذهبي أو الطائفي. ومثله يقال طبعا عن الأسماء الإيديولوجية والسياسية والحزبية، كأسماء الشخصيات التي تعتبر عند مريديها أبطالا قومية أو وطنية، أو رموزا ثورية. فمن غير المعقول أن الأب والأم يمنحان نفسيهما حق جعل ابنهما أو ابنتهما يحملان هويتهما الدينية كمسلمَين، أو مسيحيَّين، أو يهوديَّين، طوال حياتَيهما، أو يحملان هوية شيعية أو سنية.
قلت يبدأ انتهاك الحقوق الأساسية بإجراء استباقي وقائي بالاسم، ويمر بالتربية الدينية، والتي تبدأ غالبا مبكرا جدا بتلقين الأطفال كلمات دينية، كأسماء المقدسين من أنبياء وخلفاء وأئمة وقديسين، ويتدرج بتلقينهم تعاليم الدين من عقائد وشرائع وولاءات. وهنا أستعير قول ريتشارد داوكنز في كتابه (هلوسة الله) (God delusion) [تُرجِم بـ(وهم الله)]، الذي عدّ التربية الدينية للأطفال لونا من ألوان (الإساءة للأطفال)، ومصطلح الإساءة للأطفال (child abuse)، بالألمانية التي قرأت الكتاب بها (Kindermisshandlung) المستخدم في الغرب يشمل الضرب وكل ألوان العنف، كما ويشمل التحرش أو الاعتداء الجنسي، وكذلك تشغيل الأطفال بما لا يتناسب مع طفولتهم، ومنها يعد داوكنز التربية الدينية لونا من ألوان سوء المعاملة أو الإساءة هذه، أو ما يمكن تسميته بـ(الاعتداء على الطفولة). فهو يقول – وبحق – إنه من الخطأ التحدث عن أطفال مسلمين، أو مسيحيين، أو يهود، بل هناك أطفال لأبوين مسلمَين، أو مسيحيَّين أو يهوديَّين. والتربية الدينية بصياغة طفل على مقاسات عقيدة الأبوين، ليكون طفلا يهوديا، أو مسيحيا، كاثوليكيا أو پروتستانتيا أو آرثوذكسيا، أو مسلما، شيعيا أو سنيا أو وهابيا، في الوقت الذي لا يكون عقل الطفل قادرا على التمييز والفحص والاختيار الحر، هو سلب استباقي لحق الطفل في اختيار عقيدته. وقد أصاب الحديث النبوي، لكن بعض الصواب لا كله، فهي كلمة حق أريد منها ما أريد، عندما قال: «إن المرء يولد مسلما بالفطرة، ثم أبواه يُهوّدانِه ويُنصّرانِه»، والصحيح «إن المرء يولد على الفطرة، فارغا من كل عقيدة، ثم أبواه يُهوّدانِه، ويُمسّحانِه، يُكثلكانِه أو يُؤنجلانِه، ويُأسلمانِه، يُسنّنانِه أو يُشيّعانِه، ويُمجّسانِه، ويُصبّئانِه، ويُهِندُسانِه، ويُسيِّكانِه، ويُبوّذانِه، …». ويا ليتهما عوضا عن ذلك سعيا لتنمية عقله على أسس العقلانية، ولتهذيب نفسه بمثل الإنسانية، ثم تركاه يختار عقيدته، عندما يكون عقله قادرا على الاختيار، بمحض حريته وإرادته وقناعته.
جمعية الدفاع عن حقوق اللادينيين والمرتدين والملحدين
حتى كمؤمن ديني، وكطالب حوزة علمية، وكمدرِّس عقائد ودروس دينية أخرى، وكإمام دار للعراقيين يقوم مقام المسجد [دار الهدى]، وكداعية إسلامي، بل وكسياسي إسلامي وعضو فاعل في حزب إسلامي [حزب الدعوة الإسلامية (العراقي)]، ناديت بوجوب الدفاع عن حقوق الكفار والمرتدين والملحدين. وكانت دعوتي أشد، عندما تحولت إلى مؤمن ديني عقلي، وكسياسي إلى ديمقراطي إسلامي، ثم أشد كديمقراطي علماني، ثم أصبحت دعوتي أقوى عندما صرت مؤمنا، إلهيا، عقليا، لادينيا. نعم نحن نحتاج في بلاد العالمَين العربي والإسلامي [الأصح عندي عالم الأكثرية المسلمة وعالم الأكثرية الناطقة بالعربية] إلى جمعية للدفاع عن حقوق وحريات اللادينيين، والملحدين والمرتدين. وركزت على هذه المجموعات الثلاث، من اللادينيين، والملحدين، والمرتدين عن الإسلام، سواء إلى دين آخر، أو إلى اللادينية، أو إلى الإلحاد، دون أن يعني تبرئة عالم الأكثرية المسلمة من تخلصه كليا من القمع الديني للأقليات الدينية في مجتمعاتهم، ولكن قمع المرتد عن الإسلام، وقمع الملحد، وقمع اللاديني، هو في تقديري الأشد. ولذا ترى هؤلاء على مر التاريخ يتخفَّون بحقيقة ما يعتقدون، ويتكتّمون على ما يؤمنون به، ويتستّرون على ما يكفرون به. ولذا فإني أنوي في يوم من الأيام إطلاق مشروع تأسيس هذه الجمعية، عندما أرى الفرصة مواتية، إلا إذا سبقني غيري إليها.
فقهاء الشيعة واستخدامهم القياس والرأي والاستحسان
كمدخل للموضوع لا بد من بيان أمر مهم للقارئ غير المطلع على ما يسمى بمصادر الاستنباط الفقهي عند فقهاء المسلمين. المتفق عليه عندهم جميعا المصدران الأساسيان، ألا هما القرآن والسنة، والسنة أشمل من الحديث، لأن الحديث يمثل قول النبي (أو المعصوم بما هو أعم من النبي عند الشيعة، وما قول النبي أو المعصوم إلا أحد العناصر الثلاثة التي يتشكل منها مفهوم (السنة)، ألا هي (قول، وفعل، وإقرار) المعصوم، أي النبي عند السنة، والنبي وفاطمة والأئمة الاثني عشر عند الشيعة الإمامية. ويأتي بعد القرآن والسنة، أو الكتاب والسنة الإجماع، ولكن يبقى الإجماع مختلَفا على معناه، أهو إجماع المسلمين، أم إجماع أهل السنة والجماعة عند السنة، وإجماع أتباع أهل البيت عند الشيعة، أم هو إجماع فقهاء المسلمين، أو إجماع فقهاء هذا الفريق أو ذاك الفريق عند كل منهما.
المهم إضافة إلى المصادر الثلاثة المذكورة، وبقطع النظر عن الاختلاف في الثالث منها أي (الإجماع)، فإن أبا حنيفة النعمان بن ثابت إمام المذهب الحنفي قد أضاف (القياس) و(الرأي والاستحسان)، بينما أضاف الشيعة (العقل) مصدرا ثالثا. وقد شدد الشيعة على رفضهم لمنهج أبي حنيفة بإضافة القياس والرأي والاستحسان استنادا إلى روايات عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق. وكنت يوم كنت شيعيا أقول دائما أن رفض القياس أمر مخالف للعقل الذي اتخذه الشيعة مصدرا رابعا، فإذا كان الإمام الصادق معصوما ومنصوصا عليه من الله كما يؤمن الشيعة، فلا بد أن يكون القياس الذي شدّد على رفضه هو القياس الناقص، وإلا فإذا ما تحقق القياس التام، سيكون رفضه مخالفا لقواعد المنطق وضرورات العقل، وهذا محال أن يقصده إمام معصوم عن الخطأ. أما إذا كان قد عنى برفضه للقياس أنه يشمل حتى القياس التام، فهذا سيضع عصمته موضع التساؤل والشك. وعندها – وعلى قاعدة أن فرض المحال ليس بمحال عند من يكون المفروض محالا، وهو بالتالي ومن قبيل الأولى عند غيره ليس بمحال – إذا انتفت العصمة، وكان الإمام مجتهدا وليس معصوما، وهو الصحيح، تكون فسحة من حرية الاختيار أن يُؤخَذ منه ما يؤخذ، ويُرَدّ ما يرد. فرفض القياس التام أمر مرفوض عقلا رفضا قاطعا، ومحال رفضه ممن تفترض عصمته.
ولكن كلامنا عن (الرأي والاستحسان)، وهنا قد يكون للشيعة مبرراتهم في عدم القبول بالرأي والاستحسان كمصدر للاستنباط، لأنهما ربما لا يستندان على قاعدة علمية. ولكن إذا ثبت صحة الرؤية الفقهية بأن التشريعات متغيرة بتغير الزمان والمكان، قد يكون للرأي والاستحسان مبررات معقولة، إذا لم يكونا بشكل عشوائي، بل مبنيَّين على أسس مقبولة، بقطع النظر عن طبيعة هذه الأسس.
ولكن لنذهب مع المبنى القائل بثبات التشريعات الدينية، وبالتالي مع القول بعدم إمكان التعويل على الرأي والاستحسان. هنا بالذات نجد أن جُلّ فقهاء الشيعة الإمامية المعاصرين، لاسيما أولئك الذين تصدوا لإصدار ما يسمى خطأ بالفتاوى السياسية، وقعوا في مفارقة منهجية في الاستنباط الفقهي. فهم من جهة يرفضون اعتماد الرأي والاستحسان، كمنهج اعتمده الفقيه أبو حنيفة، ولكن من جهة أخرى، لو تأملنا فيما يسمى بفتاواهم السياسية، نجدها ليست إلا مواقف سياسية (شرعية؟) مبنية بشكل أساسي على آراء واستحسانات للفقيه المُصدِر لتلك الفتاوى، أو المُفتي بتلك الآراء السياسية، المتوهَّم أنها تمثل أحكاما شرعية مُلزِمة، على أقل تقدير للمكلَّف المقلِّد للفقيه المُفتي بها، وقد يُدَعّى أحيانا أنها مُلزِمة لجميع المكلَّفين، إذا تجاوز عنوان الفقيه كونه مرجعا للتقليد إلى عنوان الحاكم الشرعي أو الفقيه الولي أو الولي الفقيه، وتكون إلزامية الفتوى السياسية سارية على أقل تقدير على أتباع مذهب أهل البيت. وإني أكاد أجزم أن أيّاً من عموم الفتاوى السياسية، أو ما يُسمّى بالفتاوى السياسية إذا ما أمعنا به النظر بدقة سنجده لا يمثل إلا رأيا أو استحسانا للفقيه، لا بصفته فقيها مجتهدا، وإنما بصفته شخصا (مواطنا) متدينا ومتشرعا، أو ذا ثقافة شرعية، وإضافة إلى ذلك ذا ذوق شرعي أو رؤية شرعية، وذا ذوق سياسي ورؤية سياسية، حاله حال الناس الذين يتوزعون على أذواق ورؤى ووجهات وتيارات سياسية.
وعلى ذكر الذوق الشرعي، فلطالما قيل في أوساط الشيعة أن لكل فقيه ثمة ذوقا شرعيا تتأثر استنباطاته الفقهية به إلى حد كبير، وما هذا الذوق إلا مصطلح بديل للرأي والاستحسان الحنفي المرفوض شيعيا، أو ما هو إلا مهرب من إشكالية الوقوع في اعتماد الرأي والاستحسان، وكأن المهم مخالفة أبي حنيفة، لأنه قد روي عنه حقيقة أو اختلاقا – لا أدري – أنه تعمد مخالفة أستاذه جعفر بن محمد الصادق، مع إن مخالفة التلميذ لأستاذه في بعض مبانيه مقبول عقلائيا، ولكن استنكار المخالفة هنا هو لعدم تسليم أبي حنيفة لعصمة أستاذه، مع إن عدم التسليم هذا لا يجب أن يكون على أساس المعاندة والمكابرة، بل هي قناعة ذاتية تتكون تلقائيا عند المرء، وليست هي بالفعل الاختياري، كي يدان المرء عليه دنيويا، ويعاتب أو لعله يعاقب أخرويا، هذا طبعا مع فرض تحقق العصمة، مما لا دليل له. وبهذا نرى أن هناك إجحافا بحق الفقيه أبي حنيفة الذي عرف بمواقفه السياسية المشرفة والشجاعة التي دفع ثمنها غاليا، وعرف بفقهه المتسامح نسبيا. ونحن نعلم أن عقلاء الشيعة ومعتدليهم يحترمون ويجلون أبا حنيفة، وأما التطرف في تأييد أي فقيه أو مدرسة فقهية أو معارضته فيمثل في زماننا جمودا يُربك الحياة الاجتماعية والسياسية التي تحتاج إلى ديناميكية المعاصرة عبر استيعاب روح العصر، والتمييز بين الجوهر الثابت والشكل المتحرك.
وأما ما يتعلق بالقياس، وأتكلم هنا بالذات عن القياس المرفوض عقلا، ألا هو القياس الناقص، أي الذي لا يَلُمّ بجميع حيثيات كل من المَقيس والمَقيس عليه. وهذا القياس المرفوض ليس شيعيا فقط، بل عقليا ومنطقيا، فإن معظم المفتين بالفتوى السياسية المستنبَطة من موقفٍ معصوم لنبي أو إمام معصوم، فهي تقيس الحادثة المستبَط لها الفتوى السياسية على الحادثة التاريخية من سيرة المعصوم المستبَط منها تلك الفتوى قياسا ناقصا، لأن التشابه إلى درجة التطابق، والذي هو شرط القياس التام بين الحالتين غالبا ما يكون غير خال من ثغرات مُعتَدّ بها لم يلتفت إليها المجتهد (السياسي) أو المُتسَيِّس. وفي كل الأحوال سبق وأن قدمت الأدلة في مقالات لي بين 2002 و2007 يجدها القارئ في نسماء – باب المرجعية والمؤسسة الدينية، على عدم وجود ما يسمى خطأ بالفتوى السياسية أو الموقف السياسي الشرعي، لأن السياسة تُستمَدّ من التجربة الإنسانية ومن المقايسة بين المصالح والمفاسد، والتي أي هذه المقايسة لا تأتي مقاربة للواقع – ولا أقول مطابقة – إلا إذا صدرت من مختص ذي ثقافة سياسية وهمّ سياسي وممارسة وتجربة سياسيتين، طبعا هذا من حيث شرط الكفاءة، أما من حيث تحقق شرط النزاهة من إخلاص للقضايا العامة، وحرص على الصالح العام، وصدق مع الرأي العام، فهذا ليس مشروطا بمدى تشرّع أو تديّن الإنسان بمعناه الفقهي (الظاهري)، بل بمدى إنسانية ووطنية صاحب الموقف والقرار السياسيين. ثم إن الموقف السياسي غير الصادر من موقع تعتقد شريحة واسعة من الرأي العام بقداسته قابل للتقويم والنقد والمعارضة والتنضيج، بينما فرض القداسة يحول دون ذلك، ولا يخفى على عاقل مدى ضرر الحيلولة دون ذلك.
كتبت في 15/11/2008، وروجعت ونقحت في 27/11/2008
ثم هناك معارك هل الإسلام دين، أم دين ودولة. هل الجهاد فريضة كالصلاة، لا تعطل كما إن الصلاة لا يعطلها شيء، ما عدا الحيض والنفاس بالنسبة لـ(ناقصات الدين) كما يحلو للفقه الذكوري. ثم هي معركة هل حياة غير المسلم محرمة مصونة، أم مباحة مهدورة، كما هي معارك هدر حياة ودماء وأموال وأعراض فريق من المسلمين، أخرجهم مسلمون آخرون من الملة. هي معارك حدود الحرية، والسلب الشرعي للحرية بتفويض مُدَّعىً من الله. هي معارك المساواة واللامساوة، وهل تساوى المرأة بالرجل، أم هي نصف إنسان، بنصف عقل، ونصف حظ (أي نصف حصة) ونصف دين، وهل يساوى غير المسلم بالمسلم، أم هو ربع مواطن، يعطي الجزية صاغرا مهانا.
الدولة العلمانية هي الحل.
دولة علمانية تصون حرية الدين.
دولة علمانية يكون فيها الدين شأنا شخصيا.
دولة علمانية يُحترَم فيها الدين، لكن لا يُقحَم في شؤون الدولة، وشؤون المجتمع.
يُحترَم فيها الدين، كما تُحترَم فيها حرية التغاير مع الدين، حرية الإثبات والنفي، دون نفي أحد من الحياة.
23/01/2013 – 06/02/2013
 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل