فيينا / الأثنين 05 . 05 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
د. نضير الخزرجي
ما الذي يشدُّ المرء للسفر إلى هذا البلد أو ذاك؟
سؤال بالقطع واليقين مر على ذهنك وذهني، فما من مسافر إلا وله هدف أو مجموعة أهداف تجعله يحزم حقيبة السفر نحو مقصده يشبع ما لديه من جوع النظر الحسي إلى معالم البلد المقصود.
يشبع ما لديه من جوع النظر الحسي إلى معالم البلد المقصود.
 يشبع ما لديه من جوع النظر الحسي إلى معالم البلد المقصود.
يشبع ما لديه من جوع النظر الحسي إلى معالم البلد المقصود.على مستوى شخصي، فإنَّ المعالم العلمية والحضارية للبلد المزور تقع على رأس قائمة بنك الأهداف التي منها أتزود بصراً وبصيرة، ففي كل بلد من بلدان الكرة الأرضية إلى جانب مناظر الطبيعة الخلابة آثار ومعالم باقية تحكي جدرانها قصة النهوض المدني والحضاري لسكان بلد المقصد، ولعلّ المراكز العلمية والمعرفية التي وهبت المجتمع علماء في علوم شتى هي التي تتصدر قائمة المعالم الحضارية وعلى مر التاريخ في تنوع الزمانكانات وتعددها بتعدد الشعوب والقبائل، وكل حجر من أحجار الصرح العلمي حاكٍ عن علم وعالم ترك أثراً ورحل جسداً وبقي روحاً وعلما متواصلاً، وهذا البقاء هو الذي يدفع السائح إلى زيارة الصرح العلمي إن كان حياً صامتاً ببقايا أحجاره، أو حياً ناطقاً بعطائه المستمر.
خلال هجراتي القسرية وزياراتي الطوعية لعدد من البلدان العربية والإسلامية والأجنبية، كانت المدارس التاريخية الكبرى هي مقصدي للحديث المباشر مع جدرانها التي ضمّت بين حناياها العلماء، أو التحرك بين الأروقة وحلقات الدرس التي كانت تعقد في هذه الزاوية من الجامعة العلمية أو تلك استاف عطر الماضي، أو مشاهدة الطلبة وهم جلوس كأنهم على رؤوس الطير وآذانهم طوع الحروف العلمية السمفونية التي تطلقها أوتار الأستاذ الصوتية وعيونهم سمّرتها جاذبية لغة جسده وهو يشرح الدرس.
في العام 2010م كنت في رحلة عائلية إلى مصر، وكان جامع الأزهر وجامعتها في أولويات الرحلة إلى القاهرة والإسكندرية، وكنت أظن أنَّ الجامع الجامعة الذي ازدان اسمه بسنا سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، والذي أخمد جذوة علمه صلاح الدين الأيوبي عند قضائه على الدولة الفاطمية في مصر وتدمير مكتبته الكبرى بسنابك خيل جنوده وحرق كتبه ومخطوطاته وتبديلها إلى زريبة، واستخدام اخشاب المكتبة كحطب لحمامات القاهرة، وصناعة أحذية المقاتلين وأحزمة الجياد من جلود الكتب الثمينة، قد أصبح من الآثار الذي يأتي اليه الزائر إمّا أنْ يسكب دمعة على ماضٍ ساطع أطفأت نوره دياجي الأيام وعقول مظلمة أو أن يقف مشدوهاً إلى تاريخ كان له الأثر الكبير في قيام مدنية وحضارة ونهضة علمية وفكرية أنارت ظلام البشرية، لكن حالما دخلت الجامع الفاطمي الازهري حتى سرت البهجة إلى روحي التي أرعبها ما قرأته عن التاريخ الأيوبي في القاهرة المحروسة، فقد وجدت حلقات الدرس قائمة في زوايا وأروقة جامع الأزهر، الذي يضم 21 رواقاً وكل رواق خاص بطائفة أو مذهب أو ملة، فهناك باب أو رواق المغاربة ورواق الصعايدة، ورواق الشَّوام، ورواق الأتراك، ورواق الأكراد ورواق الأفغان ورواق السودان، وقد أخذ مني التجوال في جامع الأزهر فترة طويلة لتوقفي وتسمُّري على مجموعة من الطلبة المغاربة والأفارقة وهم جلوس والأستاذ من أصحاب السمرة الأفريقية الجميلة واقفاً يقدم لهم درساً في الفقه بالعربية الفصحى، وعلى مقربة منهم في رواق آخر جلس الطلبة والطالبات على الأرض وهم يستمعون إلى استاذهم المصري المتربع كرسياً وهو يقدم لهم درساً في اللغة العربية بلهجة مصرية.
لاشك أن المشهد يبعث على السرور، فالجامع الذي أقيم قبل أكثر من ألف عام (359 هــ) ليكون جامعة علمية لكل المذاهب الإسلامية في جو من التآلف والتحالف، ما زال معطاءً رغم ما جرى عليه من تخريب ومحاربة، ولقد تجددت لدي ذاكرة الرحلة القاهرية عام 2010م ضمن سفرة عائلية ومن بعدها عام 2011م ضمن رحلة عمل، وأنا أتابع بالقراءة الموضوعية كتاب “المناصب الدينية عند الإمامية إيجاز عن تفصيل” الصادر في بيروت حديثاً (2025م) في 79 صفحة من القطع المتوسط عن بيت العلم للنابهين للفقيه المحقق آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي، مع تقريظ للشاعر الجزائري الدكتور عبد العزيز شبين.
محورية العلم والمعرفة
تسالمت المجتمعات على أنَّ أساس أي مركز أو مقام أو منصب هو العلم والمعرفة والتجربة، فلا يولد العالم عالماً، ولا الفقيه فقيهاً، ولا الزعيم زعيماً، ولا التاجر تاجراً، ولا الطبيب طبيباً، ولا المهندس مهندساً، والإنسان في دورة الحياة هو واحد من ثلاثة كما يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: (الناس ثلاثة: فعالم ربـّاني، ومتعلـّم على سبيل نجاة، وهمج رعاع: أتباع كلّ ناعق، يميلون مع كلّ ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق)، وتبعاً لهذه التقسيمات يتمايز الناس ويتمايز العلماء ويتمايز المتعلمون، وتتمايز المناصب، حتى في حياتنا اليوم فإن بعض المناصب الوظيفية الرسمية تتبع عدد سنوات الدراسة، فبعض الوظائف تقبل صاحب شهادة متوسطة وأخرى ثانوية وثالثة جامعية، والدراسة الجامعية تتمايز وفقاً لدرجة النجاح في المرحلة الثانوية أو الإعدادية، فصاحب الدرجة المتوسطة أو الدنيا على سبيل المثال لا يستطيع دراسة الطب، وسنوات دراسة الهندسة المعمارية أكثر من سنوات هندسة تقنية المعلومات، وسنوات دراسة القانون أكثر من سنوات دراسة الأدب، وهكذا في كل مناحي الدراسات الجامعية.
ومن نافلة القول أنّ من لعب في صغره وتقاعس عن مواكبة العلوم آخذاً الحياة طولاً وعرضا ضاقت عليه الحياة في كبره وكهولته وأورث أسرته المتاعب والمصاعب، ومن تعب في مقتبل عمره استراح وأراح وأورث أسرته العزة والكرامة، والأمر ينسحب على المجتمع الصغير والأمة الكبيرة، فكلما تعاظم عندها العلم والمعرفة تقلد أبناؤها المراكز العلمية العالية وتمايزت عن بقية الأمم.
في هذا الكتاب تناول المؤلف ومن داخل البيت العلمي الذي نشأ فيه أولاً في مسقط رأسه كربلاء المقدسة حتى تناوله لثريا العلم والمعرفة وهو اليوم على أبواب العقد التاسع من عمره، معالم المناصب الدينية عند الإمامية، والمفردة “المنصب” كما يفيدنا في التعريف: (اسم مفعول من الفعل نصب بمعنى أقام ووضع، وربما استُخدم كإسم مكان والذي بمقتضاه يتطلب إلى ناصب يُنصَّب الشخص في مثل هذا المقام، وبالتالي فالمَنْصِب بكسر الصاد هو المراد في حديثنا هنا، والذي هو المقام الذي يتولاه الشخص، وفي الأصل وضع ليكون مقاماً شريفاً ولكن اليوم يُستخدم في كل وظيفة يتولاها المرء من قبل ناصبه أو أنه يُنصِّب نفسه ويضعها في هذا المقام أو ذاك، فهو بالتالي في اللغة هو المقام الذي من خلاله يتولى المرء شؤون الناس، بغض النظر عن نوعيته وشكله)، فالمنصب وظيفة، ولهذا في تعبيرنا اليوم نقول أن فلاناً تسنمّ منصبه أو وظيفته أي بمرادفة الكلمتين فكلتاهما بالمعنى العام تدلان على المقام، وبتعبير الكرباسي: (المنصب مفردة تستخدم في كل المجالات ويعادلها بشكل أو آخر الوظيفة، وهي مفردة أخرى تعنى ما هو الواجب على المرء من القيام به تجاه الذي وظَّفه بالأمر).
وحيث أن مقام النبوة والإمامية يعود أمرهما الى الناصب الأول وهو الله سبحانه وتعالى فهو مقام تعييني لا تخييري، ودونهما من مقام على علاقة مباشرة بالناس يعود الأمر فيه إلى حجم دائرة العلم والمعرفة كشرط أساس إلى جانب شروط ومؤهلات، أي مقام تخييري تبعاً لخيارات العلم والمعرفة وقرب الإنسان من المقام وانسجامه مع شروطه.
وكما هو دأبه أفرغ المؤلف مباني كتابه وفروعه في تخميسة قال فيها:
لدى الدين حقاً تجلَّت مناصبْ
الا اقرأوا سِفْرَنا إذْ يُريكُمْ
أصولاً لها في المباني يَفيكُمْ
بجمعٍ خذوها فهذا يقيكُمْ
من الشكِّ بل سوف تُبدي المواهبْ
وكان خاتمة الكتاب قصيد تقريظ من نظم الشاعر الجزائري الدكتور عبد العزيز شبين، من بحر المخلَّع البسيط، قال في مطلعها:
أحرَزْتَ كرسيَّ المعالي … عليا المناصبِ بالجلال
أجلَستَ ذاتكَ فوق ثــَ … رِّ الغيمِ يمطرُ بالزلال
ويختمها بقوله:
أستافُ ألفَ خُطًى لظِلِّ المرتضى وصدى بلالِ
كرباسُ إذ تهفو المنا … صبُ نحوهُ في كلِّ حالِ
وظائف وشروط
أجمع المسلمون على الحديث النبوي المتواتر كما في صحيح مسلم: (أما بعد: ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأُجيب، وأنا تارك فيكم الثقلين: اولاهما: كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، وأهل بيتي، أذكِّركم الله في أهل بيتي، أذكِّركم الله في أهل بيتي، أذكِّركم الله في أهل بيتي) وبضميمة قوله تعالى في الآية 55 من سورة المائدة: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ)، فإن المناصب الدينية كما يفرزها المؤلف ثلاثة: (1) النبوة والرسالة الخاتمة، (2) الإمامة والقيادة الدينية والدنيوية، (3) الوكالة أو النيابة الخاصة.
والمنصب الثالث هو الذي يقوم عليه مدار الحديث، وهو منصب لا يتولاه كل فقيه مهما بلغ من العلم شأواً، فلا ولاية لعالم متهتك أو عالم يبرر للسلطان جوره، وهو في مفهوم اليوم يمثل “المرجعية الدينية” التي يعود إليها الناس في الفتيا والتقليد وإدارة أمور البلاد لمبسوط اليد من الفقهاء العاملين، وفق شروط حددها الإمام الحادي عشر من أئمة أهل بيت النبوة الحسن بن علي العسكري عليه السلام: (فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه)، وعبَّر عنهم الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت المهدي المنتظر محمد بن الحسن عليه السلام برواة الحديث بقوله: (وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله عليهم).
وما يمكن فهمه من المناصب في إطار الوكالة أو النيابة الخاصة تسعة وهي: (1) المرجعية الدينية، (2) المُقلَّد -بفتح اللام-، (3) المجتهدـ (4) التمثيل أو ممثل المرجع أو المقلَّد (5) الوكيل للمرجع أو المقلَّد، (6) الولاية (العامة أو الخاصة)، (7) إمامة الصلاة، (8) التدريس، (9) الإعلام.
وبإيجاز مفيد يواصل المؤلف بيان شرائط كل صاحب منصب، فشروط صاحب المرجعية الدينية العليا: الحياة، العقل، الذكورة، العقيدة، العدالة، البلوغ، الطهارة (طهارة المولد)، النزاهة، السلامة (العضوية والنفسية والعقلية)، الأخلاق، الشجاعة، الحرية، الزهد، الصراحة، الإدارة، الاستشارة، الأبوَّة، الحكمة، الإشراف، الاجتهاد، الاستقلالية، الاستطلاع، الصلابة، المعاونون (مستشارون)، الإنسانية، والمسؤولية، وأما صلاحياتها فتتوزع على الأمور التالية: الولاية العامة (دون المطلقة التي هي للمعصوم من نبي وإمام)، القيادة، الحكم.
ومن الطبيعي فإن المرجعية الدينية العليا هذي لا ينحصر نفوذها في مدينة أو بلد بعينه، فحيثما كان المسلمون فثّم نفوذها قائم، ويشير الفقيه الكرباسي في معرض الحديث عن صلاحياتها إلى: (نظرية حضارية وهي تأسيس مجلس الفقهاء سواء على قواعد نظرية التخصص وتعدد المُقلَّد حسب التخصص أو مِن سَنِّ القوانين وإعمال التشريع على شكل التعدد والتداول والوصول الى الأفضل وعدم التفرد بالرأي، وهي أهم وسيلة للصَّوْن والصِّيانة من الانخراط نحو الاستبداد، المرفوض إسلامياً عند الإمامية)، على أن تستند المرجعية الدينية العليا عند التنفيذ إلى (تعاليم السماء ومراعاة مصالح الشعوب والأمة).
أما وظيفة “المُقَلَّد” أي المجتهد الجامع للشرائط الذي ترجع اليه الأمَّة في التقليد وهو دون المرجع الأعلى صاحب النفوذ الواسع، فإنَّ تعدده في البلد الواحد أو البلدان عامل إيجابي وبتعبير الفقيه الكرباسي: (إنَّ تعدد المُقَلَّد -بالفتح- هو نوع من أنواع الحرية التي يدعو إليها الإسلام، وتدخل فيها المذاقية في الاختيار، لأنَّ التعددية هي الأخرى من الأمور الأساسية في النظام الإسلامي وهيكليته).
وفي المرتبة الثالثة من حيث العلمية والنفوذ هو المجتهد ومثله كما يفيدنا الفقيه الكرباسي: (إن كان عاقلاً بالغاً ذكراً كان أو أنثى أو خنثى عليه أن يأخذ برأيه في مسيرته العلمية ولا يحق له أن يقلد غيره، نعم له أن يعمل بالاحتياط لكن من دون إلزام .. ويحق للمجتهدين الآخرين الاستئناس بنظرياته العلمية .. وبما إنَّه لا يحمل شرائط التقليد الأخرى من غياب العدالة مثلاً أو غيرها لا يجوز تقليده).
وفي المرتبة الرابعة تأتي وظيفة الممثل الشرعي للمرجعية العليا أو المُقَلَّد وهو: (لابد أن يتصف بالتالي: العدالة، الخبرة، الوثوق، الاطلاع، الثبات والطمأنينة) وأن تكون له مساحة مقبولة من الصلاحيات، وهو بمثابة الوزير المفوَّض وسفير فوق العادة.
وفي المرتبة الخامسة تأتي وظيفة الوكيل الشرعي للمرجعية العليا أو المُقَلَّد، وهو بمثابة السفير الذي له أن يمارس وظيفته في أي بلد يتم توجيهه إليه وتتفاوت صلاحياته، ويتم تعيينه من قبل المرجعية العليا أو المجتهد المقلَّد، أو من قبل الناس في البلدة أو البلد بعد استحصال قبول المرجعية العليا والمجتهد المُقَلَّد.
وفي المرتبة السادسة يتحدث الفقيه الكرباسي عن الولاية الخاصة في الأمور الحسبية وتولي شؤون القاصرين ومن لا ولي له وغيرها، ضمن الحديث عن ثلاثية الولاية المطلقة والولاية العامة والولاية الخاصة.
وفي المرتبة السابعة إمام الصلاة الذي لا يشترط فيه الاجتهاد والفقاهة ولكن يشترط فيه: (البلوغ الشرعي، العدالة، القراءة الصحيحة، عدم ارتكاب ما هو خلاف المروّة، معرفة أحكام الصلاة والجماعة، عدم العجز من أداء أركان الصلاة، والعقل والرشد).
وفي المرتبة الثامنة تأتي مسألة التدريس والتعليم التي بدأت حلقاتها الأولى من المسجد النبوي الشريف وفي مكة المكرمة حتى تعالت في الحواضر العلمية المختلفة جدران جامعات وحوزات علمية كبرى في الكوفة المعظمة والبصرة وبغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والموصل وطوس وإصفهان ودمشق والقيروان والأزهر والأندلس والاسكندرية وفاس والزيتونة وغيرها.
وأخيراً فإن رتبة الإعلام ومن يدور في فلكها من خطيب ومرشد ومبلغ وصاحب رأي وقلم تعتبر من الوظائف الشريفة إذا أحسن صاحبها نثر بذورها في الأرض الطيبة الصالحة.
وبشكل عام فإن المراتب العلمية والمناصب الدينية عند الإمامية وعموم المسلمين توزعت عناوين أصحابها
على النحو التالي: المرجع، آية الله، المفتي، حجة الإسلام والمسلمين، حجة الإسلام، ثقة الإسلام، العلّامة، القاضي، المبلِّغ أو المرشد.
الرأي الآخر للدراسات- لندن
*باحث وكاتب عراقي
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
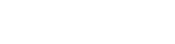 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل


