فيينا / الأربعاء 14 . 05 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
د. نضير الخزرجي*
يمثل اللسان أداة التخاطب والمحاورة، ولكل أمة لسانها الذي به تنطق وتتخاطب، وتأتي الترجمة إلى اللغات الأخرى كمرحلة أخرى من عملية التفاهم بين الأمم.
عملية التفاهم بين الأمم.
 عملية التفاهم بين الأمم.
عملية التفاهم بين الأمم.وعملية التخاطب بوصفها صنعة بشرية أدواتها الكلمات بجذورها واشتقاقاتها هي الأخرى جرى فيها التجديد والتطور والتنوع، فكان من التطور فن الخطابة والإلقاء وفن الكتابة والإنشاء بشقيه النثر والنظم، وفن الإشارة لأصحاب الصم والبكم الذين يحتفلون في الثالث والعشرين من سبتمبر أيلول من كل عام باليوم العالمي للغة الإشارة وهو اليوم الذي يصادف تأسس الإتحاد العالمي للصم سنة 1951م حيث يوجد في العالم أكثر من 70 مليون إنسان فقدوا نعمة السمع والكلام واستبدلوا الحروف الصائتة بالإشارة الناطقة، ومن التطور لغة البرايل لمكفوفي البصر وضعاف النظر، وهي اللغة التي تنسب الى الفرنسي لويس برايل (Louis Braille) (1809- 1852م) القائمة على تجسيد الحروف على ورق خاص بثقوب أو نقاط ناتئة أو مقعرة من ست ثم ثمان يلمسها البصير ويقرأها، وكل تشكيلة نقاط تعبر عن حرف هجائي، وحيث فقد الكفيف نعمة البصر والنظر زاده الله من قوة السمع واللمس، ويحتفل العالم في الرابع من يناير كانون الثاني من كل عام باليوم العالمي للغة البرايل الذي يصادف تاريخ ميلاد مخترعها.
وفي الكثير من المؤتمرات الخطابية الدولية والمحلية أدخلوا لغة الإشارة، فحيث يقف المتحدث خطيباً يقف إلى جانبه متمرساً أو متمرسةً بلغة الإشارة يترجم للحاضرين والمشاهدين عبر شاشات التلفزة، كما دخلت الترجمة والدبلجة عالم صناعة الأفلام والمسلسلات والتمثيليات، وحيث يوجد الملايين فقدوا حاسة السمع والكلام لكنهم قادرون على القراءة فإن الكثير من الأفلام والمسلسلات ونشرات الأخبار والمؤتمرات المبثوثة عبر شاشة التلفاز أوجدوا تحتها مساحة لخط وكتابة المنطوق وبلغة المتكلم، فمن يتكلم الإنكليزية حولوا حروفه غير المسموعة لذوي الصم والبكم إلى حروف مقروءة وهكذا بالنسبة إلى اللغات الأخرى، فيتساوى المشاهد الأصم والسامع في معرفة الخطاب والحوار، فهذا يسمع وذاك يقرأ، وكلاهما يفهم، ومن حسنات هذا التطور المساعدة الملحوظة على تعلم اللغة لغير الناطقين بها، وكانت معلمتنا في معهد اللغة في كلية هارو (Harrow College) تنصحنا بمشاهدة المسلسلات التي تضم كتابة الحوار المنطوق لأنها تساعد على السمع والقراءة معاً.
ولاحظت في السنوات الأخيرة أن بعض الدول الناطقة باللغة العربية التي يغلب على أفلامها ومسلسلاتها استخدام اللهجة المحلية وبخاصة في دول شمال أفريقيا العربية، أنها تضع إلى جانب الحوار المنطوق النص بحروف عربية وبنفس اللهجة أو بتحوير بسيط حتى يفهم المشاهد ما يقوله الممثل، لإدراك صانع المحتوى التلفزيوني أن المشاهد العربي غير قادر على فهم اللهجة المحلية، فيتم عبر كتابة المنطوق تقريب اللهجة إلى الفهم والإدراك.
واليوم وحيث يحتفل الناطقون باللغة العربية في الثامن عشر من شهر كانون الأول ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للغة العربية، وهو اليوم الذي أقرت الجمعية العام للأمم المتحدة عام 1973م اللغة العربية لغة رسمية في كتابات الأمم المتحدة، فإن اللهجات المحليات هي اللغة السائدة، وإذا حاول العربي من بلاد المشرقي العربي أنْ يتكلم مع العربي من بلاد المغرب العربي فإن اللغة العربية الفصحى هي القاسم المشترك للفهم والتخاطب.
وكلما زادت الهوة بين الناطق ولغته الأم نمت اللهجة المحلية وصارت هي البديل، وقد انسحبت آثار هذه الهوة على المنظوم من الكلام، فصار الشعر الشعبي هو الشائع في الكثير من البلدان العربية، على أن انتشار الشعر الشعبي ليس مقتصراً على الناطقين بالعربية فقد غزا الناطقين باللغات الأخرى أيضاً، وهي سمة عامة من سمات التطور في عالم الكتابة والخطابة وعموم عالم الاتصالات، حتى صرنا بحاجة إلى معاجم وقواميس لفهم معاني الكلمات الشعبية والمحلية التي يختلف نطقها بين بلد عربي وآخر بعدما كنا نؤوب إلى لسان العرب وغيره لفهم المفردة العربية الفصحى.
فكرة التحول من الفصحى إلى العامية وطغيان الثانية على اللغة المحكية، طرأت على ذهني وأنا أتابع بالقراءة الأدبية الجزء الثاني من “ديوان الطويل” من دائرة المعارف الحسينية للمحقق والأديب الشيخ محمد صادق الكرباسي الذي صدر سنة 1446هــ عن المركز الحسيني للدراسات بلندن في 365 صفحة من القطع الوزيري، حيث يتابع المؤلف في قسم (الحسين في الشعر العربي الدارج) القصائد الشعبية من بحر الطويل التي نظمت في الإمام الحسين عليه السلام لشعراء من بلدان مختلفة.
مشاعر متدفقة
بحر الطويل أشبه بالإناء الكبير، فذاك يستوعب أكبر عدد من الحروف والتفعيلات وهذا يستوعب حجماً أكبر من السوائل، وهذه التسمية أطلقها مكتشف البحور الخليل بن أحمد الفراهيدي عندما وجد في رحلة البحث عن البحور الشعرية أن صدر البيت وعجزه يتناصفان 48 حرفاً، وما دونها من البحور أقلّ حرفاً، فأطلق عليه الطويل، فكانت تفعيلته على النحو التالي:
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن *** فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
وهذا يُعبر عنه ببحر الطويل التام المثمن أو بحر الطويل الأول، حيث جاءت التفعيلة الأخيرة من صدر البيت وما يُعبر عنه بـ “العَروض” على وزن (مفاعيلن) ومثلها التفعيلة الأخيرة من عجز البيت وما يُعبر عنها بـ “الضرب”، وأما بحر الطويل الثاني فقد جاء عرضه وضربه على وزن “مفاعل”، واما البحر الطويل الثالث فقد جاء عرضه على وزن “مفاعيلن” وضربه على وزن “مفاعلن”.
ولأن الطويل صاحب تفعيلات وتقطيعات وحروف كثيرة فإنه أكثر البحور استيعاباً لمشاعر الشعراء، فهو عندهم من أكثر البحور ركوباً وأكثرها نظماً فقيل له أمير البحور، ومن نماذجه قول الشاعر العماني المعاصر عقيل درويش اللواتي من قصيدة بعنوان (جغرافية أنثى):
جيئين يا وجه الشروق بناظري .. مناراً وقلبي في عيونكِ مَحْجِرا
فتمسين نهر الحبِّ في كلِّ قطرة .. صفائيةَ المعنى حناناً مطهَّرا
أو قول الشاعر العراقي السيد علي عبد الأمير الكاظمي الحيدري (1936- 2018م)، من قصيدة بعنوان (يا جنَّة الأحلام):
أنا لوْ وضعتُ السيفَ بين جوانحي .. لتُقَطَّعَنَّ بحدِّهِ أحشائي
ما ازددتُ إلاّ صبوةً ومحبةً .. حتّى يسيلُ مع الدّماءِ وفائي
فأمْضي لما تبغينَ دونَ تردُّدِ .. لا تَرْهَبَنَّكِ أعينُ الرُّقَباءِ
فالمشاعر أكثر تدفقاً عندم يمخر الشاعر بقوافيه عباب بحر الطويل، ولأن واقعة الطف في كربلاء المقدسة واستشهاد سبط الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين عليه السلام، هي عبارة عن بحور ومحيطات من المشاعر والعبرات، فإن الشعراء خاضوا غمار هذه المياه الدافقة، فكان لشعراء الشعر الشعبي نصيب كبير بخاصة في العقود الأخيرة التي شهدت وفرة كبيرة على حساب الشعر العربي القريض، على أنه برز بين الناظمين في الإمام الحسين عليه السلام شعراء مسكوا بيمناهم راية القريض الفصيح وبيسراهم راية الشعبي الدارج فأبدعوا على الجبهتين وصالوا مع القريض مرة ومع الشعبي مرة أخرى فكانوا أهلاً لكل الصولتين ولعلّ من أبرزهم الشاعر المعاصر جابر الكاظمي.
بنود الطويل وفنونه
ولأنَّ المؤلف ديدنه التحقيق، فإن هذا الجزء من ديوان الطويل والجزء الأول الذي صدر سنة 2023م والجزء الثالث الذي صدر هو الآخر حديثا، رغم الحشد الكثير والكبير من المفردات الشعبية بخاصة لدى الناطقين بها في العراق وجنوب إيران، إلا أن المعنى العربي الفصيح كان ملازماً لكل مفردة شعبية، فهو بحق قاموس شعبي فصيح إلى جانب كونه ديوان شعر.
في العادة يتركب بحر الطويل في الشعر الشعبي من بند أو مجموعة بنود، وكل بند يضم مجموعة أبيات حسب رغبة الشاعر فمرة أربعة أبيات ومرة ستة أبيات ومرة خمسة أبيات ومرة سبعة أبيات، والمشهور منها تسعة أبيات في بند واحد حيث يتحد البيتان الأول والثاني مع البيت التاسع في القافية والأبيات الثالث والرابع والخامس في قافية والسادس والسابع والثامن في قافية أخرى، وكل بند هو في واقعه قصة قصيرة عن حدث معين من حوادث واقعة الطف أو ما يتعلق بنهضة الإمام الحسين عليه السلام، ومجموع البنود تشكل قصة طويلة او رواية تبعاً لكثرة البنود وقلتها، ومن السداسي قول الشاعر العراقي محمد عبد علي الخطيب النجفي المتوفى سنة 1969م:
زَينب گِضَتْ مهضومة … عُگْبِ اليُسر يا كرارْ
تِبْچي شيعتَك واتْنوح … إلمُصايِبها إبْلَيلْ إنْهارْ
زينب شافت إمْصايب … ما شايِف مثلها أحدْ
إوصابَتها مِحَنْ كِثْرَه … ما تِنْحُصَه إومَلْهِنْ حَدْ
أو ما ياجَد صبرها أحَدْ … مُرْسَل يو وَصي يوجدْ
زادتْ عَلَه امْها الزَّهره … إبْكِل إلِّي عَلَيها أجْرَدْ
واسَت عَوْدْها إبْصَبْرَه … توصَف حِلِمْ حامي الجارْ
أي مضت السيدة زينب بنت علي عليها السلام بعد انتهاء معركة الطف في عاشوراء سنة 61هــ ومقتل الحسين عليه السلام وأهل بيته وأنصاره على يد الجيش الأموي، مضت أسيرة نحو الكوفة ومن ثم الشام عند يزيد بن معاوية الأموي، وقد رأت في رحلة الأسر من المصائب الشيء الكثير، وشيعتك يا علي الكرار تبكي لمصابها ليلاً ونهاراً، وقد كانت جبلاً من الصبر والصمود فاقت صبر الكثير من الأنبياء والرسل ولا يوجد في صبرها أحد، وكانت في مصابها على فقد شقيقها ومقتله كما يقول الشاعر أكثر من مصاب أمها فاطمة الزهراء عليها السلام على فقد والدها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلّم ورحيله إلى العلي الأعلى، وهي في صبرها وحلمها كصبر وحلم أبيها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
والشاعر في قصيدته الشعبية يستحضر قصيدة الشاعر العراقي السيد صالح الحسيني الحلي (1872- 1940م) في رثاء السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، ومطلعها:
يا مُدرِكَ الثّارِ البدارَ البِدار *** شُنَّ على حربِ عِداكَ المَغار
إلى أن يقول متحدثاً عما ألمَّ بالسيدة زينب الكبرى الهاشمية:
قـد ورثَـتْ زيـنبُ مِـن أمِـّها *** كُـلَّ الـذي جَـرى عليها وصار
وزادتْ الـبـنتُ عـلـى أمِّـها *** مـن دارِهـا تُـهدى إلى شرِ دار
تسترُ باليمنى وجوهاً فإنْ *** أعوزها السترُ تمـــــــــــدُّ اليسار
لا تبزغي يا شمسُ كي لا تُرى *** زينبٌ حسرى ما عليها خمـــــار
وكما تفنن الشعراء في عدد أبيات البند الواحد، تفننوا في أشطر الأبيات، فالشاعر العراقي سلمان محمد الشكرجي البغدادي العبدلي المتوفى سنة 1950م، أورد صدر البيت الأول (يا سلّاب تاج إحسينْ) في مطلع كل بند من قصيدته السينية المفتوحة “يا سلّاب تاج احسين” المتكونة من أحد عشرَ بيتاً، وهذا الشاعر العراقي الشيخ عبد الأمير نجم النصراوي المتوفى سنة 2018م في قصيدته العينية المكسورة “هيَّجِتْ رَوْعي” من خمسة بنود أتى بعجز نهاية كل بند في صدر البند الجديد ونظم عليه بقية الأشطر في تناسق جميل، وهكذا تتنوع بنود بحر الطويل.
الأديب الكرباسي اعتمد في تنظيم سلسلة القصائد وفق الحروف الهجائية، وحيث ضم الجزء الأول 48 قصيدة أو مقطوعة حسب قوافي الحروف: (الألف، الباء، التاء، الثاء، الجيم، الحاء، الخاء، الدال، الذال)، فإن الجزء الثاني ضم 41 قصيدة أو مقطوعة (49- 89) للقوافي: (الراء، الزاي، السين، الشين، الصاد، الضاد، الطاء، الظاء، العين، العين، الفاء، القاف، والكاف) للشعراء: باقر محمد الهندي، جابر جليل الكاظمي، سلمان محمد الشكرجي العبدلي، عبد الأمير نجم النصراوي، عبد علي (محمد علي) ناصر الناصري الصفار، عبد المحمد عبد علي الخطيب النجفي، علي الصائغ، علي كريم الموسوي، وهادي عبد القصاب ولكل واحد منهم قصيدة واحدة. وعلي عبد الله الشهابي قصيدتان. وعبد الأمير علي الفتلاوي ومهدي حسن الخضري الجناحي ثلاث قصائد لكل منهما. وعبد الصاحب ناصر الموسوي الريحاني أربعة قصائد، وعبد الحسين علي الشرع وكرار عبد الحسن الحسينات الكربلائي خمسة قصائد لكل منهما، وعشر قصائد من نصيب الشاعر مهدي هلال الكربلائي.
وكما في كل أجزاء دائرة المعارف الحسينية، فإن المحقق الكرباسي أنهى هذا الجزء الذي يمثل المجلد رقم (125) من المطبوع من الموسوعة الحسينية بمقدمة معرفية باللغة الروسية للدكتور ناظم علي زينال أف المقيم في موسكو، تناول فيها بشيء من التفصيل المعرفي الجميل الظروف السياسية التي كانت عليها المدينة المنورة وعموم العالم الإسلامي بعد رحيل النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، وانتهاء مرحلة الخلافة الإسلامية بمعاهدة الصلح التي عقدها مرغماً خامس الخلفاء الإمام الحسن بن علي عليهما السلام مع زعيم الدولة الأموية معاوية سنة 41هــ الذي حول الدولة الإسلامية إلى ملك عضوض يتقاسم خيراتها بنو أمية والمستفيدون من العهد الجديد حتى يصل الى مرحلة الإمام الحسين عليه السلام الذي نهض في المدينة المنورة متوجهاً إلى الكوفة حتى يعيد الأمور إلى نصابها إلا أن الجيش الأموي عاجله في كربلاء وفيها كانت شهادته مع المئات من أهل بيته وأنصاره، وطافوا برأسه الشريف ورؤوس أصحابه في البلدان رغم أن القوم يعلمون علم اليقين أنهم قتلوا سيد شباب أهل الجنة والإمام بلا منازع وسبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم الذي قال فيه: (حسيني منِّي وأنا من حسين. أحبَّ اللهُ من أحبَّ حسيناً، الحسين سبطُ من الأسباط).
وفي تقدير أستاذ العلوم الإسلامية وأول مترجم للقرآن الكريم إلى اللغة الروسية الدكتور زينال أف عند قراءته لديوان الطويل أن: (دائرة المعارف الحسينية تمثل إرثاً علمياً وثقافياً فهي تعكس احترامًا عميقًا وتقديرًا للإمام، كما أنها تشكل مصدرًا قيمًا للباحثين والعلماء وأولئك الذين يسعون لفهم الدور التاريخي والروحي للإمام الحسين وأصحابه، وهو جزء من إرث لا نهائي له أهمية بالغة، وهو مصدر إلهام ليس فقط للمسلمين، بل لكل من يبحث عن الحق والعدالة).
الرأي الآخر للدراسات- لندن
*كاتب وباحث عراقي
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
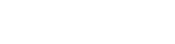 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل




