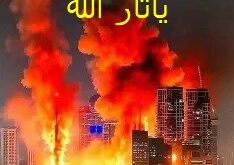السيمر / الخميس 15 . 06 . 2017
ضياء الشكرجي
هذه هي الحلقة الثالثة بعد المئة من مختارات من مقالات كتبي في نقد الدين، حيث نكون مع مقالات مختارة من الكتاب الرابع «الدين أمام إشكالات العقل». وهذه الأولى من ثلاث حلقات حول الحكمة والجدوى من العبادات والشعائر الدينية وبعض الواجبات والمحرمات في الإسلام.
الفرائض والعبادات والطقوس والشعائر في الإسلام
الإسلام مكتظّ بالأحكام الشرعية وبالعبادات، مما سنّه المؤسس، علاوة على ما أضيف من طقوس وشعائر من قبل فرق المسلمين، أو ما يمكن تسميته بالتدين الشعبي. بالنسبة للأحكام الشرعية، فقد قيل أن ليس هناك من حادثة إلا وللإسلام حكم فيها، إذ يقف المُكلَّف، أي المسلم المؤمن بالإسلام، الملتزم بأحكامه، أمام أي أمر، يمكن فيه فعل شيء أو تركه، ليرى فيه ما يحكم الله – حسب عقيدة المسلمين – ما إذا كان عليه سلوك واجب، لا يُرخَّص له تركه، أو ترك مُحرَّم، لا يُرخَّص له الإتيان به، أو ما يخير بين الفعل والترك فيما هو مُباح، فهو ليس مُحرَّما عليه، وبالتالي له الإتيان به، وليس واجبا عليه، وبالتالي له تركه، ثم يُقسَّم هذا المباح أو الحلال إلى راجح شرعا، أي ما ينبغي له الإتيان به، مع رخصة الترك، وهذا ما يُسمّى بالمستحَّب، أو المندوب، وإذا كان مستحبا من العبادات أو من أجزاء واحدة منها، يُسمّى بالنافلة أو السنة، وإلى مرجوح شرعا، أي ما ينبغي له تركه، مع رخصة الإتيان به، وهو المكروه، فإن أتى بالمستحب أو ترك المكروه، استحق ثوابا، وإذا خالف التكليف الترخيصي هذا من مستحب ومكروه، فترك الأول أو أتى بالثاني، فلا عقاب عليه، بل فوّت على نفسه الثواب الإضافي. والتدين الشعبي المتزمت كثيرا ما يحول المستحب إلى واجب، والمكروه إلى محرم، فيشدّد فوق تشديد الدين. ومن المفهوم جدا، بل مما هو ممدوح، أن يلتزم الإنسان بكل ذلك، لاعتقاده أنه يمثل حكم الله، فإذا كان المطلوب من الإنسان الالتزام بالقانون، بل احترام العرف الاجتماعي، أو العمل بنصيحة المستشار الناصح، أو تلبية رغبة من يحب، فمن باب الأولوية أن يلتزم بالأحكام التي فرضها الله عليه من تكاليف إلزامية وجوبا أو تحريما، بل أن يلتزم بما يحبه الله له من تكاليف ترخيصية استحبابا أو كراهية. ولكن الاعتراض إذا ما كان هناك اعتراض، هو عندما يُرهق الإنسان نفسه في الالتزام بما لم يلزمه الله به، كالعبادة المرهقة أو الهادرة للوقت الثمين، أو العبادات التي فيها هدر للمال كالحج أو الخمس أو الزيارات، أو ما يعرض صحة الإنسان أو لعله حياته للخطر، أو يسبب له الحرج الكبير، كالحجاب للمرأة، لاسيما للصغيرة، أو الامتناع عن المصافحة للجنس الآخر، والصوم، لاسيما للصغار. مع هذا أقول طالما كانت الأحكام ذات بعد شخصي فردي، لا تمس إلا ذلك المؤمن الملتزم بشخصه، فلا مشكلة في ذلك، بل بالعكس تكون المشكلة في منعه من مزاولتها، لمساس ذلك بمبدأ الحريات الشخصية، ولو إن أكثر المتشددين في تدينهم لا يحترمون الحريات الشخصية لغير المتدينين، إلا القلة من عقلائهم، لكن الخطأ لا يُقابَل بالخطأ. إنما تكون المشكلة عندما يتعرض التدين للحياة العامة، ويمس حريات الآخرين الشخصية، أو يؤثر على الأمن، أو الاقتصاد، أو النظام العام. ومن أمثال ما يمس الحياة العامة، أو حياة الأفراد، الجهر المبالغ به في تلاوة القرآن، خاصة بما فيه مساس لعقائد ومشاعر الآخرين، والأذان، والدعاء، ومجالس العزاء، وصلاة الجماعة، وخطبة الجمعة، وصلاة التراويح. وكذلك التدخل في حياة الآخرين وسلوكهم الشخصي، عبر ما يسمى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعطيل الحياة العامة والخدمات والاقتصاد عبر المبالغة بالمناسبات الدينية والمسيرات، لاسيما تلك التي تعرف بالزيارات، مثل ما يحصل في العراق منذ 2003. وكذلك امتداد صفوف المصلين في صلاة الجماعة إلى الشوارع، بينما يفترض إن مكانها المسجد حصرا، فإذا ضاقت المساجد بحشود المصلين، فلتُوسَّع، أو لتُبنَ مساجد جديدة، مع ما في ذلك من هدر للمال، ولكن لا يمكن استخدام الأرصفة والشوارع امتدادا للمسجد. وكذلك تكون مشكلة عندما تتأثر الحياة الاقتصادية ونشاط المجتمع بشكل يضر ضررا كبيرا بالاقتصاد عبر الصيام، وطول مواسم الزيارة والعزاء عند الشيعة مثلا. ولا ننسى هنا إكراه الأمهات والآباء لبناتهم الصغيرات وأبنائهم الصغار على التزامات لا تتناسب مع الطفولة.
هنا نريد أن نتناول العبادات وأحكاما شرعية أخرى، ونناقش مدى جدواها وفائدتها، ومدى ضررها، إن وجد ثمة ضرر، خاصا أو عاما.
فريضة الصلاة
بكل تأكيد إن للصلاة أثرا روحيا جميلا على الإنسان المصلي، إذا ما أداها كما ينبغي لها، وهو ما ندر لدى المصلين. قبل كل شيء إن الصلاة في الإسلام مبالَغ في عددها، وعدد ركعاتها. فخمسة صلوات واجبة في اليوم، لها أوقاتها الموقتة، والتي لا يجوز فيها تقديم على ما قبل أول وقت كل منها، أو تأخير عما بعد آخر وقت كل منها، وسبعة عشر ركعة، تُعَدّ مبالَغا في كثرتها وطولها، هذا علاوة على ما إذا أضفنا إليها الصلوات المستحبة، أو ما يسمى بالنوافل، أو صلاة السنة، التي إذا ما التزم بها المتدين بلغت عدد ركعات صلاته اليومية، ليلا ونهارا، اثنتين وخمسين ركعة. هذا علاوة على الوقت المهدور، إذا ما حرص بعض المتدينين على أداء الصلاة الواجبة (الفرائض اليومية) في المسجد. لكن حتى لو كان المتدين متدينا تدينا مخففا، واقتصر على الواجب من الصلاة، فخمس صلوات، بسبع عشرة ركعة من الكثرة مما يجعل الغالبية العظمى من المصلين يصلون صلاتهم بطريقة سريعة، ومستعجلة، من غير أن يتدبروا مضامين ما يتلفظون به، ولا فلسفة ما يقومون به من حركات، من قيام وركوع وسجود. شخصيا صليت ثلاثين سنة من عمري، أقصد الثلاثين سنة من تديني الواعي، دون احتساب الثماني سنوات الأولى من الصلاة التي صليتها برغبة ذاتية في طفولتي وصباي ومطلع شبابي، ولكن بفهم سطحي، إذ تركتها لخمسة عشر عاما عندما كنت ملحدا، فعدت بعد خمسة عشر عاما بكل عنفوان الإيمان وتألق الروحانية، فكنت أصلي صلاتي بتدبر ومتعة وخشوع وذوبان في الله وتحليق مع الله، وتوقف عند كل لفظ، وكل فعل واستحضار إيحاءاته. لكني لم أجد من المصلين الذين التقيتهم إلا الندرة النادرة جدا جدا جدا، ممن لا يصلي إلا بما يمكن نعته بصلاة إسقاط الواجب، مستعجلا الانتهاء منها، إلا مَن تورّط بأداء صلاته جماعة، وكان الإمام ممن يُطيل فيُملّل ويُضجّر مأموميه.
في أول تحولي من (المذهب الظني) الذي اعتمدته لستة أشهر، بعد عشر سنوات من اعتمادي لـ(تأصيل مرجعية العقل)، وفي أول تحولي إلى (لاهوت التنزيه)، صليت لسنة أو أكثر ثلاث صلوات بما مجموعه تسع ركعات في اليوم، ركعتين في بداية الصباح، أربع ركعات في وسط النهار، ثلاث ركعات في المساء، ليس لها اسم خاص، ولا وقت محدد، ولا قضاء ما فات منها. عندها وجدت هذا العدد من الصلوات اليومية الطوعية غير الواجبة، أكثر ملاءمة بكثير مما فرضه الإسلام على أتباعه. صحيح إني أصلي الآن بصلاة واحدة من ركعة واحدة، بركوع واحد وسجدة واحدة، بعد نهوضي من النوم، أقرأ فيها تنزيهيتي، لكن لو افترضت أن الله قد فرض عليّ ثلاث صلوات، مع مرونة في الاقتصار على واحدة، دون وجوب قضاء ما فات في الظروف التي تمنع من أداء واحدة من هذه الصلوات، لكان الأمر معقولا ومناسبا أكثر بكثير، ولكان أكثر المصلين ربما سيستمتعون بصلاتهم أكثر من أدائهم لهذا الكم المبالَغ به والمرهِق والمربِك لوقت الإنسان، هذا الوقت الذي أصبح رأسماله الأول في الحياة.
ثم إننا لو تأملنا في الواقع، واقع المصلين، وواقع غير المصلين، لما وجدنا أن كل المصلين هم أكثر استقامة، وأكثر إنسانية، وأكثر صدقا وعدلا ومروءة، وأسمى أخلاقا، من كل غير المصلين، ففي أوساط المصلين، أو لنقل المتدينين عموما نجد الطيبين والسيئين، كما نجد في غيرهم من هؤلاء وهؤلاء. هذا يدل على أن الدين والتدين والصلاة لم يؤدوا دورهم، ولم ينجحوا في صياغة الإنسان الإنسان، بل بالعكس نرى غالبا أن السيئين من المتدينين يُضفون على سيئاتهم قداسة، بإيجاد غطاء شرعي لها، فيخدشون بذلك جمال صورة الله، لكونهم يجعلون سيئاتهم منسوبة إليه ومشرعة منه، تعالى علوا كبيرا، وتسامى سموا عظيما عن ذلك. فأكثر المصلين لم تُنهِه صلاته عن الفحشاء والمنكر، والظلم، وسوء الخلق، والإساءة إلى الآخرين، وخيانة الأمانة، والكذب، والتزوير، والاعتداء، على حقوق الناس، والحق العام، فنرى في دولة تتنفذ فيها الأحزاب الدينية، أن أكثر وأسوأ سراق المال العام والمفسدين والمُثرين ثراءً فاحشا غير شرعي هم المتدينون. فأين هذا من الآية القرآنية «إِنَّ الصَّلاةَ تَنهى عَنِ الفَحشاءِ وَالمُنكَرِ» أو من الحديث النبوي «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لم تزده عن الله إلا بعدا» أو من كلام الإمام السابع للشيعة جعفر بن محمد الملقب بالصادق «لا تغتروا بصلاتهم وصيامهم، بل اختبروهم في صدق الحديث وأداء الأمانة» أو من الحديث النبوي «عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة، قيام ليلها وصيام نهارها»، أو من الآية القرآنية «قَد أَفلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسمَ رَبِّهِ فَصَلّى» ليكون التزكّي والتطهُّر والتنظُّف الروحي والمعنوي والأخلاقي مقدمة وشرطا وأثرا للصلاة؟ فهل الصلاة مجرد التزام بالنص القرآني «إِنَّ الصَّلاةَ كانَت على المُؤمِنينَ كِتابًا مَّوقوتًا»، أي إنها مجرد فريضة واجبة محددة التوقيتات، أو هل الخشوع الوارد في الآية «قَد أَفلَحَ المُؤمِنونَ الَّذينَ هُم في صَلاتِهِم خاشِعونَ» يعني أن يخشع المصلي بين يدي ربه عند أدائه لصلاته، هذا إذا استطاع أن يستحضر الخشوع، وهو أمر نادر جدا جدا، ولا يخشع لإنسانية الإنسان الآخر وحقوقه وحريته وكرامته؟
أرجع وأقول إن الصلاة الواجبة مبالغ في عددها وفي عدد ركعاتها، وغريب ما روته الصحاح مما حصل للنبي أثناء عروجه للسماء، وقصة تكرار عروجه وهبوطه، ثم عروجه وهبوطه، وعروجه، بين السماء الدنيا والسماء السابعة، حيث كان قاب قوسين أو أدنى من العرش، في عملية مساومة بينه وبين الله على عدد الصلوات المفروضة على المسلمين، والتي – حسب قصة المعراج – لم يدرك الله خالق الإنسان والعارف بأحواله الحكيم العليم أَلّا طاقة للمسلمين بما فرض عليهم من صلوات، بلغت الخمسين صلاة، كما لم يدركها نبيه العارف بقومه، بل الذي أدرك ذلك، هو موسى الذي كان أعرف بطاقة المسلمين من نبيهم، وأعلم من خالق الإنسان بطاقته ومدى تحمله، حتى جرى التخفيض بعد التخفيض في ثلاث مساومات أو أكثر، فجعلها الله خمسا، والتي استكثرها موسى، وبحق، إلا أن محمدا استحيى أن يصعد مرة أخرى، فنزل إلى قومه الذين اتبعوه وآمنوا به ليبلغهم بوجوب الصلوات الخمس، ووضع لها عددا من الركعات، تصاعد، من فترة بداية الصلاة ما قبل المعراج، من ركعتين، فست ركعات، فعشر، فإحدى عشرة ركعة، حتى بلغ السبع عشرة ركعة.
وأكثر المصلين يدركون صحة ما طرحت هنا في قرارة أنفسهم، لكنهم لا يجرأون بالسماح لما استقر في قرارة أنفسهم أن يطفو إلى سطح وعيهم، ناهيك عن الإفصاح بما يجول في دواخلهم؟
وإلى مواصلة الموضوع في الحلقتين القادمتين.
 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل