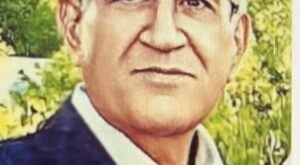السيمر / فيينا / الاربعاء 14 . 08 . 2019
كفاح الزهاوي
كنا أطفالا صغارا ننام على السطوح المنبسطة لبيوتنا في الصيف ليلا، ونرى النجوم المتناثرة فوقنا في السماء ، تتلألأ ببريقها، مع ضوء القمر. ما ان ارتفعت الشمس في السماء صباحا حتى تفيض وتنشر بحرارتها على سطوح المنازل، فتغرق الوجوه والأجساد. فتدب فيها الحياة، واستيقظ في وهج وردي. اذهب الى المدرسة، وانظم وقت فراغي في ممارسة حياتي اليومية. كنت أقضي أوقاتا ممتعة في ممارسة هواياتي، وخاصة تلك اللعبة الشعبية المفضلة لدي، لعبة كرة القدم، في ساحة صغيرة، وهي عبارة عن قطعة أرض متروكة في محلتنا ذات الأزقة الضيقة. كان لي صديق في نفس العمر، اسمه علاوي مشاكس وله عادة سيئة . كلما مررنا بالقرب من عمود الكهرباء الوحيد في محلتنا، كان يرمي المصباح بحجر ليظهر مواهبه، في قدرته على اصابة الهدف كاي طفل. كنت اغضب من تصرفه. قضيت طفولتي في هذه المدينة. كنت أشعر بمتعة غير طبيعية في متابعة الأحداث وما يحصل في محيط مدينتا، والشخصيات المعروفة، كنت اشعر بنشوة عذبة، كلما تدفعني ساقايّ باتجاه السوق. هذا السوق الذي يقع في وسط المدينة الجميلة، اعتبرها من اجمل المدن لأنها تشكل جزء كبيرا من تاريخي، فهي مسقط رأسي، اتنفس رائحتها الندية، القادمة من بساتينها المزدهرة، وطبيعتها الخضراء، ونهرها المتعانق عباب السماء، تحت الشمس الوهاجة. الألوان الزاهية بتنوعها البشري، تكسو أجواء وسماء المدينة رونقا متميزا، ومنبعا لتدفق الأفكار المتنورة. وفي المدينة تنتشر سلسلة من التلال بعضها تحمل الوانا تميل الى الاحمر، تتميز بجمالها الصارخ، وفي الأفق ترى الجبال الشامخة وخاصة عند الشفق، حيث قرص الشمس تتوارى وراءها رويدا رويدا، وتنشر شريطها الأحمر على قممها الشماء.
في الصباح الباكر من يوم الجمعة، قبل طلوع الشمس، بينما أشقائي وشقيقاتي يغوصون في نوم عميق، وشخير أبي وصل إلى عنان السماء، مع كل اطلاقة زفير، يهتز الجدار،وحجر البيت على وشك السقوط. أيقظتني أمي من النوم، ووضعت النقود في يدي، وناولتني الوعاء ذو القعر العميق، الذي أصابه الشحوب من كثرة الجلف، وتقول:
– اذهب الى حجي مراد واشتري هريسة.
بعد ان قضيت حاجتي، خرجت من الحمام، لبست حذائي، تاركا البيت مسرعا، حال ما ظهرت في فناء المحلة. داهمتني العتمة. بدا السكون واضحا على اجواء المحلة، ماعدا الايقاعات الموجية الصادرة من شخير أبي . كان المصباح الوحيد في محلتنا لا يعمل، بالأمس كان شاحبا، واليوم وجدته مكسورا. وقفت للحظة وبعدها امتصت عينايّ قليلا من الضوء المنبعث من النجوم التي لازالت تتلألأ في السماء. وأصبحت الرؤية أكثر وضوحا.. مشيت قليلا، وانا امر في ازقتنا ذات الدروب الضيقة، وصلت الى نهاية المحلة وخرجت الى الشارع. حيث أضواء الأعمدة هناك لازالت مصابيحها تشع انوارا. شاهدت بعض المارة وهم يحملون صحونهم، قطعت الطريق باتجاه الجهة الشرقية، قاصدا المحل، وقع بصري على طابور من الناس، باختلاف أجناسهم، وأعمارهم، ينتظرون دورهم من أجل الحصول على لذة الهريسة، كنت اتنفس منها رائحة طيبة ترطب الذوق وتشمها عن بعد.
شعرت قليلا برعشة برد، تسللت خلسة الى صدري. هبت ريح خفيفة، مست جبهتي، جعلتني اتنعم قليلا بنسيم الصباح الباكر .. وصلت الى موقع المحل، وقفت في الدور كبقية الناس. وبينما كنت واقفا خلف امرأة، تغلفها عباءة سوداء، اشرأبت بعنقي من خلفها لألقي نظرة من باب الفضول، على حجي مراد وقدراته الفنية ونشاطه اللامتناهي من الصباح الباكر، كنت اعتقد، انه ينام في المحل. لم أر وجه المرأة امامي، فهي ربما كانت منشغلة باولادها، ينتظرون قدومها، ولم تلتفت هي حتى جاء دوري وتَرَكَتْ المكان.
ناولت حجي مراد الوعاء، والنقود، وانتظرت قليلا، بينما كنت انظر اليه، تدفق، الى ذهني سؤال، طرحته على نفسي.. لماذا يسمونه حجي؟. فهو لم يزر الحج ولم يخرج من المدينة يوما. كنت اتسأل، ربما كلمة الحاج يرفع من منزلته، ويزيد من احترام الناس له.
قلت في نفسي :
– منافق، دجال.. أردت ان أسأله ، هل صحيح هو حجي؟، ولكن لم اتجرأ. لا ادري هل هو جبن مني أم لم اكن متأكدا من انه فعلا ليس حجي .
كان حجي مراد رجل في الخمسينات من عمره، هاديء الطبع، متوسط القامة، سريع الحركة، يستقبل الناس بابتسامة لطيفة، حتى لو لم يسمع، ما صدر عنهم، من كلام موجه له، فهو بشوش دائما.. محله يقع في الجهة الشرقية من مركز المدينة، له قدرة وذوق رفيع في صناعة الهريسة
وأنا في غمرة التفكير، فجأة ناولني الوعاء كان ممتلئا بوجبة هريسة شهية. والدراجين، غطت سطحها، كندفات قطن، تسقط على بركة ماء، و تصاعد من الوعاء، البخار، وعبق المحل، برائحة الهريسة . قمت بوضع الغطاء على الوعاء، وعدت أدراجي الى البيت. وهناك كانت امي قد اعدت لنا المائدة وجلبت خبزا حارا، طريا من فرن كاظم الخباز، وخاصة في الصباح، كانت رائحة الخبز تفوح، من التنور، الكبير، فتملأ المكان بنكهة الفطور. وجلسنا نحن الصغار، والكبار، حول الصحن، ونهيم بتناول الهريسة، بغمس الخبز فيها والتمتع بلذتها.
كانت أمي امرأة عظيمة جدا، بمثابة الشمس في النهار باشراقتها الوهاجة، والقمر في الليل بجمال هالته، ونوره الساطع، تضحي بروحها وصحتها من أجلنا. بل تكرس كل طاقاتها من اجل ان نكون بشرا لهم قيمة لأنفسهم وللآخرين، تحزن لحزننا وتفرح لفرحنا. بالرغم انها امرأة أمية، ولكن واعية ذهنيا. متنورة، كانت مدرسة خالدة حية، كنت أصارحها بكل شيء، متسامحة، لا تحمل أية ضغينة تجاه الآخرين، امرأة جميلة جدا، كنا نمزح معها ونقول كيف قبلت بالزواج من أبي. تجيب قسمة ونصيب. سألت أمي مرة بنوع من الاستغراب وبرنة بريئة:
– ماما : لا اعرف لماذا اشك ان كاظم الخباز ابن سيد محسن؟
قالت :
– لماذا تسأل؟
قلت :
– لا أرى أوجه التشابه بينهما.
قالت :
– ولكن كاظم هو ابن سيد محسن. ولا تشغل نفسك بالآخرين . ثم ما الذي يزعجك منه.
قلت مع اطلاقة ضحكة :
– اكره لحيته.
كاظم الخباز، مارس هذه المهنة منذ نعومة اظافره، بعد ان ورثهُ عن والده، المرحوم سيد محسن، كان رجلا متدينا، نزيه في تعامله مع الناس ، محبوب وسط أعيان المدينة. بالرغم انه كان سيد. إلا انه كان رجلا متنورا في أفكاره. كل الأمور في الدين يربطها بحياتنا اليومية. وما تتمخض عنها من متقلبات. بينما كاظم، بعكس والده. كانت له لحية مبتذلة، سمات وجهه تعبر عن الشؤم، عبوسا، وكأن غيمة سوداء، حجبت وجهه، ضئيل الحجم نحيفا، وتحت عينه الأيسر شامة كبيرة نبتت فيها شعرة، بينما شعر رأسه خفيف جدا، كان بامكاني حساب عدد خصلاته، لفحت الشمس بشرته، فبدت كالخبز المحروق، لم يكن لطيفا في استقباله للناس، كان يشيح عنهم النظر، وكأنه يتحاشى من فضيحة. لم اكن اتحمل رؤية وجهه، خاصة عندما كانت امي ترسلني لشراء الخبز منه.
اعتلى الشمس في الصباح، وتوهجت سمتها، رغم تناثر السحب، هنا، وهناك، إلا ان صفحة السماء بدت زرقاء زاهية. وتضوعت الأرض، برائحة ندية، بعد ان أمطرت السماء بغزارة يوم أمس، و توقف المطر عن الهطول قبل طلوع الفجر. كانت الحركة في وقت الظهيرة، شبه راكدة في السوق. المساطر، و العربات، قابعة في اماكنها كالعادة. الغيوم المتفرقة في السماء، تخبيء الشمس، خلفها بين حين وآخر فتتسلل قشعريرة خفيفة الى اجساد المارة، بينما الباعة، لم تظهر عليهم اية علامات بارزة، فهم تعودوا بحكم وقوفهم في السوق على طول فصول السنة حتى بات الأمر سيان.
وفي أروقة السوق ترى البشر على اختلاف أنواعهم وأجناسهم، من النساء، والرجال، تطأ أقدامهم أرض السوق، وتترك آثارها، واحيانا احاول الابتعاد عن بعضهم، بسبب الثوم التي رائحتها تفوح من انفاسهم وهم يطلقون الزفير اثناء الكلام، والبعض الآخر، نتيجة الإفرازات العرقية التي تتصبب من بشرتهم. فيرتفع منسوب الرائحة، الذي يزكم الأنوف، حيث يأكلون حباته ، كما الحلويات، لان لها فوائد صحية، تحافظ على صحة أبدانهم، كما يقولون. كنت صغيرا لا أطيق رائحته. في احدى الأيام قالت لي امي بسبب تذمري من رائحة الثوم.
– ماذا تفعل لو تزوجت فتاة تأكل الثوم :
أجبتها بفيض من المرح
– سوف اطلقها.
وفي السوق، ترى الباعة في تناغم مع المشترين، في محاولاتهم لإقناع زبائنهم، بنوعية بضائعهم. كنت شغوفا، فضوليا في متابعة الناس بنظراتي، كانت لي رغبة كبيرة في تقليد حركاتهم. ولكن أقلعت عن هذه العادة مع مرور الزمن كلما أصبحت أكثر نضجا..بينما كنت واقفا بالقرب من مرتضى الجايجي. وقعت نظري على رجل مسن، علامات الشيخوخة بدت عليه واضحة، كالشمس، في وضح النهار، يقبع في ركن ماسكا النارجيلة وينفخ بالجمر المجهز للتدخين. والى جانبه يقف رجل اخر، في عمر الخمسين يرتدي دشداشة حمراء قصيرة ومخططة، وسترة خضراء اللون، يظهر عليها آثار الترقيع، تم خياطتها بشكل عشوائي. أما حذائه، كان مصنوع من القماش، يبدو هكذا، قد تشبع بالغبار، يصعب التكهن بمعرفة حقيقة لونه الاصلي. وشعره قد داعبه الشَّيْبَ، وخصلاته مبعثرة كما لو انه استيقظ من النوم توا، وترك الدار وتوجه الى السوق مباشرة، وبيده تمر، يمضغ به. ينتظرون البضائع لاستلامها من رؤسائهم كل يوم. لأنهم يعملون لصالحهم مقابل اجر يومي. يبدو انهم ليسوا من اهالي نفس مدينتنا، لانهم اختفوا عن الانظار بعد هذه الزيارات، ولم يبق لوجودهم اثر في السوق. هناك من يأتي من المناطق المتاخمة وخاصة من النواحي القريبة وحتى البعيدة من أجل التبادل التجاري.
وعلى الجانب الآخر تتراصف الدكاكين، والمحلات الصغيرة، والمخازن، وورش لبيع الأدوات الفخارية. ويبيعون مختلف أنواع الخردة. الناس تشتري، فقط لانهم يريدون ان يشتروا. وفي هذا الوقت، جلس ابو صالح العجوز يبدو عليه التعب واضحا، وأثار تصدعات الزمن، بارز على وجهه، مجعداً، طاعنا بالسن، وله شارب ابيض، يحرك حبات مسبحته، تعود الى زمن ما قبل التاريخ، ظل محتفظا بها لأنها صداقة عمر، و مرافقا لمسيرة حياته، التي لا يتذكر شيئا من محاسنها. كان لديه حمام قديم في منطقة نائية، بعيدا عن البيوت، على أطراف المدينة، يقع في قبو تحت الأرض، وله فتحة من فوق السطح، يخرج منها الدخان الاسود، بحيث جعل من الطابوق والحجر في محيطه سُخاما كالفحم. كان يمارس دوره كمتمرس في العلاج الطبيعي، للمرضى الذين يعانون من آلام المفاصل، و الفقرات. كانت الأجواء داخل الحمام تتمتع بحرارة عالية. ويستخدم بعض الأعشاب الشعبية في عمله، اضافة الى وجود البخار والتدليك. التفت إلى العربة، الصغيرة، لبائع الشاي، المتجول، وهو يطقطق بالاستكانات .قال بصوت مبحوح :
– مرتضى، اعطيني استكان شاي بدون سكر . وأضاف
– لا اريد ان يرتفع نسبة السكر اكثر .
مرتضى من الوجوه المعروفة لدى أهالي المدينة. فهو ورث عمله في صناعة الشاي، عن أجداده. رجل قصير القامة، يضع اليشماغ، على رأسه دائما، متمكن جدا في لعبته البهلوانية، على تحريك الاستكان، من اجل اثارة المتعة. رغم انه في الأربعينيات من عمره، الا انه يبدو عليه الشيخوخة، عيناه غائرتان ، انفه عريض، شفته العليا فيها شق. يبدو انه ارث طفولي منذ الولادة. والتجاعيد ملأت وجهه. ظل طول حياته عازبا. مرة سألته
– مرتضى لماذا لا تتزوج؟، ويصبح لديك اولاد، ويساعدونك في عملك
رمقني بنظرة حادة، بحيث حاجباه هبطا فوق عينيه، كأنما انزل مظلة عربته، نظرته اختلطت فيها الحزن، وعدم الرضا. وخاصة السؤال صدر من طفل. سكت قليلا. وقال :
– لا اريد الزواج ، لكي لا املك اطفال وقحين مثلك.
– اغرب عن وجهي
يبدو كلامي كان كسكين حاد فتح له جرح عميق وخفي. لم اكن اعرف عن خلفياته.
أخي الأكبر زكي أوصاني بشراء لاصق، ذهبت الى دكان كريم، كان أهالي مدينتنا يطلقون عليه اسم كريم القزم. فهو قصير القامة، جسده أشبه ببستوقة فخارية، كأنما تم تشكيل رأس عليها. لم يكن مظهره بذلك الصعوبة في رسم لوحة كاريكاتيرية عنه، كنت تستطيع ان تحلل شخصيته من خلال دكانه البسيط. بأدواته والبضائع المبعثرة في فضاء المكان. عندما تدخل الى فناء الدكان تحتاج الى وقت من أجل العثور على كريم. لأسباب عديدة . أولا حجمه ضئيل والدكان يغلفه ظلام عاتِ، والمواد في المحل كما لو ان الدكان تعرض الى تفتيش من قبل الشرطة، او لص كان يبحث عن النقود، ورموا الأشياء بلا تعين. ولكن الغريب في الأمر، ان كريم كان له قدرة خيالية في إيجاد المواد، طلباتك تحصل عليها بسرعة. يلتقط الأشياء من بين الركام، وعندما تدفع قيمة البضاعة، يأخذ النقود وخاصة إذا كانت عملة ورقية، يرميها خلفه. لا ادري كيف يستطيع ان يجد الفلوس لاحقا.
سالته :
– كريم لماذا دكانك هكذا، غير منتظم؟
قال :
– ليس لدي الوقت الكافي لتنظيمه.
قلت :
– انا لدي فكرة
قال :
– ماذا؟
قلت :
– قم بنشر دعاية، مفادها، أنك تبيع الذهب. ربما هناك لص يأتي الى دكانك ويعيد الاشياء الى نصابها.
قال :
– هو يأتي لكي يسرق ام ينظم الدكان.
قلت :
– كيف يستطيع ان يجد الذهب في هذه الفوضى. إذن عليه أولا بترتيب المكان. صح !.
قال :
– انت كنت تعمل لصا سابقا.
قلت :
– فكر بالموضوع جيدا. مع السلامة.
ومقابل زقاقنا يقع دكان سيد مراد، هو نحيف الجسم كعصا الخيزران، له عينان صغيرتان خبيثتان.، غشاش، كان يفتقر الى الاستقامة والشرف، وفي نفس الوقت يمارس الفضيلة، لا ينسى الالتزام بأوقات الصلاة ويصوم كل سنة. كنا نشتري منه حلويات كانت تسمى شعر بنات ونرى بأم عيوننا. كيف وضع ثقل معلق من تحت أحد جانبي الميزان لكي يزيد من وزن البضاعة. كنا نتألم ولكن لم نتجرأ القول. سمعت صوتا قادما من خارج الدكان، خرجنا الى الشارع شاهدنا جمال وهو يمشي و يتمتم مع نفسه.
جمال دَلي. كان مجنون المدينة. يمشي بسرعة، كأنما أحد أبطال الاولمپياد في سباقات المشي، بدين الجثة، وله بطن ضخم، ويسير كعسكري متمرس، مستقيما بقامته، يتكلم مع نفسه، كأنما يطرح الأسئلة الآنية ولا يجد الجواب الشافي إلا من تلك الصادرة من فاهه. وبيده دائما عصا، ناديت عليه باسمه :
– جمال … جمال.
يلتفت الى الوراء دون ان يتفوه بكلمة، ويقلب عينيه ويبرز بياضهما، بطريقة مضحكة. لم يكن عنيفا طالما لا تتعدى حدود صبره. جمال كان يلبس شحاطة في الصيف وحذاء في الشتاء. كان دائما نظيف. أهله يهتمون بهندامه. لكي يبدو بمظهر أنيق.
أتذكر عندما كنت في السادسة من عمري حدث زلزال في مدينتنا الصغيرة، كانت جميلة بأهلها وتنوعها. لم اكن اعلم ماذا يعني الزلزال، ولكن كنا نسمع من الوالدين عن تلك الأساطير عن الحياة والموت وزوال الأرض، كنا نؤمن بها. بل يشاركنا في هذا الايمان ملايين من البشر، وأن حياتنا مرهون بانتهاء الأرض. بحيث ان الإله، الذي صنع الأرض، سوف يعلن عن يوم الحساب، ويدمر كل شيء.، ويحولها إلى أكوام مكدسة.. بدأت الغرفة ترتج، والسرير يهتز، شعرت ان موعد القيامة، قد حان، وأن نهاية الأرض على وشك، وانا على سريري الخشبي والغرفة احتوتها العتمة، كنت اتخيل ان الارض، قد تنشق، وتبتلعنا، كما تبتلع الحيتان الأسماك الصغيرة، و الغرفة سوف تنهار على رؤوسنا، وندفن، أحياء، تحت الركام. كنت اعيش في وجل، ولو للحظة، أصبحت اللحظة كل شيء. لم اعرف شيئا عن هذه الكوارث الطبيعية سابقا. ولكن كانت مفزعة.
كثيرا ما تعرض النهر الجميل، الذي يتوسط المدينة، الى فيضانات هائلة، أثناء الشتاء، يقبض الجسد، والروح، وتساقطه الغزير للأمطار، يحول النهر إلى مارد يجرف كل شيء في طريقه. كنت أهرع باتجاه النهر، لأرى زعل الطبيعة وهي تسكب اكوام الغضب على سر بهجتنا. كان النهر يُرى من فوق الجسر التاريخي الذي يربط المدينة شرقها، بغربها، قد اصبح لونه اسمر فجأة بسبب نزول الاتربة المنتشرة على جانبي النهر، حيث تحولت بفعل الأمطار التي هطلت بغزارة، لتجرفها، أكواما. فاختلط الطين مع ماء النهر وهو يقدح الشرر، هائجا، ويتدفق كمياه عابثة. وبإمكان المرء مشاهدة خيوط الماء المنهمر تربط السماء بالوحل. كان الجسر متماسكا، صلبا، مزودة بدعامات كونكريتية، حجرية صلدة، وثابتة، بشكل محكم جدا، قادرا على الصمود أمام العواصف والتيارات الجارفة الهدامة.
النهار يكسوه غطاء اسود، ومن بعيد كانت الكلاب في البساتين تعوي بحزن.. الماء الصافي الذي كنا نسبح فيه تحول بفعل انجراف الطين وامتزاجه مع الماء، وهي تتدفق بشراهة غير منصفة، يوحي للناظر وكأنه سيل من الشوكولاتة الحلوة تصنعها الطبيعة لنا. وعدت إلى البيت مرورا بمدرستنا الابتدائية.
كانت مدرستي قريبة جدا من البيت، كنت أحب الدراسة وقضاء الأوقات مع الأصدقاء. كانت مدرستنا متفوقة جدا في مجال الرياضة. بفضل معلمنا، كان رائع جدا، يولي اهتمام بالغ في تطوير مستوى الرياضة لدينا، هو ايضا كان متمرس في مجال الساحة والميدان، اضافة الى نشاطات في الكشافة. كنت احبه كثيرا وهناك ايضا من المعلمين الذين تركوا أثرا سلبيا في حياتي . ترسخت في نفسي ذكرى أليمة، ظلت عالقة في ذهني، لسنوات طويلة، وأنا حينها في السنة الثانية في المدرسة، بينما كنت غارقا في عمل واجباتي داخل الصف. وفجأة ارتفع جسدي من مقعدي الى الهواء بواسطة يدين غليظتين واوقعني أرضا بكل ثقله. كما لو انني في حلبة المصارعة، لم تتوقف الضربات وتوجيه الركلات لي أمام جميع التلاميذ الذين كانوا اولاد صغار مثلي. ثم رفعني دون رحمة وقذفني على مقعدي، كما يرمي جمادا، رغم ضربه المبرح لي، وقساوة فعله، الا أنني لم أبكِ، بل جلست، ورأسي منكسا قليلا، وكل حواسي يرتعد من هول الصدمة، احتبست الكلمات في حلقي، كمن عاجز عن الكلام، وعينايّ محدقتان كأرنب وديع إحاطته الحيوانات المفترسة تسلل الرعب الى جسده، يترقب حركة غريمه، ووعينايّ تفيض حقدا عليه ونظراتي تشوبها الذهول، والإذلال. ونبضات قلبي تزداد خفقانا، كنت في حالة وكأنني أستعد لجولة ثانية اكراهاً. لم افهم لماذا عذبني معلمي في الابتدائية ، كان اسمه صالح. طويل، مفتول العضلات، كان في عينه اليمنى حَوَلْ. هذه الحادثة تركت في نفسي جرحا عميقا. لاشيء اكثر ايلاما من ندبات الجروح. كنت اراه في احلامي وهو يطفئ غريزته البربرية بايذائي. بل يثير في نفسه لذة المتعة والسعادة.
الجامع وإمامه كانوا في محلتنا. الإمام كان يعيش في أقصى الجهة اليمنى، والجامع يقع في اقصى اليسار، كان للجامع، بابان، يفصل المحلة عن الجهة الثانية من الشارع. فيخفف من وطأة المشي بدلا من السير طويلا. كنا نسمع صوت ملا سعيد وهو يأذن صباحا بصوت جهوري بدون مكبرات الصوت مع الفجر قبل ان تبلغ الشمس سمتها. ملا سعيد كان بدين، أعمى، ولكن كان لا يخطئ الطريق ابدا. كان يسكن في محلتنا، مفتاح باب الجامع كان بحوزته. كنت اتصور ان ملكية الجامع تعود له. والحسينية على الجانب الآخر قريب من النهر، كان آذان الفجر من مكبرات الصوت يخترق أجواء المدينة فتصطدم بذبذبات الصوتية لملا سعيد في الهواء. ثم مع الزمن حصل الجامع أيضا على مكبرات الصوت.. من الطرائف مع ملا سعيد انه بعد اذان المغرب نسي ان يطفئ جهاز المصدح، راح يغني مع نفسه.. هله ليلة هله.. اتذكر تم إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة. وصل الى حد دارنا، وبصوته الجهوري، نادى على أمي، كي يخبرها ان الشرطة اعتقلته. وفي مركز الشرطة وجه له الضابط سؤالا :
– قل لي كيف أنت ملا وفي نفس الوقت شيوعي. يا خروشوف
كنت استغرب من قدرة ملا سعيد على معرفة بعض الشخوص بالرغم انه لا يبصر. في احدى الايام تحدث عن مَمَدْ، بعد ان اعتراني الخوف منه. قال :
-لا تخاف منه، القدر جعل منه هكذا.
مَمَدْ، ينام في وسط القبور. تلك المقبرة تقع على نواحي المدينة ، فهو غريب الأطوار، نحيل الجسم، جبهته عريضة، له حاجبان عريضان، منفوشان، يتدلى على العينين. يظهر عند العصر في المدينة، ويمر أمام السينما، يسير حافي القدمين في أسمال ممزقة. وعلى رأسه طاقية ملفوف عليها رباط اخضر، ويشد على بطنه حزام عتيق من الجلد. يرتدي دشداشة طويلة وسترة شتوية. كان وجهه شاحبا، كمن أصابه فقر الدم، هزيل البدن، وضامر، عظامه بارزة، تتلمسه من رقبته، كان حجم السترة لا اتذكر لونها اكبر من جسمه، لم اره ابدا بدونها، حتى في أعلى درجات الحرارة، كنت في دهشة من امري كيف لا يفقع هذا الرجل. وانا انظر الى مقلتيه، ظلت عيناه محدقتان، وهو ينظر إلى الأمام، دون ان يحرك رموشهما. كأنما اصابه صدمة قوية ولم يفق منها بعد، كنت اخشى من وجوده. كان يمشي منحني الظهر، يحرك فقط يده اليمنى، بقوة الى الأمام والخلف، بينما يده اليسرى ثابتة ملاصقة بجسده. عندما يتقرب المرء منه. يشعر بثقل الهواء وهو يحمل رائحة نتنة، بسبب الجيفة في جسده. ما ان جلس للراحة قليلا، سرعان ما يتجمع الذباب حوله بحثا عن الطعام ، وكأن صندوق القمامة انفتحت غطاءه. انتفضت رائحتها لتصل إلى الذباب. وفجأة بعد برهة من حضوره يختفي عن الأنظار.
كلام ملا سعيد ظل يتردد في ذاكرتي. بان القدر جعل منه هكذا. المرء يرى في حملقته تمرد واضح على بؤس الزمان، انتفاضة ضد اللاعدالة، ومع ذلك كان يعيش في عالم وهمي صنعه لنفسه، مجرد من كل القشور، وجوده بين الأموات، يمنحه شعورا، بالحرية، والسعادة . لا صوت يعلو على صوته. سمعت من أخي الكبير بأن مَمَدْ يعتقد ان الذين يسكنون في القبور ويقصد بالساكنين، الأموات، يدخلون في سكون مطبق، ما ان يصل الى موطنه. واحيانا عندما ينام يرتفع في الظلام انينا عميقا يزعجه أثناء النوم. عند سماعي لهذه القصة، شعرت بالخوف أكثر. كنت أتصور بأن الحياة بدت له شريرة وظالمة الى حد اللعنة، وكل شيء مناط الى الصدفة .
هبط الليل على القبور، بعد يوم مثقل ومملوء. رقد مَمَدْ في حفرته وسط القبور، مستشعرا الم الحياة تحت ترابه الساخن في تلك الحفرة بحجم جثته . كما يسميها هو موطنه. أسدل أجفانه، أغمض عينيه المثقلتين، ليدخل إلى عالم الأحلام، عالم يجد فيه ضالته، ويعيد قواه قبل ان تشرق شمس الصباح وتحرمه من أحلامه. وتحت جفنيه المغمضين، ربما مرت بحور من الالام منذ ولادته، وربما شعر انه يسبح في الفضاء عاريا، حرا، في عالم يختلف عن عالمه، الذي فقد فيه ساعاته، وأيامه. لم يعد يسمع ذلك الأنين بعد الآن. سكن قلبه وبقي جاثما في حفرته إلى الأبد. كنت اراه دائما قريب من السينما، لم يعد لمَمَدْ أي حضور يذكر. عندما مررت بالقرب من السينما تذكرت ان المكان ينقصه انسان مجهول.
كنت احب السينما، حتى ولو لم احضر اي فلم. كان ينتابني شعور بالبهجة بمجرد إلقاء نظرة على المانشيتات للافلام. كنت سرا دون ان أخبر أهلي، اذهب مع بعض اصدقاء المحلة إلى السينما. لم يكن في حوزتنا ما يكفي من النقود لشراء تذكرة الدخول. فكنا نقف امام باب الصالة، عندما يبدأ العرض، نبدأ بالاستعطاف من قاطع التذاكر، ان يسمح لنا بالدخول، كان يسأل عن كمية النقود التي بحوزتنا، نمد يدنا مفتوحة، كمن يقول هذا كل ما نملكه، يلتفت يمينا ويسارا، يلتقط النقود، و يخفيها في جيبه، و بإيماءة من رأسه، مشيرا الى الباب، مطالبا، الاسراع بالدخول. ومع الزمن أصبحنا معارف. ما ان يبدأ العرض يأخذ منا الفلوس وندخل بسرعة الى داخل الصالة. وأحيانا لم نملك مالا ، سمح لنا بالدخول مجانا.
الشمس اختبأت خلف الغيوم القادمة من غبار الصحراء التي تحوم في الجو، غبار خانق وحر لا يطاق. كان يوما ثقيلا بطبيعتها غير الهادئة. يبعث في النفس القلق. أخذتني والدتي الى المضمد مصطفى وانا في عمر ست سنوات من أجل لقاح السل. دخلت الى فناء المستوصف، حتى بدأ الجسد يرتعد والخوف يتسلق على اكتافي وريشة الابرة رسمت تشنجاتها على ملامح وجهي. امسكت بامي وألصقت نفسي بها . وبينما امي تربت على ظهري وتحاول تهدأتي، يمسك المضمد مصطفى بالقطن المبلل بالديتول لتعقيم ذراعي قبل الزرق. انتابني فزع شديد . أخذت بالصراخ فاغراً فاهي . المضمد مصطفى نفذ صبره من حدتي على قبول الزرق، فقذف القطن المبلل في فمي. شعرت بالغثيان، ورحت اتقيئ القطن، وأمطَرتُ المكان برذاذ بصاقي، لازالة اثار الديتول عن لساني. وبعد ان هدأت الامور وشاهدت الآخرين لا يخافون، تشجعت قليلا. وافقت على زرقي وانتهى الأمر.
ايام رمضان كانت لها سمة خاصة. ملامحها يظهر جليا على وجوه الناس. يتجمع الأهل حول مائدة الإفطار، بعد إطلاق المدافع، وارتفاع اصوات الاذان. يشرع الناس بنهم الاكل. و كان يحدث بعض الطرائف خلال فترة رمضان في محلتنا. بعض الشباب المدينة لهم مزاج جميل في ترطيب الأجواء. مجاميع ينظمون لانفسهم ليالي السمر، يجتمعون في النادي الليلي، او احيانا في البساتين، ويحتسون العرقى. وفي ليلة القدر، في ساعة متأخرة من الليل، سمعنا أصوات الطبول وتبعتها، صراخ، وعويل..حيث جاءت هذه المجموعة من الشباب، لجمع بعض الأموال، طرقوا باب احدى البيوت وخرج عليهم عدنان. كان يطلقون عليه لقب، عدنان دُكَمة. شاب غريب الاطوار، يبدو من مظهره صعب المراس، ومعقد نفسيا، قليل الكلام، انعزالي. أصبح غاضبا، وبيده دلو مملوء بالماء، ورشه عليهم، هربوا الشباب من المكان. سرعان ما هدأت الامور عادوا الى نفس الدار.. وهبوا بالغناء.. ماجينا يا ما جينا.. حل الجيس وانطينا. الله يموت عدنان… أربعون عشرين ساعة بالحمام. ثم اختفوا عن الأنظار..
انتقلنا من مدينتا إلى العاصمة. وعشت جزءا من طفولتي هناك، وبينما كنت في زيارة الى مدينتي السابقة لإجراء بعض الأعمال الضرورية. حيث كنت امشي في الشارع المقابل لضفاف النهر مع صديق طفولتي رياض، هبت ريح خفيفة تحمل نسمة هواء النهر. لامست بشرة وجهي و حركت خصلات تسريحتي. التقيت بالصدفة بمعلمي صالح الأحول في هذا الشارع . كنت في حينها، قد بلغت التاسعة عشرمن عمري. بعد الترحيب ذكرته بحادثة ضربي عندما كنت طفلا في السنة الثانية في الابتدائية، وقلت باني لم أنس هذه الجريمة طوال فترة طفولتي. كنت احمل كرها شديدا في نفسي تجاهه، واقسمت، ان اعيد له تلك اللكمات، عندما أصبح بالغا وقادرا على المبارزة.
قال بنوع من المزاح :
-هل تريد ان تأخذ ثأرك؟.
أجبته بنوع من الكبرياء :
– عندما تجاوزت مرحلة الطفولة، وأصبحت ناضجا، احسست بالم، كم من المخجل ان تكون انسانا مربيا، وتتعامل مع الآخرين كجلاد، وخاصة عندما تكون الضحية طفلا، لا يستطيع حتى الدفاع عن نفسه. بل شعرت كم هو عمل منبوذ ان تمارس العنف أيا كان .
كنت أنظر الى قسمات وجهه وهو يتلقى الموعظة من إنسان، كان يوما ما تلميذا صغيرا.لا يدرك شيئا من الحياة سوى المدرسة ولعب الأطفال، كان منظره مثير للشفقة. كمن تتقاذفه الأمواج باتجاه العاصفة ويبحث عن ملجأ للخلاص. لم يرد، ولم يقدم الاعتذار، تركته لضميره. ولكن مصارحتي له بجرأة، ازاح عن صدري عبء ثقيل، وعظيم. لأن السعادة الحقيقية تتكامل عندما تطرد القلق. فما زال للمرء ان يستمتع بالالوان، والاشجار، وسماع الموسيقى، وتغاريد العصافير.
كان الغسق، قد بدأ دَهْمَته، والسماء، عند المغرب، قد ظفرت بجمال متميز .. وكانت عذبة بسمتها، وإذا بنجمات صغيرات متناثرة، موشاة بالذهب ، تتباهى بحضورها في بنفسج المساء القاتم.
 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل