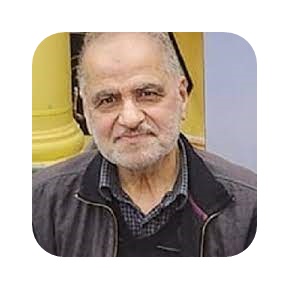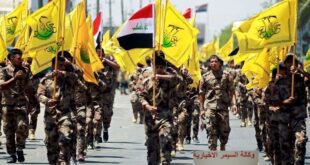فيينا / الخميس 02 . 01 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
د. فاضل حسن شريف
عن مركز دراسات تفسير الاسلام عن البراغماتيَّة (الذرائعيَّة): (البراغماتيَّة) بالإنكليزية: Pragmatism، وأصلها اليوناني: Pragmaticus، تُعبَّر عنها في العربية بـ: (الذَّريعيَّة) أو (الذرائعيَّة)، أو (العملية)، أو (العَمَلانِيَّة)، أو (الأداتية)، وبنحو ذلك من الألفاظ حسب اختلاف الترجمة أو التوجهات المختلفة في إطار هذه الفلسفة. وهي اسم مشتقٌّ من اللفظ اليونانيِّ: براغما pragma، ويُعبَّر عنه بالإنكليزية بكلمة: action، أي: عمل، فعل، تصرف، سلوك، نشاط، فعاليَّة. أو affair، أي: مسألة، أمر، شأن ـ تجاريًّا كان أم سياسيًّا أم مهنيًّا، أو غير ذلك. ويُذكر عن المؤرخ اليوناني بوليبيوس Polybius (ت: 118 ق م) أنَّه سمَّى كتاباته بـ: pragmatic، مما يدلُّ على أنه كان يهدف إلى أن تكون مفيدة ونافعة للقراء. أما مصطلح: (النفعية) أو (النفعانية) Utilitarianism فيرادف البراغماتية في هذا السياق بمعناه العام، فيطلق على: (كل مذهب يجعل من النافع أساسَ كلِّ القيم في مجال المعرفة، وكذلك في مجال العمل. فيدل اسم (نفعية) على النسق الذي يكمن في إرجاع معنى الصحيح العادل إلى معنى النافع، وتاليًا: في جعل المنفعة أساسًا للحقِّ والأخلاق). (البراغماتية: مذهب فلسفيٌّ يقرِّرُ أن العقل لا يبلغ غايته إلا إذا قاد صاحبه إلى العمل الناجع، فالفكرة الصحيحة هي الفكرة الناجحة، أي: الفكرة التي تحققها التجربة، فكل ما يتحقق بالفعل فهو حقٌّ، ولا يُقاس صدق القضية إلا بنتائجها العملية. ومعنى ذلك كلِّه أنه لا يوجد في العقل معرفة أولية تستنبط منها نتائج صحيحة بصرف النظر عن جانبها التطبيقيِّ، بل الأمر كلُّه رهنٌ بنتائج التجربة العملية التي تقطع مظانَّ الاشتباه. وإذا كانت الحقائق العلمية تتغيَّر بتغيُّر العصور فإن الصادق بالحاضر قد يصبح غير صادق في المستقبل. ونتيجة ذلك واضحة جدًّا وهي أنَّ صدق القضايا يتغيَّر بتغيُّر العلم، وأنَّ الأمور بنتائجها، وأنَّ الحقَّ نسبيٌّ، أي: منسوبٌ إلى زمان معيَّن، ومكان معيَّن، ومرحلة معينة من العلم، فليس المهمُّ إذن أن يقودنا العقل إلى معرفة الأشياء، وإنما المهمُّ أن يقودنا إلى التأثير الناجع فيها. ويقابل هذا المذهب ـ الذي أخذ به: شارل ساندز بيرس (1839-1914م)، ويليام جيمس (1842-1910م)، وجون ديوي (1859-1952م)، الأمريكيون([4]) ـ مذاهبُ فرنسيةٌ قريبةٌ منه، كقول هنري برغسون (1859-1941م): إن العقل هو القدرة على صنع الأدوات. وقول إدوارد لوروا (1870 ـ 1954م): تُقاس قيمة الدِّيانة بما تتضمَّنه من قواعد سلوكية، لا بما تتضمَّنه من حقائق. وقول موريس بلوندل (1861 ـ 1949م): إن العمل هو المحيط بالعقل، فهو يتقدَّم على الفكر ويهيِّئُه، ويتبعه، ويتخطاه، وهو تركيب داخلي لا تمثيل موضوعي. وقوله: إن التفكير في الله عملٌ. ففي هذه المذاهب كما ترى شيء من البراغماتية، إلا أنها لا تبالغ في إرجاع الحقيقة إلى النجاح العملي، ومع أنَّ بلوندل يُشارك البراغماتيين في بعض آرائهم إلا أنه يسمِّي مذهبه بفلسفة العمل، لا بفلسفة البراغماتية. والبراغماتي Pragmatic هو المنسوب إلى البراغماتية، معناه: العملي أو النفعي. ومن فروع البراغماتية مذهب الأداة Instrumentalism وهو قول ديوي: النظرية أداة أو آلة للتأثير في التجربة وتبديلها، والمعرفة النظرية وسيلة للسيطرة على المواقف الشاذَّة، أو وسيلة لزيادة قيمة التجارب السابقة من حيث دلالاتها المباشرة. والعلة الأداة instrumental cause عند فلاسفة القرون الوسطى، هي العلة الفاعلة).
عن موسوعة السبيل: البراغماتية للدكتورة ربى الحسني: التأثر والبيئة: تعد الولايات المتحدة الأمريكية موطن البراغماتية الأم، حيث ظهرت هناك ثم لقيت انتشاراً عالمياً واسعاً، وقد تبلورت الخطوط العريضة لهذه الفلسفة في سبعينيات القرن التاسع عشر، في مؤلفات عالم المنطق الأمريكي تشارلز بيرس، ثم تطورت على يد وليم جيمس، وجاء بعده جون ديوي الزعيم الروحي للبراغماتية المعاصرة في أمريكا. والأمريكيون مغرمون بالعلم والتفكير والبحث وراء القضايا والنظريات العلمية، ولهم في كل مجال رأي ونظر، ويتميزون عن غيرهم بغرامهم للتطبيق، وبافتتانهم بالنتائج الواقعية للأشياء. فنجدهم يسارعون إلى تطبيق أي نظرية علمية تُكتشف، بغية معرفة صدقها وماهية الآثار الناتجة عنها وفائدتها في الحياة الراهنة، فإذا لم تكن لها نتائج في الحياة والبيئة التي يعيش فيها الأمريكي، فهي مجرد نظرية تضاف إلى سابقاتها وتوضع جانباً. ويتميز الشعب الأمريكي بحب المجازفة والاستهتار بالمخاطر، وليس ذلك عن شجاعة بالضرورة، بل لمجرد الرغبة في مشاهدة النتائج العملية التي تترتب على هذه المخاطرة، كما يحب الأمريكيون الاستمتاع بالحياة الراهنة، ويشكل النجاح المادي لديهم غاية في ذاتها. ومع أن الفلسفة الأمريكية اتخذت مسارها التاريخي من خلال متابعة الفلاسفة الأمريكيين للتراث الفلسفي العالمي عبر التاريخ، إلا أن تطورها تميز بميزة أساسية هي شمولها لكل جوانب الحياة بما فيها السياسة والاقتصاد والثقافة والدين والأخلاق. وقد تأثرت أيضاً تأثراً بالغاً بتطور العلوم عامة، وعلم الأحياء والنفس خاصة، لا سيما أبحاث عالم الأحياء الإنكليزي تشارلز داروين ونظريته في النشوء والارتقاء المعروفة بـ”نظرية التطور”، وتقوم على الاعتقاد بأن أشكال الحياة المختلفة تعود إلى أصل واحد مشترك، حيث بدأت من خلايا بسيطة تكونت عن طريق المصادفة عبر عمليات كيميائية مركبة، ثم تطورت إلى كائنات كبيرة معقدة. واستنتجت نظرية التطور ما يعرف بقانون الصراع بين الكائنات، أو التنازع من أجل البقاء، الذي نتج عنه تعبير “البقاء للأصلح” أي أن الأفراد الذين يتمتعون بصفات تميزهم عن غيرهم، ستكون لهم فرصة أفضل للبقاء بعد صراعهم مع بقية الكائنات الأضعف منهم، حيث يبقى القوي وهو الأصلح ويهلك الضعيف. ويذكر أيضا أن البراغماتية تستمد الكثير من مبادئها من المقولة الشهيرة للفيلسوف الإيطالي ماكيافيلي: “الغاية تبرر الوسيلة”، لذا تسمى البراغماتية أيضاً باسم “الذرائعية”.
اذا كانت الأصنام لا تسب فالأولى براغماتيا لا يسب أي عبد من عباد الله حتى لا تخلق مشاكل حولك، وفي الوقت الحالي يسمى الإعلام الذي هو واجهة الدولة المسموعة والمقروءة والمرئية. وحتى عمليا الأعتداء على الآخرين ولو كانوا يعبدون الأصنام إذا لم يعتدوا فعلينا تركهم اذا لم يقبلوا النصيحة، فالمرجع اليه سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني عدم الاستعداد بقوة العقيدة العملية والمعنوية لمجابهة العدو عند الاعتداء الداخلي وعند دخول الحدود. جاء في تفسير الميسر: قوله عز وجل “وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ” ﴿الأنعام 108﴾ عدوا: ظلما و اعتداء. واعتدى: ظلم، والعدوان: الظلم، ولا تسبوا أيها المسلمون الأوثان التي يعبدها المشركون سدًّا للذريعة حتى لا يتسبب ذلك في سبهم الله جهلا واعتداءً: بغير علم. وكما حسَّنَّا لهؤلاء عملهم السيئ عقوبة لهم على سوء اختيارهم، حسَّنَّا لكل أمة أعمالها، ثم إلى ربهم معادهم جميعًا فيخبرهم بأعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا، ثم يجازيهم بها.
عن الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله تبارك وتعالى “وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ” ﴿الأنعام 108﴾ تناولت الآيات السابقة موضوع قيام تعاليم الإسلام على أساس المنطق، وقيام دعوته على أساس الاستدلال والإقناع لا الإكراه، وهذه الآية تواصل نفس التوجيهات فتنهى عن سبب ما يعبد الآخرون ـ أي المشركون لأنّ هذا سوف يدعوهم إلى أن يعمدوا هم أيضا ـ ظلما وعدوانا وجهلا ـ إلى توجيه السب إلى ذات الله المقدسة: “وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ”. يروى أنّ بعض المؤمنين كانوا يتألمون عند رؤيتهم عبادة الأصنام، فيشتمون أحيانا الأصنام أمام المشركين، وقد نهى القرآن نهيا قاطعا عن ذلك، وأكّد التزام قواعد الأدب واللياقة حتى في التعامل مع أكثر المذاهب بطلانا وخرافة. إنّ السبب واضح، فالسّب والشّتم لا يمنعان أحدا من المضي في طريق الخطأ، بل إنّ التعصب الشديد والجهل المطبق الذي يركب هؤلاء يدفع بهم إلى التمادي في العناد واللجاجة وإلى التشبث أكثر بباطلهم، ويستسهلون إطلاق ألسنتهم بسبّ مقام الرّبوبية جل وعلا، لأنّ كل أمّة تتعصب عادة لعقائدها وأعمالها كما تقول العبارة التّالية من الآية: “كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ”. وفي الختام تقول الآية: “ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ”.
والاسلوب العلمي في الخطابة كما يقول الشيخ الوائلي ليس الشتم والتعدي لان العلم يعتمد على المحاورة بالحسنى للوصول الى الحقيقة وما يستفيد منه المجتمع كما جاء “وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ” ﴿الأنعام 108﴾.
عن ثقافة التسامح قال الله سبحانه”وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ” (الانعام 108) جاء في صحيفة انباء عن التسامح في الاسلام للكاتب عقيل يوسف عيدان: وهكذا بات واضحاً أن التسامح الديني مطلب إنساني نبيل دَعَت إليه الأديان كافة دون استثناء، وكيف لا تدعو إليه وقد أرادته الحكمة الإلهية واقتضته الفِطرة الإنسانية واستوجبته النشأة الاجتماعية وفرضته المجتمعات المدنية وتُحتّمه ثقافة العولمة وما تحتاج إليه من قِيَم حضارية ومَدنية نبيلة. والمهم أيضاً، أن الإشكال ليس في الأديان ذاتها وإنما هو كامن في عُقم إفهام بعض القائمين عليها ولا زالت المفارقات بين المبادئ والممارسات الواقعة هنا وهناك لا تُحصى. أليس هناك إجماع على أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان ومع ذلك فإننا نجد من التفاسير ما لم تحرص على شيء حرصها على إظهار الإسلام في شكل لا يقدر على تطبيقه إلاّ من أَلِفَ العيش في مغاور جبال أفغانستان ؟ ألم يكن هناك إجماع على أن الإسلام دين ينبذ الغلظة والفضاضة والجفاء ويحض على اللين والرّفق والسماحة والتيسير ويأمر بالتحابُب والتوادُد والتراحم والتآلف ويعترف بوجود الآخر ويُقر حقّه في التَّديّن ويُقدّر اختياره ويدعو إلى احترام ما ارتضاه من خصوصية وإلى التعامل معه بلطف وإحسان وينهى عن سبّه والتحرّش بدينه، ولكن هل لدى الخطاب الديني المتشنّج من براعة سوى إمطار المخالفين من داخل دينه وخارجه بالقذائف الجارحة التي لا تحصى ولا تُعد؟
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل