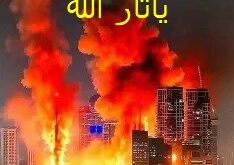السيمر / الاحد 16 . 07 . 2017
ضياء الشكرجي
هذه هي الحلقة السادسة عشر والمئة من مختارات من مقالات كتبي في نقد الدين، حيث سنكون مع مقالات مختارة من الكتاب الرابع «الدين أمام إشكالات العقل».
قصة فشل المشروع الإلهي في سورة الشعراء
سورة الشعراء، التي لم ينتبه مؤلفها ومؤلف القرآن، إنه إنما قدم في هذه السورة عرضا سريعا وموجزا لقصة فشل الله – تنزه الله – في مشروعه عبر أنبيائه ورسله، ذلك المشروع المسمى وحي الله ودينه ورسالته، من أجل دعوة البشرية للإيمان به، وتوحيده، وعبادته، ومن أجل إصلاح المجتمع الإنساني.
ففي مطلع السورة، في الآية الثالثة، يخاطب الله – كما يروي المؤلف – بادئ ذي بدء نبيه الذي ختم بنبوته النبوات، فأحال جبريل للتقاعد وأراحه من مهمة الهبوط والتبليغ. إذ تروي السورة معتبرا مؤلفها إنها رواية الله وخطابه له في الثالثة من آياتها بقوله المفترض: «لَعَلَّكَ باخِعٌ نَّفسَكَ أَلّا يَكونوا مُؤمِنينَ»، ثم تعبر عن خيبة أمل الله في الناس الذين ما خلقهم والجن إلا ليعبدوه، إذ تؤكد الآية على ألّا جدوى من دعوة الناس إلى الإيمان بقوله: «وَما يَأتيهِم مِّن ذِكرٍ مِّنَ الرَّحمانِ مُحدَثٍ إِلّا كانوا عَنهُ مُعرِضينَ». ثم تنتقل السورة لسرد قصة فشل المشروع الإلهي – تنزه الله عن ذلك وتعالى -، عارضة فشل المشروع عبر سلسلة قصص الأنبياء والرسل قبل خاتمهم وسيدهم، فتبدأ من الآية العاشرة لتسرد باختصار قصص عدد من الأنبياء، الواحد تلو الآخر، وكيف كلفهم الله الواحد بعد الآخر بدعوة الناس إلى الإيمان بالله وتوحيده وعبادته، مع تكرار قوله في كل مرة، كمحصلة لتلك الدعوة: «وَما كانَ أَكثَرُهُم مُّؤمِنينَ». إذن الذين يستجيبون لدعوات الأنبياء مثلوا دائما الأقلية، بينما لم يكن أكثر الناس مؤمنين. فبعدما تبدأ السورة من الآية الحادية عشرة بسرد قصة موسى مع قومه ومع فرعون وآل فرعون وأهل مصر، حتى تصل بنا إلى الإخبار عن إغراق آل فرعون وإنجاء موسى وآل إسرائيل، بالقول في الآيتين (65) و(66): «وَأَنجَينا موسى وَمَن مَّعَهُ أَجمَعينَ، ثُمَّ أَغرَقنَا الآخَرينَ». وبعدها تقرر السورة عن لسان الله النتيجة التي تتكرر في كل مرة، ألا هي: «وَما كانَ أَكثَرُهُم مُّؤمِنينَ». ويتكرر الأمر مع إبراهيم، ونوح، وهود، وصالح، ولوط، وشُعَيب. في كل مرة يقول النبي المرسل حسب الرواية القرآنية إلى قومه: «إِنّي لَكُم رَسولٌ أَمينٌ، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطيعونِ، وَما أَسأَلُكُم عَلَيهِ مِن أَجرٍ إِن أَجرِيَ اِلّا عَلى رَبِّ العالَمينَ»، وفي كل مرة تكون النتيجة: «وَما كانَ أَكثَرُهُم مُّؤمِنينَ»، وكأنه فلم يعاد إنتاجه وإخراجه بممثلين جدد، تتكرر فيه نفس القصة. وكامل آيتي المحصلة في كل مرة هو «إِنَّ في ذالِكَ لَآيَةً، وَّما كانَ أَكثَرُهُم مُّؤمِنينَ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العَزيزُ الرَّحيمُ». ولا نعلم أين تكمن هذه الآية، بمعنى العلامة والدليل والبرهان، ثم أين تكمن العزة لله، والتي تعني القوة والقدرة، التي لا يمتنع عليها شيء. من غير شك إن الله عزيز منتهى العزة، ورحيم منتهى الرحمة، وحكيم منتهى الحكمة. لكن هذا السرد لفشل المشروع الإلهي ينفي ضمنا، وكمحصلة، كل ما أراد المؤلف أن يثبته لله من صفات الكمال.
ولو أوتي لنا القيام بدراسة شاملة للقرآن، وربما أيضا للعهد القديم، لإثبات فشل المشروع الذي نسب إلى الله وما هو بمشروعه، لوجدنا تأكيد هذا الفشل لمشروعه المُدَّعى. فها هي سورة الأحزاب تقرر في آيتيها الأخيرتين 72 و73 فشل الإنسان في حمل الأمانة الإلهية، بسبب ظلمه وجهله، فتقول الآية 72: «إِنّا عَرَضنَا الأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالأَرضِ وَالجِبالِ فَأَبَينَ أَن يَّحمِلنَها وَأَشفَقنَ مِنها، وَحَمَلَهَا الإِنسانُ، إِنَّهُ كانَ ظَلومًا جَهولًا». صحيح إن ذلك لم يكن على نحو التعميم والإطلاق، لكن القول عن الإنسان «إِنَّهُ كانَ ظَلومًا جَهولًا»، يدل على أن هذا يمثل القاعدة، وما سواه هو الاستثناء النادر، والنادر جدا جدا. بينما تحاول أن تقدم لنا الآية 73 التالية للآيتين آنفا، المبرر أو الحكمة الإلهية من ذلك بالقول: «لِيُعَذِّبَ اللهُ المُنافِقينَ وَالمُنافِقاتِ وَالمُشرِكينَ وَالمُشرِكاتِ، وَيَتوبَ اللهُ عَلَى المُؤمِنينَ وَالمُؤمِناتِ وَكانَ اللهُ غَفورًا رَّحيمًا»، واللام في قول «لِيُعَذِّبَ» والمعطوف عليه فعل «وَيَتوبَ» هي لام العلة، أي التي تفيد معنى السبب والعلة والحكمة من كل ذلك. صحيح إن آية حمل الأمانة تشتمل على معنى في غاية الجمال والدقة، فيما هي مهمة الإنسان الذي أراد الله أن يجعله خليفته في الأرض، لأن الإنسان وحده مما نعلم من مخلوقات، هو الكائن الواعي المريد العاقل المفكر، وبالتالي فهو وحده المؤهل لمهمة الاستخلاف وحمل الأمانة. ولكن بما أن الله هو الذي خلقه، وهو الذي يعلم، كما تنبأت ملائكته – حتما بتعليم منه لهم، والذي عبروا عنه بقول «لا عِلمَ لَنا إِلّا ما عَلَّمتَنا» – بأنه إنما «يَجعَلُ فيها [أي الإنسان] مَن يُفسِدُ فيها وَيَسفِكُ الدِّماءَ»، وبأنه سيكون «ظَلومًا جَهولًا» وبأن الناس «ما كانَ أَكثَرُهُم مُّؤمِنينَ»، وبأن البشرية لا تستحق بالمحصلة إلا نار جهنم خالدين فيها، باستثناء قلة ضئيلة. فهل من المعقول والمقبول أن يؤسس الله القدير الحكيم لمشروع فاشل، ويخلق هذا النوع الراقي من مخلوقاته، ألا هو الإنسان، من أجل أن يفشل في امتحانه، الذي يعلم الله فشله مسبقا، كي يُشوى في النار من بعد ذلك في عذاب، ليس مثله عذاب، وليس له أمد ونهاية؟ تعالى الله عن ذلك تعاليا كبيرا، وتنزه عنه تنزها عظيما.
عندما يكون لله مشروع، وهو القدير الحكيم، وهو العادل الرحيم، وهو مشروع الدين بالذات، لكان أتقن مشروعه، ولم يتركه في كل مرة عرضة للفشل. إذن الدين لا يمثل مشروع الله للإنسانية. فهل يعني ذلك ألّا حكمة من الخلق؟ بكل تأكيد هناك حكمة من الحكيم، الذي لا حكيم مثله. لكن هل يجب بالضرورة أن نتعرف على فلسفة وجودنا، والحكمة من خلقنا، بالدقة المتناهية التي يمتنع معها الخطأ؟ أبدا لا أتصور أننا مكلفون بذلك، ولا أتصور إن الله ينتظر منا اكتشاف كامل الحكمة. إنما الحجة علينا والحجة لنا أمام الله، هو ما ندركه ونعيه، فقد نفخ فينا الخالق عقلا وضميرا ونزعة إنسانية. فلا أتصور إن مؤلف القرآن أفلح في الإجابة على الحكمة أو الغاية من خلق الإنسان، عندما قال وَما «خَلَقتُ الإِنسَ وَالجِنَّ إِلّا لِيَعبُدونِ[ـي]»، إلا إذا كان المقصود بالعبادة معناها المجازي، أي من أجل أن يعيش الإنسان – ولا شغل لنا مع الجن – منسجما مع قيم الله ومثله، وأن يجسد معنى الاستخلاف، ويكون حاملا للأمانة المؤتمن عليها، لا بأمر مباشر موجه إليه من الله، بل بما أودع فيه من ملكات؛ ليحمل الأمانة المسؤول عنها تجاه نفسه، وتجاه نظيره الإنسان، وتجاه المخلوقات الحية الأخرى من حيوان ونبات، وتجاه الطبيعة، وتجاه الكون الذي سخره الله له، وكمحصلة يكون قد أدى الأمانة تجاه الله، بما منحه من ملكات عقلية، وملكات إنسانية، كي يتعقل ويتعلم من جهة، فلا يكون جهولا، وكي يتزكى ويستقيم من جهة أخرى، فلا يكون ظلوما، سواء آمن بالله أو لم يؤمن.
نعم أفلح وتألق مؤلف القرآن في عدد غير قليل من الموارد في قرآنه، عبر طرح تصوراته عن الله والإنسان والكون، ولكنه أخفق في أضعاف أضعاف ما أفلح فيه. فقد أصاب في توحيد الله، بنفي الشريك له، ونفي الجزء منه، ووصفه أحدا صمدا، ليس له كفوٌ أحد، ولا كمثله شيء، وكون رحمته وسعت كل شيء، وكونه جعل الإنسان خليفته في الأرض، وكونه نفخ فيه من روحه، وكونه أودع فيه قابلية حمل الأمانة، وكونه أراد للإنسان أن يُعلِّم نفسه ويزكّيها، كي لا يكون جهولا ولا ظلوما، وأن عليه أن يستقيم إلى الله ويكدح إليه كدحا فيلاقيه. أذكر هذا، وهناك غيره كثير، مما تفرض الموضوعية والإنصاف الإقرار به. ولكن الذي يدل على امتناع أن يكون هذا القرآن العظيم في الكثير من جوانبه، من وحي الله، لما فيه الكثير الكثير مما يتعارض مع العدل والمساوة في عالم الإنسان، من أحكام فيها الكثير من الإجحاف والظلم والتمييز، وفيها الكثير من اللامعقولية واللامبرر لها، بل اشتماله، أي القرآن المنسوب إلى الله، الكثير الكثير مما يتعارض مع حكمة الله وعدله ورحمته وجلاله وجماله. وإن كان مؤلف القرآن أصاب في معظم الصفات الذاتية لله، لكنه شوّه من جمال هذا الصفات، ونقص من كمالها، عبر ما نسب إلى الله من أحكام غير عادل الكثير منها، وغير حكيم الكثير الآخر، ومن تصوير لجزاء أخروي يتنزه الله عنه، من سادية مرعبة متناهية في القسوة واللارحمة من جهة، ومن ثواب ساذج في جنة عرضها السماوات والأرض، يتقابل فيها المتمتعون فيها كسالى على سرر وأرائك، لا يتعبون أنفسهم في شيء، بل ترى حتى الفواكه قطوفها دانية وفي متناول اليد من غير أي جهد، علاوة على الاستمتاعات الجنسية التي لها أول وليس لها آخر، كما هناك أنهار من لبن، وأخرى من عسل، وثالثة من خمر. وإلا فالجزاء لازم من لوازم العدل الإلهي، والعدل متناه في الدقة، وموزون بموازين القسط الإلهي التي لا تخطئ أبدا وبالمطلق، والذي أي هذا العدل لازم من لوازم كمال الله المطلق، والذي بدونه لا يكون الله واجب الوجود، ولا العلة الأولى التي لا علة لها، وبدون وجود واجب الوجود، ما كان سيكون وجود ممكن حادث مخلوق أبدا. فالدين عموما والإسلام خصوصا له ما له من الكثير، وعليه ما عليه الكثير الكثير من أضعاف الكثير مما له، فإثمه أكبر من نفعه، رغم أن فيه منافع للناس، تلك المنافع التي يمكن للإنسان أن يحصل عليها من خارج الدين، مما وهبه خالقه من عقل وفطرة إنسانية، ومما أنتجت تجربته المتطورة والمتنامية اطّرادا متواصلا، ومما أنتجه الإنسان مما علّمه الله، بإيداع ملكات هذا الإنتاج الرائع، متمثلا خالقه، من مدارس أخلاقية، وفلسفات فكرية، وعلوم تجريبية، ليواصل الإنسان كدحه نحو المطلق، وما هو ببالغ المطلق، بل كادح نحوه تكامليا، دون بلوغ منتهى الكمال، الذي لا يكون إلا له سبحانه، ولا يكون إلا مثلا أعلى في عالم التجريد، يتطلع الإنسان إلى الاقتراب منه، واعيا استحالة بلوغه، مدركا إمكان الكدح نحوه، وواعيا لمسؤوليته في السعي من أجل ذلك، كل بمقدار وعيه لهذه الحقيقة، ويكون معذورا عند ربه بمقدار انخفاض أو غياب هذا الوعي.
 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل