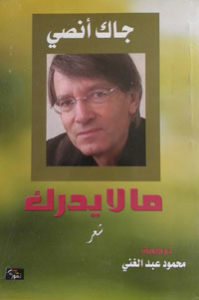السيمر / الأربعاء 30 . 08 . 2017
جاسم العايف
الشاعر والباحث والمترجم ، المغربي ، محمود عبد الغني ، سبق أن تُرجمت أشعاره إلى لغات عالمية منها، الفرنسية والاسبانية، وغيرهما،كما قدم تراجم شعرية وروائية ، من اللغتين الفرنسية والاسبانية، إلى اللغة العربية، ومنها راويات:”محمد يحبني” لألينا ريس، و”خط ساخن” للويس سبولفيدا، و”في بلاد النخيل القصير” لأندريه جيد، و” الاحتلال الأمريكي” لباسكال كينغارد،و” يوميات حرب الشرق” لجيل كيبل. وفي الشعر ترجم إلى اللغة العربية عدداً من الأعمال الشعرية منها:”مثل قصر مفكك” لليونيل راي،و “في قلب العالم” لبليز ساندارس، و “ما لا يُـدرك” للشاعر الفرنسي “جاك أنصي”، وهي المرة الأولى التي يُـقدم فيها ” أنصي” إلى اللغة العربية في مجموعة شعرية*. محمود عبد الغني يعمل أستاذاً جامعياً للأدب الحديث، في المغرب ، في تقديمه لـ”ما لا يُـدرك” يذكر: أن الشاعر الفرنسي” جاك أنصي” مرّ في عام 2000 بمدينة الرباط كـ”الشهاب”، عندما استضافه “مركز حوار الثقافات”،والشاعر “محمد بنيس” هو مَنْ أشار عليه بالإنصات، وسبق لـ” بنيس” أن ترجم عام 1996 لـ” أنصي” كتاب “الغرفة الفارغة”. يذهب ” عبد الغني” إلى تسجيل انطباعاته بعد (10) سنوات على تلك الليلة، فيؤكد أن: الشاعر”أنـصي كان يعزف على قيثارة وينشد قصائده بصوت خفيض، الصنعة التي لا يخبرها ولا يجيدها إلا الذين يخبرون عما يحدث في الروح”. تلك الروح المسكونة بهاجس الشعر.. الشعر الذي لا يخضع للتعريف. أما لقاء “محمود عبد الغني” الثاني بـ “أنـصي” فكان بمراكش، سنة 2010، إذ اقترب أكثر من “جاك ” المترجم المحترف من اللغة الاسبانية إلى الفرنسية، وبين حارات ودروب مراكش تحدثا عن أشياء كثيرة،أهمها الشعر الفرنسي الراهن، والترجمات الأدبية، والشعرية بالذات، وهي واحدة من اعقد القضايا والأمور الأدبية، ومن خلال تلك الحوارات المتواصلة “انفتحت المغارة المغلقة بسحر كلمات قليلة من شاعر ومترجم لم ينل حظه الكافي من الشهرة والتعريف به في العالم العربي”؟!. “جاك أنصي” ولد في مدينة ” ليون” 1942،و نشر أكثر من خمسة عشر عملاً أدبياً، بين رواية، ومجموعات شعرية،ويوميات،وتراجم، وحصل عام 1992 على جائزة “نيلي” عن ترجماته، وجائزة ” الرون- الألب للكتاب” 1992 عن مجمل أعماله المنشورة، كما حاز على جائزة الشعر- شارل فيدراك- عام 2006، ومنحة الترجمة عام 2006، و يعيش في مدينة ” أنيسي” التي تبعد عن “باريس”540 كم،ومتفرغ للكتابة والترجمة. يرى “جاك أنصي” في كتابه” صمت،جسد، طريق” 1996:” أن تكتب يعني أن تكون مخترقاً”، مؤكدا أن الشاعر- المترجم، مخترق بكل الأصوات التي مصدرها ثنائية، الذات – العالم، وهذا ما يثيره فيه كل الشعراء الذين قرأهم طوال سنوات،،وصمم على ترجمة قصائد وأعمال بعضهم، إلى اللغة الفرنسية،ومنهم: غامونيدا، فالانتي،لويس سارنودا،فيسانتي اليكسادري، رامون غوميز دي لا سيرنا..وغيرهم. وبذا امتلك الكثير من الأسرار الشعرية-الجمالية، التي باتت عبرها قصائده “نصوصاً صعبةً..فهي قصيدة الحدود التي كتبت لتقود القارئ إلى حدود الكائن ، بموجب ما كتبته عنها الناقدة الفرنسية ( هيلين سوريس):
هناك أيضاً في العتمة،
نبحث: وجه، يدان،
نسقط دون سقوط ،
ننادي، نغرق في الصمت.
في الفم، يوجد طعم
الدم، وما يشبه الدوار،
في مركز الجسد..هو هذا
ربما، ذلك التحرك،
ذلك النوع من بخار
الصور التي لا نرى.
يبدو ( جاك أنصي) في قصائده، من خلال الجمل المكثفة، القصيرة، والاستعارات المألوفة له، وليس لغيره، في هيئة شاعر يشغله إلى حد كبير، البحث عن اليومي، الذي يريد الاستحواذ عليه في الحياة، ثم يستثمره، بعد امتلاكه، والابتعاد عنه وأدواته، فاليومي هو ما لا تتوفر لنا رؤيته، وهو ذلك الذي لا يمكن أن نحدد معناه بسبب التصاقنا به:
في منتصف النهار، ساحة
فارغة بعصفور واحد،
وسط برك الشمس،
والظلال التي تتحرك قليلاً،
لا نعرف هل ذلك،
يأتي أم يذهب؟.
يشبه..كرسياً منسياً هنالك،
من اجل لا أحد،
نفس محبوس،
أصوات جد بعيدة،
.حتى أننا لا نستطيع فهمها
قصائد أنصي في “مالا يُـدرك”، غير معنونة،و صغيرة إلى الحد الذي يخيل إلينا أنها لا ترى، وميزتها، وفي ذات الوقت صعوبتها، في أنها غالباً تزوغ من المعنى:
كل كلمة تقول ضدها،
ليس المعنى الخاطئ،
بل معنى،
يضيع بعد المعنى،
لنرى نغمض العيون:
الحجر صلب مثل حجرة،
الليل يخدع النهار،
لا نعثر أبداً على يديه.
وكما يؤكد مترجمها:”أنها تشبه شاعرها الصامت، المتحفظ، لكن الذي يرتجف لأدنى نفس يهب من جهة الحياة”:
في الصيف، ربما ضجيج
الذباب في الثانية،
مع الزمن في العيون،
جامد، كأنه توقف.
نرى ضوءاً، طفولة،
أو شيئاً قادماً،
من العدم، يتنفس، يعبر
الجدران، الأشجار، الأجساد،
ريح عظيمة،
ولا شيء يتحرك.
في “ما لا يُـدرك”،يراودنا البحث مع التعطش لمعرفة الشاعر “جاك أنصي” الذي يؤكد أن القصيدة بالنسبة إليه: هي الصوت الذي يحدثه العالم عندما أتكلم. ويضيف: لم يعد الأدب هو – الكلام – مع المسافة التي يفرضها السرد، الوصف أو التعبير، بل أصبحت هي الوجود، لم نعد أمام أو جنب: إننا في الداخل، في جلد الآخر، فنكتشف جلدنا:
رغم أننا نسقط ،
عندما يفككنا الزمن ،
فإن ذلك إشارة ،
أقل أحياناً ،
كلمة لم تنطق جيداً ،
إنه أنت، من بعيد،
آتياً من الشمس،
أحسب الخطى، التي تفصلنا،
أرى ما لن يحدث،
هنا ما لا يدرك يحترق.
ما لا يُـدرك هي الكلمات، الأشياء،الزائغة، وهي إصغاؤنا لدوي الحياة، وإنصاتنا لألفة كائن غير مرئي يتجسد في الشعر..الشعر الذي هو” فن التذكر، وفن النسيان” في آن واحدٍ، والقصيدة كما يردد ( جاك أنصي):” هي ذلك الانتظار الدائم على حافة الصمت، إلى أن يأتي، في الأخير، ما لم نكن ننتظره، ولا نعرف ماهيته”. لعل الأضواء لن تفيدنا في أن نتعرف عليه، قد تكون تلك الظلال الواضحة، وان عن بعد، تجعلنا نلمس نفعها في التعرف على ما لا يُـدرك،ربما الزوابع هي الضيف الوافد؟.لا ننشغل في ذلك، لأننا سنرى أبعد كثيراً من تلك اللحظات العابرة، الدائمة في الهروب بعيداً:
لا شيء أيضاً،
لا شيء قبلاً،
انه غير مدرك تقريباً،
خيط النار،
لقاء اللحظة واللمعان،
انبهار أسود، ولا شيء،
الزبد، الرمل.
في “ما لا يُـدرك”.. يكمن ذلك الشاعر، بغض النظر عن اسمه ومكانه وزمنه ، والذي يثيره جداً، ويشغله دائماً، التمييز بين الحقيقة والواقع، الحقيقة التي ليست غير وصف لهذا العالم الذي يفرضه علينا((المجتمع)) الذي نحن في قلبه،عن طريق اللغة التي نتفاهم ونحلم بها.. أما وجودنا في الواقع فهو ما ينأى عنها، ويتجاوزها، وفي ذات الوقت يؤسسها اللانهائي الراقد في الأعماق.
* إصدارات اتحاد الأدباء والكتاب – البصرة – 2011 – دمشق.
 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل