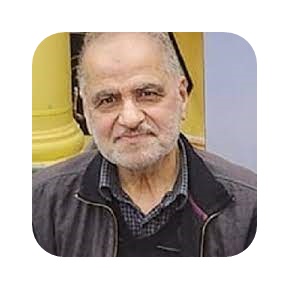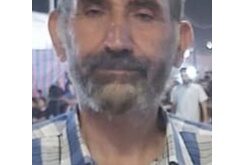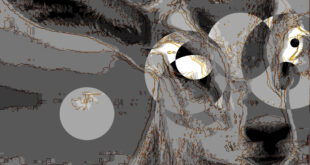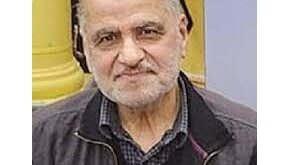فيينا / الأثنين 24 . 11 . 03 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
د. فاضل حسن شريف
جاء في موقع مركز تراث البصرة عن جامع ومقام الامير عليه السلام: التولية وأئمّة الجماعة: أمّا عن تولية المقام، فنذكر السيد (باقر السيد حسن الحكيم) رحمه الله، فقد تولّى إدارة شؤون المقام والصلاة فيه عام (1343هـ)، بعد أن أرسلته المرجعيّة الدينيّة في النجف الأشرف لحلِّ نِزاعٍ نَشب بين عشيرتين في البصرة، فبقي فيها بعد طلب أهاليها وموافقة المرجعيّة، وبعد وفاته، أصبح السيد (محمد سعيد الحكيم) متولياً للمقام، وكان خطيباً وإماماً للصلاة من سنة (1352هـ) إلى سنة (1386هـ)، وهي سنة وفاته، فخلفه نجله السيد (أحمد الحكيم)، فكان المتولي من سنة (1386هـ) إلى غاية سنة (1406هـ)، وبعده آلت التولية إلى السيد (محمد حسن الحكيم)، فكان خطيب جامع المقام وإمام الصلاة فيه، وهو الذي قام بتوسيع الجامع وتجديده، وبعد وفاته، خلفه السيد (محمد صادق الحكيم) من عام (1426هـ) وإلى غاية وفاته عام (1435هـ). الأنشطة: لجامع المقام اليوم أنشطة كثيرة متعدّدة، منها: إقامة صلاة الجماعة يوميّاً، واستقبال زوّار المقام بشكل يوميّ ومنتظم، من الصباح الباكر وحتى المساء، كما تبنّى المقام بين فترة وأخرى إقامة دورات تعليمية مختلفة، منها: دورات قرآنية تهتم بعلوم القرآن وتلاوته وحفظه، استقطبت عدداً من المهتمين بهذا المجال من الأطفال والشباب، فضلاً عن إحياء المناسبات الدينيّة بمواعيدها المحدّدة، وعقد محافل لقراءة الأدعيّة الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، خصوصاً في شهري: محرّم الحرام وصفر الخير، وقد توالى على جامع المقام عدد من الخطباء البارزين، كما يُقام فيه تشييعٌ رمزيٌ سنويٌ في ذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام، كما أن هناك النشرة الشهريّة التي يصدرها الجامع للتوعية الدينيّة بعنوان: (أنوار المقام)، استمرت في الصدور إلى أكثر من سنة، وللجامع لجنة ثقافيّة تتحمّل الكثير من العبء في إقامة هذه الأنشطة وغيرها. ويبقى جامع المقام مصدراً للعطاء الديني والفكري والثقافي، وواحداً من منارات الهدى في البصرة، عامراً بذكر الله، فواحا بعطر الإيمان، وعنواناً للتراث البصري الأصيل الذي يحقّ لنا أن نفخر به.
عن تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله تعالى “إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَـٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ” ﴿التوبة 18﴾ “إنما يعمر مساجد الله” ولفظة إنما لإثبات المذكور، ونفي ما عداه، فمعناه: لا يعمر مساجد الله بزيارتها، وإقامة العبادات فيها، أو ببنائها ورم المسترم منها إلا “من آمن بالله واليوم الآخر” أي: من أقر بوحدانية الله، واعترف بالقيامة، “وأقام الصلاة” بحدودها، “وآتى الزكاة” أي: أعطاها إن وجبت عليه إلى مستحقها، “ولم يخش إلا الله” أي: لم يخف سوى الله أحدا من المخلوقين، وهذا راجع إلى قوله “أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه” أي: إن خشيتموهم فقد ساويتموهم في الإشراك، كما قال: “فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله” الآية “فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين” إلى الجنة، ونيل ثوابها، لأن عسى من الله واجبة، عن ابن عباس، والحسن، وفي ذكر الصلاة، والزكاة، وغير ذلك، بعد ذكر الإيمان بالله، دلالة على أن الإيمان لا يتناول أفعال الجوارح، إذ لو تناولها لما جاز عطف ما دخل فيه عليه. ومن قال. إن المراد فيه التفصيل، وزيادة البيان، فقد ترك الظاهر.
جاء في موقع عريق عن مسجد القطانة من مساجد البصرة القديمة، وهو من مساجد العراق التراثية التي بنيت في عهد الدولة العثمانية، ويقع في محلة القطانة في سوق الصفات، قريبا من جامع البصرة الكبير خلف مبنى عمارة الحيدراني. بني حرم المسجد من الطابوق وسقفه عكادة ويمتاز بأقواس في جميع أجزائه وتقام فيه الصلوات الخمس، وقامت وزارة الأوقاف العراقية بترميمه عام 1384هـ/1964م، وبما لم يؤثر على تراثهِ ومحافظاً على بنيانهِ القديم. ويحتوي الجامع على حرم مصلى بطول 15 متراً وبعرض خمسة أمتار، وفيه محفل تراثي قديم للقراء مصنوع من الخشب الصاج، وتحيط الحرم سبعة شبابيك خشبية قديمة يعود تأريخها للعهد العثماني، وللحرم محراب بني من الطابوق، وقبالة الحرم طارمة بعرض الحرم وبطول ثلاثة أمتار، وبجوار الحرم غرفة للإمام والخطيب، وأشهر من تولى منصب الإمامة والخطابة فيه الشيخ محمود عبد العزيز.
جاء في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: الآية التّالية فتذكر شروط عمارة المسجد الحرام إكمالا للحديث آنف الذكر فتبيّن خمسة شروط مهمّة في هذا الصدد، فتقول،”إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ” (التوبة 18). و هذا النص إشارة إلى الشرطين الأوّل و الثّاني، اللذين يمثلان الأساس العقائدي، فما لم يتوفر هذان الشرطان لا يصدر من الإنسان أي عمل خالص نزيه، بل لو كان عمله في الظاهر سليما فهو في الباطن ملّوث بأنواع الأغراض غير المشروعة. ثمّ تشير الآية إلى الشرطين الثّالث و الرّابع فتقول: “وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَى الزَّكاة ” (التوبة 18). أي أن الإيمان باللّه و اليوم الآخر لا يكفي أن يكون مجرّد ادعاء فحسب، بل تؤيده الأعمال الكريمة، فعلاقة الإنسان باللّه ينبغي أن تكون قوية محكمة، و أن يؤدي صلاته بإخلاص، كما ينبغي أن تكون علاقته بعباد اللّه و خلقه قوية، فيؤدي الزكاة إليهم. قوله تعالى ” أَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ جاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ” (التوبة 19) و يحدثنا التأريخ أنّ منصب (سقاية الحاج) قبل الإسلام كان من أهل المناصب، و كان يضاهي منصب سدانة الكعبة، و كانت حاجة الحاج الماسة في أيّام الحج إلى الماء في تلك الأرض القاحلة اليابسة المرمضة التي يقل فيها الماء، و جوّها حار أغلب أيّام السنة، و كانت هذه الحاجة الماسة تولي موضوع (سقاية الحاج) أهميّة خاصّة، و من كان مشرفا على السقاية كان يتمتع بمنزلة اجتماعية نادرة، لأنّه كان يقدم للحاج خدمة حياتية. و كذلك (عمارة المسجد الحرام) أو سدانته و رعايته، كان لها أهميته الخاصّة، لأنّ المسجد الحرام حتى في زمن الجاهلية كان يعدّ مركزا دينيا، فكان المتصدي لعمارة المسجد أو سدانته محترما. و مع كل ذلك فإنّ القرآن يصّرح بأنّ الإيمان باللّه و باليوم الآخر و الجهاد في سبيل اللّه أفضل من جميع تلك الأعمال و أشرف.
جاء في موقع مركز تراث البصرة عن جامع الفقير: يُعدُّ جامع الفقير من المساجد التاريخيّة المهمة في محافظة البصرة، والكائن في مركز المحافظة، منطقة البصرة القديمة، وهو بناءٌ قديمٌ يعودُ تأريخه إلى حدود المائة وعشرين سنة تقريباً، إذ توجد وثائقُ للمسجد يعودُ تأريخها إلى عام 1928م، علماً أنّه كان مُشيّداً قبل هذا التأريخ. تحفةٌ معماريّة: يُعدُّ هذا المسجد تُحفَة أثريّة بارزة في مدينة البصرة، كانت تعلوه منارةٌ متوسطة الارتفاع مبنيّة من الطابوق الأصفر، محاطة بحزام أخضر، وأربع سمّاعات متوجّهة إلى الجهات الأربع، يعلوها تشكيلٌ للفظ الجلالة صُنعَ بشكلٍ زُخرفيٍّ جميل، والداخل إليه يمرُّ من بابه الخشبي الكبير الذي زخرف بالنقوش الإسلاميّة، ويليه صحنُ المسجد وقد أُحيط بجدران مهدّمة في بعض الجوانب، وتتوسّط هذا الصّحن باحة المسجد، ويستقرُّ حرم المسجد على مساحةٍ كبيرةٍ. بابه من الحديد، وعند الدخول إلى الحرم يستقبلُ الداخلُ محرابَ الصلاة، وقد صُمِّم بطرازٍ إسلاميٍّ رائع، واستقرَّ في أحد جوانبه منبرٌ خشبيٌّ نُقشت عليه بعضُ النقوش، وممّا يُلفت النظر فيه ساعةٌ جداريةٌ قديمة استقرّت فوق محرابِ المسجد جُعلت وقفاً عام 1962م. زمن التأسيس والمراحل العمرانية للمسجد: أُسّس المسجد على يدِ الحاج محمد علي فقير ــ أحد تجّار الهِند الذين قدِموا البصرة ـــ بسبب نذر وفى به بعد أن شفاه الله من مرضٍ أصابه، فبنى هذا المسجد، ونسبت تسمية المسجد إليه، فكان المسجد بعد ذلك مهوى القلوب، ومكانَ العبادة والصَّلاة، ومركزَ الإشعاع الفكري، يرتادُه الناس على اختلاف طبقاتِهم وأعمارهم، وكان له الدورُ الكبير في نشر العلوم الثقافية والدينيّة والفقهيّة في المنطقة، كما تخرّج من أحضانه كثيراً من قرّاء القرآن الكريم وحفّاظه، حتى أنَّ البعض كان يروق له أن يسمِّيَه (جامع الفقيه)، لكثرةِ ما احتضَنَ مِن حلقاتٍ للذكر والعلم والمعرفة، ولكثير مَن صلّى فيه من الفقهاء والأعلام. كان المسجد بمنزلة محطّةٍ لاستراحة بعض التجّار والوافدين من بلاد الهند لزيارة العتبات المقدّسة، إذ كان عددٌ من الهنود القادمين إلى البصرة عن طريق البحر ينزلون الجامع للراحة فيه عدّة أيّامٍ، ثمَّ ينطلقون لأداء مراسيم الزيارة، وينزلون به مرّة أُخرى عند عودتهم. مرّ المسجد بمراحل عمرانيّة متعدّدة، إذ كان بناؤه من الطّين والخشب وأعمدة الصّندل. عُمِّر عدّة مرّات منها في عام1995م على نفقة أحد المؤمنين، ثمّ ألحق به بناءٌ جديدٌ جُعل داراً للضِّيافة، تقام به بعض المناسبات الاجتماعيّة، وأُعيد بناؤه عام 2014م بطرازٍ حديث ومن طابقين، وأُضيفت له عدّة قاعات واسعة، وكل ذلك من تبرعات الإخوة المؤمنين، وخصوصاً من آل المازنيّ، وبإشراف من السيد ثامر الموسوي إمام الجامع ومتوليه، وبنيت له منارة بارتفاع 27م على يد البنّاء السيّد عليّ الحليّ.
أُقيمت في المسجد الكثير من الأنشطة الدينيّة والثقافيّة والندوات الفكرية، كصلاة الجماعة، وذكر مصائب أهل البيت وولاداتهم المباركة، والمحاضرات الثقافيّة، وبعض الدروس الحوزويّة في الفقه والعقائد والقرآن، و تستمرُّ طيلة أيّام العام، فقد ارتاده الكثير من الشخصيات العُلمائيّة أمثال الفقيه الراحل السيّد أمير محمّد القزويني (طيّب الله ثراه)المدفون بضريح فاطمة المعصومة بقم المقدسة ، والسيّد عبّاس شبّر القاضي ونجله الشهيد السيّد عصام شبّر، والسيّد عبدالله خليفة الموسوي المدفون في الروضة العلويّة المقدّسة، والشيخ عبد الرضا الجزائري، والسيِّد حسين الشامي الكربلائي، والرادود الشيخ محمّد باقر الأيرواني، والسيِّد شمس الدّين قدس سرهما، والشيخ يوسف الدكسن وآخرين. أبرز الخطباء والوجهاء والمؤذنين والخدم: ومن أبرز الخُطباء الذين خَدموا المِنبر الحسيني في هذا المسجد، السيّد جواد شبّر، والشهيد الشيخ عبد الأمير المنصوري، والسيِّد حسين الشامي الكربلائي، والرادود الحسيني عبد الرضا النجفي، والشيخ عبد الحافظ البغدادي، أما مَن ارتفع صوته بالأذان وصدحت حنجرته من منارته فهم كثر، أبرزهم الحاج كرم المتوفي عام 1965م وبعده جاء الحاج (خدا بخش) الإيراني، وكان لبعض الوجهاء والشخصيات حضور فاعل ومؤثر في المسجد أمثال السيّد مضر الحلو والأُستاذ الحاج محمّد ياسر، والأُستاذ الحاج عبد الأمير دهراب، والملّا مهدي نوح الربيعي، وأبو زينب المؤذِّن، والأخ حامد ذياب ساجت والملّا حسين البصير المتوفى عام 2003م، وآخرين. موكب المسجد: وكان قد أُسِّس فيه موكبٌ للخدمة الحسينيّة قبل موكب الوحدة الذي أسَّسه السيِّد أمير محمّد القزويني في البصرة عام 1950م، وقد انضم موكب الخدمة إلى موكب الوحدة في هذا التاريخ، وفي عام 1963م افتُتحت فيه مكتبة عامّةٌ للسيِّد الحكيم. وفي عام 1970م أُسِّس للمسجدِ موكبٌ خاصٌّ باسم موكب الشهداء، أسَّسه السيِّد حسن القزويني نجل العلامة الراحل السيد أمير محمّد القزويني ، وقد قدّم هذا الموكب خيرة الشباب قرابين شهداء لإدامة الشعائر الحسينية واستمرارها في زمنٍ تكالبت فيه أجهزة السلطة على محو هذه الشعيرة وإخماد الصّوت الحسينيّ الثائر، حتى سُمّي بمسجدِ الشّهداء لكثرةِ ما قدَّم مِنَ الشّهداء. احداث جرت على المسجد: مرّ المسجد بمراحل عصيبة في تأريخه، ففي عام 1979م أُغلِق نتيجة للظروف الأمنيّة التي مرّت بها البلاد آنذاك، وفي عام 1981م تم افتتاح المسجد بعد مجيء ملّا حسين البصير من الكويت، الذي أقام الصلاة فيه، وفي بداية التسعينيّات هُجر المسجد تماماً بسبب الظروف السياسيّة والأمنيّة بعد الانتفاضة الشعبانيّة، التي على أثرها ضيّق النظام على المصلِّين فيه، وفي عام 1999م أُغلِق تماماً حتّى عام 2003م، وخلال تلك الفترة التي أُغلق فيها المسجد تعرّض للسّرقة والعبث بأثاثِه، وعاش الآم البصريين، وشمله ما أصابهم. خاتمة: أما اليوم فإنَّ مسجدَ الفقيرِ عامرٌ بندائِهِ وصلاته ومحاضراته ويشكِّلُ ذاكرةً وتراثاً لمدينة البصرة، وإنَّ زائرهُ يستنشق عبقَ الماضي وذكرياتِه، وتنتابُه حالةٌ من الرُّوحانيّة، خصوصاً عندما يَعلم بعدد الأعلام والفقهاء الذين جاءوا ووَطِئت أقدامهم تراب هذا المسجد المبارك.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
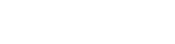 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل