فيينا / الخميس 15 . 05 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
في مدينة الحلة، حيث يجاور الفرات بساتين التمر، ولد الدكتور علي إبراهيم عام 1950، فكان مولده وعدًا مبكرًا لحضور فكريّ مميز،
منذ أطروحته الجامعية التي ناقشها في جامعة صوفيا البلغارية، والموسومة بـ(الزمان والمكان في روايات غائب طعمة فرمان)، والتي نال عنها شهادة الدكتوراه بامتياز، وضع علي إبراهيم نفسه في مسار نقدي ينتمي إلى ما يمكن تسميته بـ”نقد الداخل الروائي”، حيث تُقارب النصوص لا من خارجها الأكاديمي فقط، بل من داخلها الإنساني والثقافي، باحثًا عن نبض الشخوص، وجغرافيا الألم، وزمن القهر أو الحلم.
لقد جعل من أعمال غائب طعمة فرمان، وهي أعمال مثقلة بالهجرة والحيرة والانكسار، مرآة لفهم سرديات المنفى العراقي، وراح يستخلص منها أدواته النقدية التي توسعت لاحقًا لتشمل القصة القصيرة والرواية والشعر، وترك بصمته في مجلات متخصصة عراقية وعربية وأوروبية.
ولا تنفصل الرؤية النقدية عند الدكتور علي إبراهيم عن تجربة المنفى التي عاشها، فهو لم يكتف بكتابة النصوص، بل ساهم في صياغة المنفى ذاته كموضوع نقدي. لقد انتقل من الحلة إلى بغداد، ومن بغداد إلى صوفيا، ومن هناك إلى هولندا، حاملاً همَّ الكتابة والمعنى، وحاضرًا في المنصات الثقافية من بيروت إلى برلين، ومن السليمانية إلى لاهاي.
كتب عن القص العراقي الذي “ابتعد عن سماواته”، مشيرًا إلى الضياع الإبداعي الذي أصاب النص العراقي بفعل التحولات السياسية والاجتماعية، وقدم كتابات صافية عن تجربته الشخصية كقارئ ومثقف وناقد، كانت أشبه بسيرة نقدية تتقاطع فيها الذات مع النص، والتاريخ مع اللحظة الجمالية.
تميّز الدكتور علي إبراهيم بموقف نقدي لا ينحاز إلا للنص ذاته، رافضًا التهويل أو المحاباة. يشتغل على تفاصيل السرد كما يشتغل الفلاح على الأرض، بصبر وانتباه، ويكشف عن بنيات متوارية خلف سطح الحكاية. ولعل أبرز ما يميّز رؤيته هو الحس التأويلي العالي، الذي لا يقف عند ظاهر البنية بل يتوغل في دلالاتها، عابرًا من المكان الواقعي إلى الزمكان النصي، ومن الحكاية إلى التاريخ السردي.
كما أن مشاركته في ثقافة الأنصار، وفي مجلات اليسار الفلسطيني والعراقي، مثل فلسطين الثورة والهدف والشغيلة، كشفت عن توازن نادر بين الالتزام السياسي والوعي الجمالي، فلم تكن نصوصه محض انعكاس أيديولوجي، بل محاولة حقيقية لفهم الواقع السردي ضمن تشابك مع الواقع السياسي.
في قاعات جامعة بابل، وجامعة السليمانية، وفي قاعات جامعات أوروبا، كان الدكتور علي إبراهيم يُدَرِّس النقد الأدبي لا كمادة جامدة، بل ككائن حي يتنفس من النص ويعود إليه. أشرف على عشرات الرسائل الجامعية، وشارك في لجان علمية، وفتح آفاقًا جديدة لدراسات عليا في جامعات الناصرية وواسط.
ترقى إلى درجة الأستاذية عام 2011، وواصل عمله الأكاديمي حتى بعد تقاعده، فاختير أستاذًا متمرسًا في كلية التربية، ليبقى على تماس حيٍّ مع جيل جديد من الباحثين الذين تلقوا على يديه أدوات النقد وآفاقه.
أصدر مجموعة من الكتب التي أثارت اهتمام النقاد، منها: القص العراقي بعيدًا عن سماواته، وهو محاولة جريئة لتفكيك المسكوت عنه في السرد العراقي، قصص الرواية، الذي يمزج فيه النقد بالإبداع، كتابات عن تجربتي، سيرة فكرية في هيئة مقالات نقدية، تكثيف المعنى الشعري، كتاب يكشف عن حساسيته تجاه اللغة وقوة الانزياح فيها، ولم يغب الشعر عن حقل اشتغاله، فقد تعمق في تحليل البنية الشعرية أيضًا، وظل وفيًّا لقضية المعنى ومركزية الإنسان في النصوص.
لم يكن حضور الدكتور علي إبراهيم في المشهد النقدي العراقي مجرد وجود وظيفي، بل كان حضورًا مميزًا وفاعلاً، تُرجم في الندوات، والمؤتمرات، والدراسات التي كُتبت عنه. عشرات النقاد، من أمثال ناجح المعموري، جاسم المطير، قيس حمزة الخفاجي، عدنان حسين أحمد، وغيرهم، احتفوا بتجربته، ووقفوا أمام اجتهاده النقدي بإجلال، لأنه يمثل الجيل الذي كتب عن الرواية وهو يقرأها بضمير الإنسان، لا بحبر النظرية فقط.
وفي زمن كثرت فيه الأصوات وقلَّت الرؤى، يظل الدكتور علي إبراهيم أحد الأعمدة الهادئة في النقد العربي الحديث، لا يُضجّر القارئ بكثرة المصطلحات، بل يُضيء له الطريق إلى فهم النص في مرآته الزمانية والمكانية والإنسانية. هو ابن الحلة، ونزيل المنفى، ورفيق السرد، وحارس المعنى، الذي كتب بوعي النقد، ومرارة المنفى، وصدق المثقف الباحث عن نور في أزمنة الظلمة.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
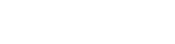 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل


