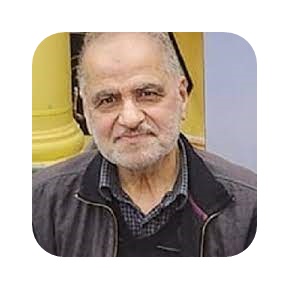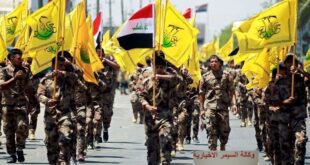فيينا / الخميس 27 . 06 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
د. فاضل حسن شريف
جاء في کتاب الميزان في تفسير القرآن للعلامة الطباطبائي: وقد عرفت ما تدل عليه الآية، وأن الذي نقلناه من الأخبار المتكثرة المتظافرة هو الذي يطابق مدلول الآية، وبالتأمل في ذلك يتضح وجوه الفساد في هذه الحجة المختلقة والنظر الواهي الذي لا يرجع إلى محصل، وهاك تفصيلها: منها: أن قوله: ومصادر هذه الروايات الشيعة إلى قوله: وقد اجتهدوا في ترويجها ما استطاعوا حتى راجت على كثير من أهل السنة، بعد قوله: إن الروايات متفقة، ليت شعري أي روايات يعنى بهذا القول ؟ أمراده هذه الروايات المتظافرة التي أجمعت على نقلها وعدم طرحها المحدثون، وليست بالواحدة والاثنتين والثلاث أطبق على نقلها وتلقيها بالقبول أهل الحديث، وأثبتها أرباب الجوامع في جوامعهم، ومنهم مسلم في صحيحه والترمذي في صحيحه وأيدها أهل التاريخ. ثم أطبق المفسرون على إيرادها وإيداعها في تفاسيرهم من غير اعتراض أو ارتياب، وفيهم جمع من أهل الحديث والتاريخ كالطبري وأبي الفداء بن كثير والسيوطي وغيرهم. ثم من الذي يعنيه من الشيعة المصادر لهذه الروايات؟ أيريد بهم الذين تنتهي إليهم سلاسل الأسناد في الروايات أعني سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبدالله وعبدالله بن عباس وغيرهم من الصحابة؟ أو التابعين الذين نقلوا عنهم بالأخذ والرواية كأبي صالح والكلبي والسدي والشعبي وغيرهم، وأنهم تشيعوا لنقلهم ما لا يرتضيه بهواه فهؤلاء وأمثالهم ونظرائهم هم الوسائط في نقل السنة، ومع رفضهم لا تبقى سنة مذكورة ولا سيرة مأثورة، وكيف يسع لمسلم أو باحث حتى ممن لا ينتحل بالإسلام أن يبطل السنة ثم يروم أن يطلع على تفاصيل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تعليم وتشريع والقرآن ناطق بحجية قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته، وناطق ببقاء الدين على حيوته، ولو جاز بطلان السنة من رأس لم يبق للقرآن أثر ولا لإنزاله ثمر. أو أنه يريد أن الشيعة دسوا هذه الأحاديث في جوامع الحديث وكتب التاريخ، فيعود محذور سقوط السنة، وبطلان الشريعة بل يكون البلوى أعم والفساد أتم. ومنها: قوله: ويحملون كلمة نسائنا على فاطمة، وكلمة أنفسنا على عليّ فقط، مراده به أنهم يقولون بأن كلمة نسائنا أطلقت واريدت بها فاطمة وكذا المراد بكلمة أنفسنا عليّ فقط، وكأنه فهمه مما يشتمل عليه بعض الروايات السابقة: قال جابر: نسائنا فاطمة وأنفسنا علي الخبر، وقد أساء الفهم فليس المراد في الآية بلفظ نسائنا فاطمة، وبلفظ أنفسنا علي بل المراد أنه صلى الله عليه وآله وسلم إذ لم يأت في مقام الامتثال إلا بها وبه كشف ذلك أنها هي المصداق الفرد لنسائنا، وأنه هو المصداق الوحيد لأنفسنا وأنهما مصداق أبنائنا، وكان المراد بالأبناء والنساء والأنفس في الآية هو الأهل فهم أهل بيت رسول الله وخاصته كما ورد في بعض الروايات بعد ذكر إتيانه صلى الله عليه وآله وسلم بهم أنه قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فإن معنى الجملة: أني لم أجد من أدعوه غير هؤلاء.
يقول السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سره في تفسيره لآية المباهلة: عن لفظ المفرد والجمع: ويدل على ما ذكرناه من المراد ما وقع في بعض الروايات: أنفسنا وأنفسكم رسول الله وعلي، فإن اللفظ صريح في أن المقصود بيان المصداق دون معنى اللفظ. ومنها: قوله: ولكن واضعيها لم يحسنوا تطبيقها على الآية فإن كلمة نسائنا لا يقولها العربي ويريد بها بنته لا سيما إذا كان له أزواج ولا يفهم هذا من لغتهم، وأبعد من ذلك أن يراد بأنفسنا علي، وهذا المعنى العجيب الذي توهمه هو الذي أوجب أن يطرح هذه الروايات على كثرتها ثم يطعن على رواتها وكل من تلقاها بالقبول، ويرميهم بما ذكره وقد كان من الواجب عليه أن يتنبه لموقفه من تفسير الكتاب، ويذكر هؤلاء الجم الغفير من أئمة البلاغة وأساتيذ البيان، وقد أوردوها في تفسيرهم وسائر مؤلفاتهم من غير أي تردد أو اعتراض. فهذا صاحب الكشاف وهو الذي ربما خطأ أئمة القراءة في قراءتهم يقول في ذيل تفسير الآية: وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء عليهم السلام وفيه برهان واضح على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لم يرو أحد من موافق ولا مخالف: أنهم أجابوا إلى ذلك، انتهى. فكيف خفي على هؤلاء العظماء أبطال البلاغة وفرسان الأدب أن هذه الأخبار على كثرتها وتكررها في جوامع الحديث تنسب إلى القرآن أنه يغلط في بيانه فيطلق النساء (وهو جمع) في مورد نفس واحدة؟ لا وعمري، وإنما التبس الأمر على هذا القائل واشتبه عنده المفهوم بالمصداق فتوهم أن الله عز اسمه لو قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: “فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ” (آل عمران 61) (الخ) وصح أن المحاجين عند نزول الآية وفد نجران وهم أربعة عشر رجلاً على ما في بعض الروايات ليس عندهم نساء ولا أبناء، وصح أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى مباهلتهم وليس معه إلا علي وفاطمة والحسنان كان لازم ذلك أن معنى من حاج وفد نجران، ومعنى نسائنا المرأة الواحدة ومعنى أنفسنا النفس الواحدة، وبقي نسائكم وأبنائكم لا معنى لهما إذ لم يكن مع الوفد نساء ولا أبناء. وكان عليه أن يضيف إلى ذلك لزوم استعمال الأبناء وهو جمع في التثنية وهو أشنع من استعمال الجمع في المفرد فإن استعمال الجمع في المفرد ربما وجد في كلام المولدين وإن لم يوجد في العربية الأصيلة إلا في التكلم لغرض التعظيم لكن استعمال الجمع في المثنى مما لا مجوز له أصلاً. فهذا هو الذي دعاه إلى طرح الروايات ورميها بالوضع، وليس الأمر كما توهمه.
وعن بلاغة آية المباهلة يقول العلامة السيد الطباطبائي قدس سره: توضيح ذلك أن الكلام البليغ إنما يتبع فيه ما يقتضيه المقام من كشف ما يهم كشفه فربما كان المقام مقام التخاطب بين متخاطبين أو قبيلين ينكر أو يجهل كل منهما حال صاحبه فيوضع الكلام على ما يقتضيه الطبع والعادة فيؤتى في التعبير بما يناسب ذلك فأحد القبيلين المتخاصمين إذا أراد أن يخبر صاحبه أن الخصومة والدفاع قائمة بجميع أشخاص قبيله من ذكور واناث وصغير وكبير فإنما يقول: نخاصمكم أو نقاتلكم بالرجال والظعائن والأولاد فيضع الكلام على ما تقتضيه الطبع والعادة فإن العادة تقتضي أن يكون للقبيل من الناس نساء وأولاد والغرض متعلق بأن يبين للخصم أنهم يد واحدة على من يخاصمهم ويخاصمونه، ولو قيل: نخاصمكم أو نقاتلكم بالرجال والنساء والبنين لنا كان إخباراً بأمر زائد على مقتضى المقام محتاجاً إلى عناية زائدة وتعرفاً إلى الخصم لنكتة زائدة. وأما عند المتعارفين والأصدقاء والأخلة فربما يوضع الكلام على مقتضى الطبع والعادة فيقال في الدعوة للضيافة والاحتفال: سنقرئكم بأنفسنا ونسائنا وأطفالنا، وربما يسترسل في التعرف فيقال: سنخدمكم بالرجال والبنت والسبطين الصبيين، ونحو ذلك. فللطبع والعادة وظاهر الحال حكم، ولواقع الأمر وخارج العين حكم، وربما يختلفان، فمن بنى كلامه على حكاية ما يعلم من ظاهر حاله، ويقضي به الطبع والعادة فيه ثم بدا حقيقة حاله وواقع أمره على خلاف ما حكاه من ظاهر حاله لم يكن غالطاً في كلامه، ولا كاذباً في خبره ولا لاغياً هازلاً في قوله. والآية جارية على هذا المجرى فقوله: “فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ” (آل عمران 61) (الخ) اريد به على ما تقدم: أُدعهم إلى أن تحضر أنت وخاصتك من أهلك الذين يشاركونك في الدعوى والعلم، ويحضروا بخاصتهم من أهليهم، ثم وضع الكلام على ما يعطيه ظاهر الحال أن لرسول الله في أهله رجالاً ونساءاً وأبناءاً ولهم في أهليهم رجال ونساء وأبناء فهذا مقتضى ظاهر الحال، وحكم الطبع والعادة فيه وفيهم، أما واقع الأمر وحقيقته فهو أنه لم يكن له صلى الله عليه وآله وسلم من الرجال والنساء والبنين إلا نفس وبنت وابنان، ولم يكن لهم إلا رجال من غير نساء ولا أبناء، ولذلك لما أتاهم برجل وامرأة وولدين لم يجبهوه بالتلحين والتكذيب، ولا أنهم اعتذروا عن الحضور بأنك أمرت بإحضار النساء والأبناء وليس عندنا نساء ولا أبناء، ولا أن من قصت عليه القصة رماها بالوضع والتمويه. ومن هنا يظهر فساد ما أورده بقوله: ثم وفد نجران الذين قالوا إن الآية نزلت فيهم لم يكن معهم نساء ولا أبناء. ومنها: قوله: وكل ما يفهم من الآية أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو المحاجين والمجادلين في عيسى من أهل الكتاب إلى الاجتماع رجالاً ونسائاً وأطفالاً، ويجمع هو المؤمنين رجالا ونسائاً وأطفالاً ويبتهلون إلى الله بأن يلعن الكاذب فيما يقول عن عيسى ـ إلى قوله ـ: وأنى لمن يؤمن بالله أن يرضى أن يجتمع مثل هذا الجمع من الناس المحقين والمبطلين في صعيد واحد متوجهين إلى الله تعالى في طلب لعنه وإبعاده من رحمته؟ وأي جرأة على الله واستهزاء بقدرته وعظمته أقوى من هذا؟
 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل