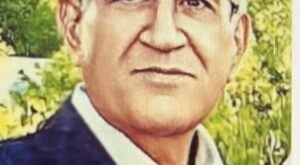فيينا / الأثنين 09. 09 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
يبدو أن كل المشروع الإنساني، يتألف من إثبات الإنسان لنفسه في كل لحظة أنه إنسان وليس غصناً
“نحن مجهولون لأنفسنا، نعلم هذا … وهناك سبب وجيه لذلك. فلم نسعَ قط إلى اكتشاف ذواتنا، فكيف ننتظر إذن أن نتعرف عليها؟” منذ أواخر القرن التاسع عشر، حينما خط نيتشه هذه الكلمات، تبدلت الأمور كثيرًا. الآن، نتأمل في ذواتنا بقلق لا يهدأ، ونسعى لاكتشافها بطرق لا تُحصى، ونبحث عن المزيد من السبل لذلك. ومن بين تلك السبل أداة نمت حولها العلوم، وأزهرت معها سبل جديدة للإيمان، وأثمرت عقائدًا. تلك الأداة هي الإستبيان، والعلم هو القياس النفسي، والإيمان هو التفاني في تصنيف الذات، وثمرته الكشف عن الشخصية.
ربما مررت بتجربة مماثلة مع هذه الظاهرة، سواء من خلال تقييم نفسي علاجي، أو تقييمات في مكان العمل، أو محاولات لتوجيهك روحياً، أو بدافع الفضول، وقد تكون وجدت فيها فائدة. أو ربما تساءلت عن مدى اهتمامنا غير العادي بالاختبارات الموحدة وأولئك الذين يديرونها لتقييم جوهر وجودنا. قد تكون شعرت بالراحة عندما اكتشفت أنك حسب اختبار 16 نوعًا من الشخصية، تنتمي لنوع ISFP؛ أو حسب الإنياجرام، أنك نوع 3 مع فرع 2 أو 4. أو ربما أزعجك كيف أصبح مصطلح “الشخصية”، المشتق من الكلمة اللاتينية “persona” (والتي تعني الأقنعة التي كان يرتديها الممثلون على المسرح)، مستودعًا للعديد من الصفات، مما يخالف القاعدة الميتافيزيقية لأرسطو التي تمنع اختزال المادة في خواصها.
في جميع الأحوال، لم تكن الذات أبدًا محط تركيز أكبر للتصنيف مما هي عليه اليوم، فبفضل تطور التحليل السلوكي، وعلم النفس العلمي، والسوسيومترية، وتصنيف الشخصية، ونظرية الشخصية على مدى قرن من الزمن. أضف إلى ذلك الأدوات النفسية التشخيصية التي تعتمد على تحسينات تحليل الانحدار المتعدد، والنمذجة المتعددة المتغيرات، وتحديد السمات من خلال البطاريات النفسية، وتغيرات نظرية التحليل النفسي. ولا ينبغي نسيان قوة التعميم التي تأتي من التصنيف الشخصي الموضوعي والتنبؤي، داخل وخارج المختبر وغرف العلاج، فمنذ أن بدأت كاثرين بريجز في تطوير ما سيصبح مؤشر مايرز بريجز لأنواع الشخصية (MBTI) في عام 1919، ستجد نفسك (مثل الكثيرين حول العالم) أمام أكثر من ألفي تقييم للشخصية يعدون بفك شفرتك، ببعض المكالمات الهاتفية، أو الإحالات النفسية، أو تقديم طلبات، أو حتى منصات على الإنترنت مجانية أو بأسعار معقولة. الفعالية المتوقعة لهذه الاختبارات أصبحت موضوع تكهناتنا الجماعية. وبحسب العديد من الآراء، فإن نتائجها تساعدنا على معرفة أنفسنا بشكل أفضل، وتتيح لنا حياة أكثر صحة ورضا. كان لدى نيتشه الكثير ليقوله، ولكنه لم يكن لديه PersonalityMax.com أو PersonalityAssessor.com.
يبدو أن ولاءنا لهذه الاختبارات بريء، حيث يعدنا علم نفس الشخصية بمساعدة الأفراد على فهم أنفسهم والآخرين بعمق أكبر، كما تشير مجلة “Psychology Today”. ولكن تحقيق هذا الوعد يعتمد على ما تسميه الجمعية الأمريكية لعلم النفس “المعرفة المتخصصة”. بالطبع، هناك نقاش حول ما يتضمنه هذا المصطلح، ولكن مسار الوصول إلى خبرة معرفو “الشخصية” مُعَبَّد بنماذج محددة.
تبدأ معظم أدوات التقييم بسلسلة من الأسئلة (عادةً ما بين عشرة إلى مئتين) تطلب من المشاركين تحديد مدى توافق أوصاف معينة للسمات معهم. على سبيل المثال، يركز استبيان “السمات الخمسة الكبرى” الشهير على الانفتاح، والاجتهاد، والانبساط، والموافقة، والاستقرار العاطفي. تُجمع الدرجات وتُقارن بمجموعة متزايدة من اتجاهات السمات. استخدام مصطلح “اختبارات” لهذه الأدوات قد يكون غير دقيق؛ “أدوات القياس” هو المصطلح الأكثر دقة، حيث يوحي بضمان الدقة القوية مثل تلك الموجودة في الأدوات الطبية. هذا المصطلح يشير إلى قوة أدوات مثل “مؤشر مينيسوتا المتعدد الأوجه للشخصية” (MMPI) أو نسخته الأحدث (MMPI-3)، و”مؤشر نِو للشخصية المعدل” (NEO PI-R)، و”مؤشر هيكساكو للشخصية المعدل” (HEXACO-PI-R)، و”مؤشر هوغان للشخصية” (HPI)، و”مؤشر مايرز بريجز لنوع الشخصية” (MBTI)، واختبارات الإنياجرام. ليست كل الأدوات تُعامل بالتساوي من قِبل علماء النفس؛ تلك التي تحمل تعديلات (“R”) تُعتبر أكثر احترامًا في الأوساط الأكاديمية.
في العالم التجاري، يظهر الحذر بشكل أقل. بحلول عام 2021، كانت 80٪ من شركات “فورتشن 500” تستخدم أدوات القياس النفسي لتقييم موظفيها، ومن المتوقع أن يصل سوق اختبارات الشخصية إلى 6.5 مليار دولار بحلول عام 2027. ينظر عالم الموارد البشرية إلى هذه الاستثمارات على أنها تحقق عوائد ذكية في مراحل التوظيف، سواء قبل التوظيف أو بعده، حيث تساعد التقييمات في تحسين التوافق الثقافي والكفاءة، وتطوير المواهب، وتعزيز التعاون بين الفرق. تُشاد هذه الممارسات أيضًا لقدرتها على “تعزيز التنوع والشمول بدلاً من التوافق.” حتى أن “نظم تقييم هوغان” تدعي أن أدواتها تدعم “مبادئ العدالة الاجتماعية.” يظل اختبار “MBTI” شائعًا، مثلما أكد عليه الكاتب والمتحدث في مجال إدارة الأعمال باتريك لينسيوني في كتابه المؤثر لعام 2012 “الميزة: لماذا تتفوق الصحة التنظيمية على كل شيء آخر في الأعمال.” من بين العديد من أدوات التقييم الأخرى المتاحة “مؤشر السلوك DiSC”، و”مؤشر التنبؤ”، و”مكتشف القوة”، و”بروفايل كالبر”، و”تقييم كورن فيري لإمكانات القيادة” (KFALP)، و”تريتيفاي”، و”سويتد”.
كيف وصلنا إلى هذا الإيمان القوي بالتصنيفات الذاتية؟ وماذا يعكس ذلك عن فهمنا لأنفسنا؟
كيف أصبح الطبع (Character) شخصية (Personality)
يمكن تتبع تطور علم القياسات النفسية إلى موقعه الحالي في المجتمع من خلال ثلاثة أنظمة اجتماعية تاريخية تداخلت خلال القرن الماضي: الكفاءة، والنفسية، والتجارية. عند استكشاف هذه الأنظمة، نجد أنها مرتبطة بآليات تفسيرية تجمع بين المزاج الشرطي للاستقصاء (يبدو أنك كذا) والمزاج التصريحي للأحكام الحاسمة (أنت كذا). وسيظهر لنا كيف أن هذا الانتقال بين المزاجين يحمل أهمية كبيرة.
قبل حوالي ستة قرون من شيوع مصطلح الشخصية، كانت هناك برامج تقييم الكفاءة في الصين كجزء من جهود التوظيف في الخدمة المدنية. ركزت هذه البرامج على إمكانيات الأفراد، خاصة فيما يتعلق بوظائفهم المحتملة. فخلال عهد أسرة هان (206 ق.م – 220 م)، كانت الاختبارات التي تركز على المهارات وإجراءات الاختيار قائمة، وازدادت شعبيتها خلال عهد أسرة مينغ (1368-1644). تطورت هذه الأنظمة بشكل ملحوظ مع مرور الوقت.
في عام 1832، استخدمت شركة الهند الشرقية الإنجليزية التقييمات لاختيار الموظفين للعمل في الخارج، مما أدى إلى تبني الخدمة المدنية البريطانية لهذه الاختبارات في عام 1885. وفي عام 1883، تولت لجنة الخدمة المدنية الأمريكية مسؤولية إدارة العديد من الاختبارات المتعلقة بالعمل الحكومي. وخلال الحرب العالمية الأولى، طور عالم النفس في جامعة كولومبيا روبرت وودورث “ورقة البيانات الشخصية” لاستخدامها من قِبل الجيش الأمريكي لفرز الجنود المعرضين للذعر. وبعد هزيمة ألمانيا في الحرب، أنشأت القيادة العليا الألمانية برنامجًا ضخماً لتقييم واختيار الضباط والمتخصصين، سعيًا لتفسير “الشخص الكامل.” واستمر اعتماد الحكومة الأمريكية على هذه الاختبارات في “مجالس اختيار ضباط الحرب” منذ عام 1943. وبمرور الوقت، أصبح مفهوم الشخصية يرتبط بضبط دقيق لتوزيع الوظائف لتحقيق قوة الدولة والفوز بالحروب، وكان هذا جزءًا من تحول أوسع في المفهوم الغربي للذات. ما عكسه اعتماد أداة وودورث كان ميلًا طفيفًا في الإدارة المدنية بعيدًا عن ما يسميه المؤرخ وارين سوسمان من “ثقافة الطبع” نحو “ثقافة الشخصية الجديدة”. أقول “طفيفًا” لأن التطورات الكفائية المذكورة كانت لها قدم واحدة في جانب الطبع والأخرى في جانب الشخصية.
في السياق الأمريكي، كان الواجب في الخدمة يعتمد جزئيًا على مفهوم الطبع من القرن التاسع عشر، باعتبارها الجوانب الأخلاقية للشخصية التي تعزز صحة النظام الاجتماعي. كانت قيمة الذات تُقاس بشكل كبير بمدى تجسيد المرء لمعايير السلوك الاجتماعي والأخلاقي. باختصار، كان الطبع يُفهم من حيث الواجب الأخلاقي في تطبيق الفضائل.
ولكن من الجانب الآخر، أصبح الشخصية مسألة لياقة عاطفية يمكن الحكم عليها بناءً على السمات والاتجاهات، حيث يمكن افتراض المثالية الشخصية بوضوح دون الحاجة إلى تحديد اسمها بشكل دقيق، وبدأت العزيمة الأخلاقية في التراجع لصالح التوحيد القياسي كوسيلة للتصنيف. ومع تقدم علم النفس التجاري -كخطوة يتم التحضير لها-، ساهمت الكفاءة في التكوين الكامل لمفهوم “الشخصية”.
أما من الجانب النفسي، فتلك قصة أكبر. يمكن تتبع تطور هذه الأفكار إلى المفهوم القديم للأخلاط الأربعة – الدم، البلغم، الصفراء الصفراء، والصفراء السوداء -التي كانت تُستخدم لتحديد مزاج الشخص. فعلى سبيل المثال، كان يُعتقد أن الصفراء السوداء تسيطر على الشخص الكئيب. وربما يجب أن نراعي جذور الإنياجرام -جذور التساعية- في علم الكونيات الفيثاغوري والممارسات الصوفية القديمة. ولكن التطورات الأكثر تأثيرًا بدأت في القرن العشرين.
رفض عالم النفس الألماني فيلهلم فونت التركيز القديم على القوانين العالمية للسلوك البشري، وفي عام 1879، افتتح مختبرًا لقياس الشخصية باستخدام تجارب محكومة. كانت هذه خطوة علمية كبيرة، ولكنها أيضًا نقلت النقاش حول الذات من “الطبع” -الذي يتعلق بالصفات الأخلاقية للفرد- إلى “الشخصية” -التي تركز على السمات النفسية والاجتماعية-. تبع ذلك تطوير طرق جديدة لدراسة الفروق الفردية بين الأشخاص، مما أثار نقاشات حول أسباب وطرق التباين البشري. بحلول عام 1921، بدأت حركة دراسة الفروق الفردية تأخذ شكلها، وسرعان ما بدأت الجهود لتضييق الفجوة بين الجانب السلوكي والجانب الإنساني في علم النفس، وهو ما أشار إليه عالم النفس الإكلينيكي جيري ويغينز. حيث يقول “إن علماء الشخصية في جامعتي هارفارد وكولومبيا اعتمدوا إطارًا نظريًا يجمع بين صرامة المختبر وفورية العيادة، وهو ما يتطلبه “الوجود الإنساني”“.
في البداية، يصعب تحديد اللحظة التي أصبح فيها مصطلح “الشخصية” تقنية مستخدمة في علم النفس. لكن من المعروف أن لودفيج فيلهلم ستيرن في أوائل القرن العشرين ساهم بشكل كبير في تفعيل هذا المفهوم من خلال أبحاثه في علم النفس التفاضلي والشخصية، وهو المجال الذي أتى منه اختبار معدل الذكاء. أضاف سيغموند فرويد أبعادًا جنسية نفسية للمفهوم بأطروحته حول الأنا والهو والأنا العليا. أما كارل يونج، فقد كان له دور كبير في ترسيخ فكرة الشخصية من خلال كتابه “الأنواع النفسية”، حيث قدّم تصنيفات بين الانبساط والانطواء ووظائف التفكير والشعور والإحساس والحدس. جوردون ألبورت أضاف إلى هذه الفكرة بتحليله “للسمات” الشخصية عبر مقاييس القيمة. وبحلول منتصف القرن العشرين، مع ابتكار ريموند ب. كاتيل لنموذجه متعدد المتغيرات للسمات، أصبح مفهوم الشخصية محكمًا وثابتًا.
تحليل السمات يعتمد على التنبؤ الإحصائي للسلوك البشري، حيث يُنظر إلى السمات كأجزاء مترابطة تحدد السلوكيات التي يمكن ملاحظتها. بمجرد فك شفرتها، تصبح وسيلة للتنبؤ بالسلوكيات المستقبلية. كاتيل وصف الشخص بأنه يتكون من سمات سطحية ومصدرية وقدراتية ومزاجية وديناميكية، وابتكر استبيانات تربط رموز الحروف بصفات معينة، مثل “A” للانفتاح و”L” للشك، و”N” للذكاء. كانت هذه التصنيفات تتميز بالدقة التجريبية، وهو ما يشير إلى محاولة الإجابة على السؤال الذي طرحه دوستويفسكي في رواية “الرجل تحت الأرض”: “أين الأسباب الرئيسية التي يمكنني أن أرتكز عليها، أين قواعدي؟” قدمت نظرية “تحليل العوامل” لكاتيل ستة عشر تصنيفًا للسمات.
كما هو الحال في أي علم، اعتمد تحليل السمات على نظرية المعرفة كوسيلة لضمان صحة النتائج. في البداية، يبدو هذا منطقيًا. فعندما يُحدد الحرف “A” لشخصية “منفتحة”، وإذا أثبتت اختبارات الشخصية أن هذا الشخص يتمتع بالانفتاح، فإن الاستنتاج يكون بأن هذا الشخص “منفتح”. ولكن هنا يظهر تحوّل غير ملحوظ؛ فالصقل في تسمية الصفة يقودنا للاعتقاد بأن التعريف قد تحقق وأن النتيجة قد تم الوصول إليها. تراكم هذه الصفات يعطي رؤية شاملة للشخصية، مما ينقل الحالة من مجرد افتراض إلى تصريح مؤكد.
ولكن ماذا تعني كلمة “يكون” هنا؟ هل تمثل فعلاً علامة المساواة (=)؟ إذا وجدت نفسي أميل إلى سمات معينة مثل A + L + N، فماذا يعني ذلك حقًا؟ هل يعني أنني “ALN”؟ أين هو الحد الفاصل بين التكهن والاكتشاف؟ وهل يمكن أن تمثل هذه الخصائص السلوكية جوهر الفرد فعلاً؟ حتى وإن قيل لنا أن هذا الاستنتاج يتعلق بـ “الأنا” وليس الجوهر، فإننا نعتمد على قوة الوثائق، ونفترض أننا نعرف بعض الجوهر عن طريق معرفة الأنا كتركيب حوله. هل يمكن أن نفترض بنفس الطريقة أننا نحدد وجود الأرض بناءً على أنماط الطقس الخاصة بها؟
مع ظهور علم الشخصية، لم يكن هذا العلم بمنأى عن النقد الذاتي، ولكن الأسئلة المعرفية لم تلقَ صدى واسعًا بسبب ارتباطها بنموذج تجاري متنامٍ. حينما بدأ العالمان هوغو مونستربيرج ووالتر ديل سكوت بتطوير مناهج علم النفس الصناعي في حوالي عام 1915-1917، لفتا انتباه مدراء المصانع الذين كانوا يسعون لتحسين تدريب العمال وتزويدهم بموارد أفضل. بحلول عام 1919، وفقًا لما أوضحه لورين باريتز في كتابه “خُدام السلطة”، أصبحت “جاذبية تلك المعجزة” مترسخة في إدارة الشئون البشرية. شركات استشارية مثل شركة سكوت وشركة جيمس ماكين كاتيل النفسية التي تأسست في عام 1921، بدأت تروج لاختبار العمال بناءً على استبيانات. وفي عام 1934، قام الطبيب النفسي جاكوب إل. مورينو بتطوير القياس الاجتماعي لقياس العلاقات الإنسانية. كما تم تصميم تقنية الإدراك الموضوعي (TAT) لتحديد علامات “القيادة” سريريًا، وأصبحت أداة MBTI دقيقة الاستخدام في أواخر الأربعينيات.
مع حلول الخمسينيات، اجتاحت الصناعة الأمريكية حمى القياس النفسي. وكما أوضح باريتز، اعتمدت صناعة الفحم على “الهندسة البشرية” كوسيلة لزيادة الإنتاجية، وأعرب أحد مدراء شركة ستاندرد أويل عن الاعتقاد المتزايد بأن “طبيعة الشركة الحديثة كانت اجتماعية”. فبالرغم من أن تحسين الأجور والمزايا كان قد لا يكون كافيًا، إلا أن استراتيجيات إدارة الأفراد يمكن أن تعزز الكفاءة والتحفيز وبالتالي الإنتاج. وقعت شركات مثل سيرز وجنرال إلكتريك وويستنجهاوس في حب جداول العمال، مما أدى إلى نمو قطاع خدمات الاختبار بقيادة مجموعات مثل “علم النفس الصناعي” و”جمعية الأبحاث العلمية في شيكاغو”. وقد رفعت تلك المؤسسات علم النفس الصناعي إلى مستوى جديد من علاقات الأفراد والتدريب التنموي واستثمار القيادة.
وفي تلك الأثناء، استمرت كلمة “الشخصية” في العمل كمرجع توجيهي دون أن يتم تحديد تعريف دقيق لها. بالنسبة لويليام إتش. وايت، محرر مجلة فورتشن، كان الأمر كله عبارة عن لغة معقدة وزائفة لتحديد علامات “الولاء” لدى القادة في الناس. في كتابه “رجل المنظمة” (1956)، أوضح كيف أن استخدام البطاريات التقييمية في مكان العمل، رغم تجميلها بالإشارات إلى تقييم الكفاءة وتعزيز القيادة والتماسك الاجتماعي، كان يحمل افتراضات معرفية مشكوك فيها. ووراء بريق “المنهج العلمي” والدقة الموضوعية لاختبارات مثل جدول شخصية ثورستون واستبيان شخصية برنروتر وسجل التاريخ الشخصي لوورثينجتون، رأى وايت أسطورة وضعية تدعم اختلالًا في توازن السلطة. طرح السؤال: ما هي “السمة” بالضبط؟ وكيف يمكن تكييفها مع مقياس خطي؟ جادل بأن العلم، في ادعائه تقليص “الكل” إلى وحدات قابلة للقياس، كان يتبنى رياضيات تُظهر الحقيقة بشكل مضلل. ومع ذلك، ورغم هذه الدقة النفسية والانتهازية التجارية، لم يعد الهدف هو تحديد ما يمكن للشخص “فعله”، بل أصبح تحديد “من أنت” و”من ستكون” لتحديد دورك في السوق. هذه الأهداف المحسوبة بدقة دفعت المنظمات إلى تبني ممارسات تصنيف البشر بشكل مضلل.
رغم نجاح كتاب “رجل المنظمة”، لم يُعر الكثير من علماء النفس غير الصناعيين اهتمامًا لما قاله وايت، فقد كانوا مشغولين بمحاولة تحسين طرق التقييم الخاصة بهم. عالم النفس التربوي إل. جيه. كرونباخ، كان يستغرق كل وقته في دراساته الدقيقة لتفاصيل تصنيف الاختبارات وتقييم الموضوعات. ومع ذلك، حتى أوائل السبعينيات، كانت الأسئلة لا تزال مطروحة.
جيري ويغينز، المعروف بعمله على “نموذج الدائرة” للعلاقات الإنسانية، أقر بجهود كرونباخ وآخرين واعترف بأن “الأدلة على دقة الحكم العامة ليست قاطعة”. كان من الصعب تجاوز العنصر البشري في الأحكام السريرية، وكان تحقيق الموضوعية الكاملة في اختيار معايير تقييم أدوات الاختبار والسمات المستهدفة أمرًا صعبًا. حذر ويغينز من أن التنبؤات النفسية التشخيصية قد تقع في فخ ما أسماه “الفلكلور السريري”. واعترف أيضًا بوجود “افتقار لنظرية شخصية مقبولة بشكل عام”. ورغم ذلك، كانت القاعدة الطموحة بالنسبة لويغينز -كما هو الحال مع أسلافه- هي محاولة تجاوز الصعوبة الموضوعية بتطبيق المزيد من العلوم الموضوعية. ولكن، لم يفكر ويغينز فيما إذا كان هذا التوجه بحد ذاته نوعًا من “الفلكلور”.
هذه القصة أعمق من ذلك بكثير، ولكن يمكن تلخيصها كالتالي: وُلدت نظرية الشخصية من خلفية تقييم الكفاءة، ثم ارتقت لتصبح مشروعًا نفسيًا ذا تطبيقات تجارية مغرية، وانتقلت من عصرها المحوري إلى حالة من التركيز المستمر دون أن تتوقف لإعادة التفكير في قفزتها من الوضع الشرطي إلى التصريحي. ومن منظور المختبر، والعيادة، والفصل الدراسي، وأرضية المصنع، وإدارة الأفراد، أصبحت هوية الشخص ومعنى الشخصية موضوعًا للحساب في نظام نفسي سيكومتري معقد. لقد أصبحت “الذات” كما “بدت” على نحو قابل للقياس، شيئًا يمكن فك شفرته باستخدام أدوات شبه خوارزمية تحدد قصته وتحدد إمكاناته. ولكن كم ابتعدنا عن تحذير هاينريش هاينه (1833) بأن “تكوين وصف شخصية المرء سيكون ليس فقط مهمة صعبة ولكن ببساطة مستحيلة”. لقد كانت القوة التفسيرية (والربحية) للتشخيصات الدقيقة مغرية جدًا بحيث لا يمكن التشكيك فيها.
وبعد كل هذا، تخيل الآن واقعًا تصبح فيه الواقعية الساذجة والواثقة للأجندة الكاملة للتوصيف هي السائدة في الثقافة العامة، حيث يصبح الأفراد جزءًا من ميدان القياس النفسي، ويتعلمون بمرور الوقت الاستمتاع بهذه التصنيفات، بل ويستثمرون في تلك التقييمات كوسيلة لاكتشاف الذات وتحقيق الرفاهية. هذا هو المشهد الذي نعيش فيه اليوم، والذي نعود إليه الآن.
حمى التصنيف
يكمن الفارق الوحيد بين عصرنا الحالي وعصر نشوء نظرية الشخصية في الحجم ومدى انتشار هذه النظرية. الفرضيات الأساسية بقيت كما هي، ولكن تم تهدئة المخاوف المتعلقة بالاعتماد على “الفلكلور” في اختبارات الشخصية بفضل التحسينات التقنية في أساليبنا والنماذج المتقدمة. مع تزايد الحملات التي تُجرى لصالح بروتوكولات التشخيص وتحديد الأمراض النفسية، وتطوير فرق العمل في أماكن العمل، وتحقيق الذات والتوفيق المهني، تطورنا بشكل كبير منذ أيام كاتل وستاندرد أويل وسوسيومتري مورينو، ناهيك عن اللحظة التي تساءلت فيها كاثرين بريجز عن اختيار ابنتها لشريك حياتها بناء على اختبارات الشخصية. ومع صعود علم البيانات، أصبحت أدواتنا أكثر دقة وإثباتاً. هذا الاتجاه أصبح الآن صناعة تقدر بملياري دولار في عالم الشركات، كما تشير صفحات نيويورك تايمز ووال ستريت جورنال وفوربس إلى مكانته المرموقة. عندما يشارك كيان عقلاني مثل صندوق بيو الخيري في هذا المجال من خلال استبيان فكاهي مثل “أي نوع من البطريق أنت؟”، ندرك أن الفكرة حققت نجاحًا كبيرًا. نضحك قليلاً على جنون التصنيف، لكن يبدو أننا نثق في أن الوسائل النفسية أثبتت جدارتها لتحقيق غايات مفيدة. هذا رهان جريء، وإغراء المعجزة يستمر في البقاء.
في هذا التقاطع بين الأنظمة الكفائية والنفسية والتجارية، نحن اليوم مواطنون في “البارادايم الاختصاري”، الذي له استخداماته العملية، لكن بأي ثمن نختصر الذات؟ ولماذا نحن مستعدون لدفع هذا الثمن؟
لننظر أولاً -من أجل السياق- إلى المعنى الضمني لـ “التقدم”. أحيانًا، تعزز التحديثات الجديدة قدرتنا على نسيان القفزات التأكيدية الغريبة التي اُتخذت في البداية. ما يبدأ كتعبيرات تأهيلية يصبح ملاحظات توضيحية، ثم نقاط فاصلة، وأخيرًا اختصارات مؤكدة لشخصيتك. يتحول التخمين إلى ثقة، والتكهنات إلى يقين، والأخطاء المحتملة إلى حقائق. نخطئ عندما نأخذ الانطباعات على أنها حقائق مطلقة. وكما كشفت لنا اختبارات جيناتنا، يصبح الشخص شخصية، وتتحول الشخصية – التي هي في الأصل مجرد تجريد شرطي – إلى جوهر يمكن التحقق منه. تُختصر الذات إلى علامة تجارية بلا غموض. وفي عالم تتلاشى فيه الأسئلة تحت سطوة الحسابات والتصنيفات، كما أشار دوستويفسكي، “سوف تتلاشى جميع الأسئلة الممكنة في لحظة، لأنها ستُمنح جميع الإجابات الممكنة”. وعد الإجابات مغرٍ، وربما يقدم تلك الشخصانية نظرة ثالثة سريرية عن أنفسنا في عالم لا نثق فيه بالأشخاص الحقيقيين للقيام بذلك. ربما نقبل أن نُصنّف بسبب القلق الوجودي الذي أشار إليه الشاب ويرثر لغوته: “كم نشتهي لمحة اهتمام!”. بعد كل شيء، أن تُصنف يعني أن تُلاحظ، أن تُحدد وبالتالي تُعتمد. وهذا يلبي حاجة إنسانية للاعتراف.
الإجابات، بالطبع، تكشف أحيانًا أشياء عن أولئك الذين يسعون إليها. مهما كنا نظن أننا نعرف عن أنفسنا في حالتنا ما قبل التقييم، فإننا نشعر بأننا غير محددين حتى تحددنا أداة ما. كما قال ديستويفسكي، “يبدو أن كل المشروع الإنساني يتألف من إثبات الإنسان لنفسه في كل لحظة أنه إنسان وليس غصنًا!”. يأتي الإثبات عندما نتعرف، وهذا يعني اليوم أن نُصنّف. جملة “لقد عالجنا مخزونك وسنعطيك نتيجة شخصيتك” تغرينا بالمعنى، ونحن لسنا مخطئين في الرغبة في ذلك. أن تكون ذاتًا هو عمل صعب. ولكن عندما نختصر أنفسنا من خلال ترتيب العمليات الذي تقوده الأدوات، فإننا نختصر أيضًا، أو نتخطى تمامًا، ما يجب أن يكون ارتباطًا طويلًا واستكشافًا عميقًا مع تلك الحالة الصعبة.
التعقيد فى العصر الحديث
ما الذي يجعل هذا الانخراط صعبًا للغاية في عصرنا الحديث، ويجبرنا على التوق للاعتراف بتعريف الشخصية المختصر رغم أننا ندعي كراهية التصنيف؟ هنا ندخل في أعماق اجتماعية ووجودية أعمق.
في كتابه “انتصار العلاج النفسي” (1966)، وصف عالم الاجتماع فيليب ريف تحولًا ثقافيًا يتمثل في إزاحة الطبع بالشخصية، حيث جادل بأن الغرب بعد الحرب العالمية الثانية فقد الأطر المعيارية المشتركة لفهم من هو الشخص وكيف يجب أن يعيش. تزعزع تنسيق الأفراد وفقًا لبعض المبادئ المشتركة للحياة، مما أدى إلى شعور بـ “الضيق” بسبب فقدان “البراءة البشرية”، وبالتالي إلى رغبة ملحة في إيجاد مبادئ تنظيمية جديدة لمن نكون. ونتيجة لذلك، ظهرت شخصية “الإنسان النفسي” – الشخص الذي يسعى في المقام الأول إلى العثور على الرضا في وعد “الفردية والحرية”. تطور هذا التحول منذ أوائل القرن العشرين، حيث بدأت رؤية التضحية بالنفس تتحول إلى تحقيق الذات. ولكن في فترة ما بعد الحرب، أصبحت الأدوات العلاجية لتحقيق هذا الإدراك -تحت رعاية التحرر- مكررة بشكل لا يقاوم. وبينما كان الدافع وراء نموذج الطبع هو الحفاظ على التماسك الاجتماعي، كان الدافع وراء “الإنسان النفسي” هو الصراع للبقاء في مناخ التفكك الاجتماعي والحفاظ على الذات. في حين أنه قد يكون من الضروري أن تكون مواطنًا جيدًا، إلا أن تحقيق الذات أكثر إرضاءً.
لم يكن ريف معارضًا للعمل العلاجي، لكنه كان قلقًا بشأن التحول نحو الفردية المجزأة والمجالات العلاجية التي تعززها. لاحظ أن “عندما لم يعد معنى الوجود الاجتماعي يمنح حياة داخلية في سلام مع نفسها، يجب على كل إنسان أن يصبح عبقريًا بشأن ذاته. ومع ذلك، فإن الخيال يعجز عن تصور ثقافة تتألف في معظمها من عباقرة في تصوير الذات.”
إذا كان هذا الرأي صحيحًا، فإنه يساعد في تفسير لماذا تم تبني الافتراض بتعريف الشخص بصيغة تقريرية صريحة. لم يحسن نظام تقييم الشخصية إدارة الأفراد فحسب، بل جلب أيضًا راحة لجرح وجودي. ومن خلال ترميز الفرد، تم اختصار الرحلة الطويلة لإعادة التكوين الداخلي.
في الآونة الأخيرة، لفت الفيلسوف تشارلز تايلور الانتباه إلى كيفية تحولنا في العقود الأخيرة إلى ثقافة “الفردية التعبيرية”، حيث يُشجع الناس على إيجاد طريقهم الخاص واكتشاف رضاهم الشخصي وفعل ما يريدون. أصبح الفرد أقل ارتباطًا بـ “التجمعات الكبرى” التي تتجاوز ذاته، وأصبح “موضوعًا معزولًا” يسعى للعيش وفقًا لشروطه الخاصة في عالم أصبح خاليًا من السحر وميكانيكيًا. نحن نلتزم بعقلية أنثروبومورفية تعتمد على العقل والقوة و”إعادة التشكيل الذاتي المنضبط”. هذا الالتزام يعبر عن “نظام من الأفكار” الذي يعتبر جزءًا من الأشكال الثقافية. لذلك، من الطبيعي أن نتناول مشروع الشخصية باعتباره -كما يراه تايلور- مشروعًا “عقلانيًا أداتيًا” آخر. ولكن وسط هذا، لا نستطيع الهروب من شعور واسع بالقلق، إحساس هش بأن “شيئًا ما قد فُقد”. نشعر بحنين غريب لشيء يتجاوز حدودنا الذاتية.
إذا كانت ملاحظات تايلور دقيقة، فإن استعدادنا لتبني منطق أدوات الشخصية المرتبة والمحددة يصبح مفهومًا، وكذلك الشعور بالفراغ الذي يسيطر علينا بعد زوال الارتياح الناتج عن هذا الاختصار. تحليل ريف لتفكك الذات، ومخاوف تايلور بشأن العزلة الذاتية، يشيران إلى أننا -مع الشخصية- عالقون في أداء فوضوي لكنه منطقي. نحن نعتبر الحياة الجيدة هي تلك التي نؤكد فيها فرديتنا ونجعلها أداة.
لكن هل يناسبنا قناع الشخصية حقًا؟ نحن مفتونون بحياتنا الداخلية، ولكن كأبناء للقياسات النفسية، نتعامل معها من خلال “سماتنا” و”ذواتنا” القابلة للتسجيل. ومن المفارقات أن هذا يعمق انفصالنا عن أعماقنا. تنشأ ولاءاتنا وأهدافنا المشتركة من التعبير عن ذواتنا التي نظن أننا نعرفها، وليس من خلال استثمار في قيم دائمة تتجاوز ذواتنا. هذا لا يعني أننا بحاجة للعودة إلى القيم الفيكتورية التي تركز على ضبط النفس عبر التضحية بالمثل العليا، بل يشير إلى التناقض في تحقيق الذات عبر التضحية بالمخططات. يبدو ذلك عشوائيًا، لكنه طبيعي، حيث نبحث الآن عن ذواتنا في مسلمات “الأدوات” و”الملفات الشخصية” التي نركبها.
وماذا عن مساعينا الأخرى؟ مثل الانتشار الواسع لممارسات اليقظة والتأمل التي تأخذنا إلى داخلنا؟ والرواقيات الشعبية التي تنمي هدوءنا واعتمادنا على الذات؟ نعم، نقوم بهذه الممارسات، أو نعد بإضافتها إلى روتيننا اليومي. ربما تساعدنا في معرفة أنفسنا من الداخل إلى الخارج. ولكن كم هو غريب أن هذه الممارسات كانت تهدف في الأصل إلى إفراغ الذات والتخلص من أوهام الشخصية. هل نحن نسعى إلى ذلك دون أن نشعر؟ ففي عصر “الاغتراب الذاتي المتزايد”، تصبح مهمة فهم الذات أكثر إلحاحًا.
مع هذه الأهمية، يعتمد الهوس بالاختصارات بسعادة (وبربح)على فعالية وسلطة التقدم الأداتي، مقلدًا أوهامه الحسابية. التقييمات تتمتع بهالة من الشرعية تجعلها ممكنة من خلال بيانات الاستطلاعات والإحصاءات، وتستعير هذه الأدوات السحر السلطوي لـ”المقاييس”، وهو هوس وصفه المؤرخ جيري مولر بأنه “الاعتقاد بإمكانية وضرورة استبدال الحكم المكتسب من خلال الخبرة الشخصية والموهبة بمؤشرات رقمية للأداء بناءً على بيانات موحدة.” يحذر مولر من “وهم العقلانية” في هذا المعتقد، وهو إيمان بـ”سيادة التقنية” كوسيلة لـ”المعرفة الحقيقية”.
بهذا الميل، هل يمكن أن نميل إلى الاستماع إلى أغنية القياسات النفسية لأنها تبدو في سجل اليقين التقني؟ نحن نشتاق إلى “لمحة اهتمام”، ولا شيء مثل الاختصار أو الكود الرقمي للدلالة على الاعتراف التفسيري. ولكن أي إحصائي أو مستطلع نزيه سيخبرك أن الرسوم البيانية لا يمكنها أن تلتقط كيفية عمل الحياة على الأرض. عداد الخطوات في ساعتك لا يخبرك بمدى لياقتك. وزقزقة عصفور طائر واحد لا تصنع الصيف.
***
لقد اخترعت أداة قياس نفسي، أسميتها “الخداعوميتر“، وهي تتألف من خمسين سؤالاً من نوع الاختيار المتعدد مع دليل بسيط للتقييم يكشف عن شخصيتك، أو ما سأطلق عليه “نوع الخداعي”.
كيف تستجيب لنتائجك؟ أولاً، قم بتقييم مدى توافق التصنيف معك. إذا كان يتوافق بشكل كبير، ففكر فيما إذا كنت (أ) تعتقد أن أساليب خداع الذات التي تستخدمها مفيدة وجيدة، وإذا كان الأمر كذلك، فتخيل كيف يمكن تنظيمها بشكل متعمد، أو (ب) ترغب في تغيير طرقك، وإذا كان الأمر كذلك، فتخيل ما قد يتطلبه ذلك. في كلتا الحالتين، المهم هو جعل الخيار واضحًا وامتلاكه. إذا لم تشعر أن نوع الخداعي الذي تم كشفه يناسبك، فلا تتردد في إعادة الاختبار لترى ما إذا كنت تستطيع الوصول إلى النوع الذي تفضله. الأمر يعود إليك.
— مترجم من مجلة Hedgehog Review للكاتب كريستوفر ييتس
( الأداة عبارة عن صفحة فارغة وهذه هي الخدعة )
قراءات كانوية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة
الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أي اعتداء او تجاوز ، او محاولة حذف المادة باي حجة واهية سنلجأ للقضاء ومقاضاة من يفعل ذلك
فالجريدة تعتبر حذف اي مادة هو قمع واعتداء على حرية الرأي من الفيسبوك
 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل