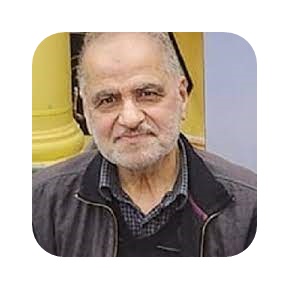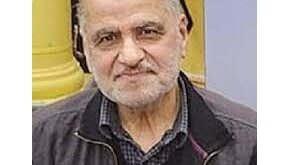فيينا / السبت 22 . 02 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
د. فاضل حسن شريف
جاء في موقع مركز تراث البصرة عن جامعُ الإحسان مدرسة لتخريج المؤمنين: اختارَ اللهُ المساجدَ وجعلها مكاناً للعبادة, وعظّمها وقدّسها فهي بيوتُ اللهِ من دخلها كان في ضيافته جلَّ وعلا، فلو كُشِف عن بصيرتِنا لرأينا عظيم ما نرى من كرمٍ وعطاءٍ، وما يغشى العبدَ من النورِ، وما يحطُ عنهُ من الذنوبِ، نتعلَّم فيها حق العبادة، فالمسجد مكان مقدَّس وهو أعظمُ مكانٍ يُعبَدُ الله عزَّ وجلَّ، إذ قالَ تعالى مُخاطِباً رسولَهُ الكريم: “لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ” (التوبة 108). كثيرةٌ هي المساجد وخصوصاً في بلد الحضارات والمقدسات بلدنا العراق، والبصرة صاحبة التراث والتاريخ العريق تضم الكثير من هذه المساجد، إذ تنتشر في عمومِ مناطقها، ومن تلكَ المساجد (جامعُ الإحسان). الموقع والمؤسس وزمان التأسيس: يقعُ الجامعُ في قضاءِ شطِ العربِ، منطقة التنّومة، أسَّسهُ الحاج المرحوم (باقر عيسى السعد) عام (1989م)، وبقي مغلقاً مدّة أربعة عشر عاماً حتى عام (2003م). أنشطة الجامع وأئمة الجماعة: يُعدُّ جامع الإحسان من الجوامع البارزة في المنطقة ومن أماكن العبادة المهمّة، تُقام فيه المناسبات الدّينيّة الخاصّة بأهل البيت عليهم السلام، وتُعقَدُ فيه الندوات الفكرية والثقافية، ومراسيم قراءة دعاء التوسّل في كل ليلة أربعاء وزيارة عاشوراء في ليالي الجمع، ولصلاة الجماعة فضل لا يحصيه الا الله وحده تبارك وتعالى، ويداوم الاخوة في جامع الإحسان على إقامة صلاة الجماعة، وللحضور دور بارزٌ في استمرارها، ففي بعض الأحيان يمتلئ الجامع بالمصليين، وقد أمَّ الجماعة في هذا الجامع المبارك عدد من المشايخ الكرام منهم الشيخ عبد الله المسفر، وكذا الشيخ باسم المسافرة، والشيخ علي أيوب، والشيخ عبد الله الساكان، حفظهم الله جميعاً أما إمام الجماعة الراتب فهو الشيخ أسعد الصالح ، وهذه الأنشطة مستمرة على طول السنة، فضلاً عن فتح دورات قرآنية وفقهية وعقائدية في أيام العطلة الصيفيّة. وأنشطة أخر. ومن ضمن نشاطات الجامع –أيضاً- يقام فيه تشييعٌ رمزيٌ لمولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام يوم استشهادها وآخر لحفيدها الإمام الحسن العسكري عليه السلام في ذكرى استشهاده. يضم الجامع مكتبة صغيرة تحتوي على بعض المصاحف وكتب الأدعية وبعض الكتب الضرورية.
عن الموسوعة الحرة: يقع جامع المقام في منطقة العشار في البصرة، وهو من مساجد العراق التاريخية التي يرتبط تاريخ إنشائها وأسمها بحكم الدولة العثمانية في العراق. شيد وبني الجامع في عهد الدولة العثمانية عام 1167 هـ/1754م، وأول من أسسهُ وبناه الحاج محمد الششتري وعلى نفقة السلطان العثماني عبد الحميد، ويمتاز الجامع بضخامة بنائه وبجمالية هندسة بنائه ونقوشه وزخرفته الداخلية ولقد بني من الطابوق والآجر، وعلى شكل مخروطي ومقوس، ويتسع الحرم الداخلي إلى ما يقارب 500 مصل، ويمتاز الجامع بقبته المتينة حيث اكتشفت بعد الصيانة والتعمير للمسجد في عام 1420 هـ/2000م، بوجود قبة أخرى تحت القبة الخارجية. ولا زال الجامع يحتفظ بأبوابه الأثرية التاريخية ومفاتيحه الحديدية القديمة، وتحتوي خزانته على مصحف نادر يعود تاريخه إلى زمن الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان. وسبب تسمية الجامع بالمقام يعود إلى مبنى دار المقام العالي قبل تأسيسه عام 1167 هـ/1754م، ودار المقام العالي هي دائرة كمرك تابعة للدولة العثمانية تشرف على كمرك البضائع القادمة من خارج العراق إلى ميناء البصرة بواسطة السفن عبر الخليج العربي مرورا بميناء شط العرب، وترسو السفن في منطقة الداكير حالياً مما جعل سلطات الدولة العثمانية تتخذ من هذا الموقع مقراً لهذه الدائرة المهمة، لأن المكان أصبح كالميناء ويدر أموالاً، وبعد تشييد مبنى دائرة المقام العالي وأصبح ما حولها منطقة تجارية وصناعية كبيرة، فشجع العاملون في هذا المكان إلى البناء قربها لتتحول إلى محلة سكنية، وسميت بمحلة المقام نسبة إلى مبنى دائرة المقام، وبعد أن تطورت المدينة وكثر السكان شيد جامع المقام الذي اشتق إسمه من اسم المدينة واسم الدائرة. وتبلغ مساحة الحرم 450 متراً مربعاً حيث يبلغ عرض الحرم 30 متراً، وطوله 15 متراً، وفي وسطه محراب وعن يمينه منبر وكلاهما مغلف بالطابوق والكاشي المزجج الكربلائي، ويحوي مصلى الحرم على ثلاث قبب إحداها كبيرة تتوسط حرم الجامع، وبناؤها من الداخل من الطابوق الفرشي غير المغلف بمساحة ثمانية أمتار مربعة ولها ثمانية نوافذ، وعلى جانبيها قبتان مساحة كل منهما أربعة أمتار مربعة، ولهُ محفل للقراء من الطراز العثماني صنع مع السلم المؤدي إليه من الخشب الصاج، وقبالة الحرم ساحة وله منارة مئذنة تعلو الجامع بارتفاع 25 متراً، ولمدخل الجامع وغرف الإمام والخطيب والمؤذن ثلاثة أبواب خشبية ما زالت محتفظة بطابعها التراثي القديم. ولقد طرأت على الجامع عدة تغييرات بعد الترميمات ابتداء من عام 1922م، وعلى نفقة وزارة الأوقاف حيث تم كتابة المخطوطات عليه، كما أِعيد ترميم الجدران وبناء جدار خارجي لساحة الجامع، حيث كان الجامع يطل مباشرة على نهر العشار المرتبط بشط العرب، كما قامت الحكومة العراقية عام 1401 هـ/1981م، بإعادة ترميم الجامع. ومن أبرز خطباء المسجد في عقدي الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي الشيخ شهاب الدين القيسي والشيخ أحمد شهاب، ثم جاء من بعدهِ الشيخ عبد المعطي سعد عمر الخويطر، وكان يشغل العديد من المناصب منها امام وخطيب وواعظ جامع المقام ومدير إعدادية الحسن البصري للدراسات الإسلامية ورئيس المجالس العلمية في المنطقة الجنوبية، وقد تولى رعاية المسجد لمدة 66 عاما، ثم تولى رعاية المسجد ابنه الشيخ عبد السميع الخويطر.
جاء في موقع مركز تراث البصرة عن جامعُ (نَهَرْ خُوزْ): أئمة الجماعة في المسجد: أمَّ الصَّلاة في مسجد نهر خوز الشيخ عبد العزيز زين الدين رحمه الله، جاء بعده عددٌ كبيرٌ من العلماء والفقهاء، منهم: نجله العالم الجليل آية الله العظمى الفقيه الشيخ محمد أمين زين الدين قدس سره، ثُمَّ الشيخ محمد طاهر الخاقاني رحمه الله، ثُمَّ الشيخ علي زين الدين رحمه الله، واستمرت الحركةُ الدينيةُ تزدادُ نشاطاً في المسجد، واستمر ينشر علومه ومعارفه بين أوساط الناس، لوجود ثُلَّة من الشباب المؤمن في تلك المرحلة، وبعد وفاة آية الله العظمى الفقيه الشيخ محمد أمين زين الدين قدس سره، آلت التوليةُ إلى نجله العلّامة الشيخ ضياء الدين زين الدين أعزَّه الله، فكان يقيم الجماعة، ويُلقي محاضرات الوعظ والإرشاد في الجامع. وإضافة إلى ما ذكرنا من العلماء، فقد أَمَّ الصلاة في هذا المسجد المبارك كلٌّ من: الشيخ محمد محمد طاهر الخاقاني، والشيخ علي رجب، والشيخ حسن العصفور. خطباءُ المنبر الحسيني والمؤذنون: وفيما يتعلّق بأبرز الخطباء الذين نالوا شرف حدمة المنبر الشريف في هذا المسجد، فقد كان يرتقي المنبر في هذا المسجد المبارك كلٌّ من: الخطيب الحاج أحمد، وكان هذا نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن المنصرم، كذلك الشيخ عبد الستار الدكسن، والشيخ محمد رضا الدكسن، والشيخ صاحب الدكسن، والشيخ علي الدكسن، وآخرون. وأما أبرزُ مَن أذَّن في هذا المسجد، وصدحتْ حناجرُهم في هذا المكان المبارك، فهم: السيد كريم والسيد جعفر بن السيد حبيب الكامل، وكان يحتضن الجامع ويرجع إليه في بعض الأمور الفقهية، والسيد عدنان الكامل، وكذلك الحاج خليل موسى. أبرزُ الوجهاء: وأما مَن يرتاد المسجد من الوجهاء وكبار السن الذين لهم التأثير البارز عند حضورهم، فيُذكر السيد سلمان وأولاده، (السيد عدنان والسيد داود والسيد كامل)، الذين كان لهم الدور الكبير في الجامع، إذ كانوا يُحيون المناسبات، ويُسهمون في خدمة الجامع وإحياء المناسبات الدينية، ويُحفِّزون الشباب ويدفعونهم نحو إحياء ذكر أهل البيت عليهم السلام وإبراز مظلوميتهم للناس. كذلك كان بيت الحاج علي والحاج عيسى والحاج موسى والحاج محسن والسيد جاسم والسيد حبيب، وكذلك من بيت السيد إبراهيم السيد توفيق، ومن بيت صيهود الحاج صيهود والحاج فالح الصيهود, وكذلك الحاج سلمان العاتي، الذي كان له دورٌ كبيرٌ في قراءة المقتل الحسيني يوم العاشر من المحرم، وكان له صدى في نفوس المصلين، والآن أحفاد الحاج سلمان العاتي على سِيرة جدِّهم في قراءة المقتل، منهم: حسين مؤيد الحاج سلمان العاتي. كذلك السيد زكي السيد عدنان الكامل. التطورُ العمرانيُّ للمسجد: وبخصوص التطوُّر العمراني في المسجد، فقد مرَّ المسجد بمراحل عديدة – كما أسلفنا – ثُمَّ طوِّرَ الى ما هو عليه اليوم بعد أن تعرَّض إلى الهدم عدَّة مرَّات نتيجة تأثره بالحرب العراقية – الإيرانية في الثمانينيات من القرن المنصرم، ففي عام (1986م) تعرَّضتْ البصرة لهجومٍ إثر الحرب العراقية – الإيرانية، فانهار المسجد بكامله نتيجة القصف الذي تعرَّضتْ له منطقة أبي الخصيب. ويعود تاريخ ما نراه اليوم من بناء للمسجد إلى سنة (1993م)، فقد شُيِّدَ على مساحة طول الحرم فيها (22م) وعرضه (12م)، أما مساحة المسجد وملحقاته، فتبلغ أكثر من (600 م2)، وفي النية إنشاء مكتبة لخدمة أهل القضاء ورفدهم بالمعلومة المفيدة. وقد بُني مغتسلٌ في سبعينيات القرن الماضي قرب الجامع تابعٌ له، ويقصده الناس من أطراف مدينة أبي الخصيب لتغسيل موتاهم فيه، ويعمل فيه أناس متفقِّهون في هذا المجال، لا يبتغون من عملهم هذا إلَّا الأجر والثواب من الله تعالى جزاهم الله الخير كله. ويبقى مسجد نهر خوز ـ كسائر مساجدنا ـ مستمرا بأداء رسالته الدينية والثقافية، يجمعُ الشباب المسلم والملتزم بتعاليم الدين الحنيف، ويواظبُ على إحياء المناسبات الدينية، ومصداقا لقوله تعالى “فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوّ وَالاَصَالِ * رِجَالٌ لاّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَإِقَامِ الصّلاَةِ وَإِيتَآءِ الزّكَـاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأبْصَارُ* لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُمْ مّن فَضْلِهِ وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ” (النور 36-38).
جاء في معاني القرآن الكريم: سجد السجود أصله: التطامن (التطامن: الانحناء) والتذلل، وجعل ذلك عبارة عن التذلل لله وعبادته، وهو عام في الإنسان، والحيوانات، والجمادات، وذلك ضربان: سجود باختيار، وليس ذلك إلا للإنسان، وبه يستحق الثواب، نحو قوله: “فاسجدوا لله واعبدوا” (النجم 62)، أي: تذللوا له، وسجود تسخير، وهو للإنسان، والحيوانات، والنبات، وعلى ذلك قوله: “ولله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال” (الرعد 15)، وقوله: “يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله” (النحل 48)، فهذا سجود تسخير، وهو الدلالة الصامتة الناطقة المنبهة على كونها مخلوقة، وأنها خلق فاعل حكيم، وقوله: “ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون” (النحل 49)، ينطوي على النوعين من السجود، التسخير والاختيار، وقوله: “والنجم والشجر يسجدان” (الرحمن 6)، فذلك على سبيل التسخير، وقوله: “اسجدوا لآدم” (البقرة 34)، قيل: أمروا بأن يتخذوه قبلة، وقيل: أمروا بالتذلل له، والقيام بمصالحه، ومصالح أولاده، فائتمروا إلا إبليس، وقوله: “ادخلوا الباب سجدا” (النساء 154)، أي: متذللين منقادين، وخص السجود في الشريعة بالركن المعروف من الصلاة، وما يجري مجرى ذلك من سجود القرآن، وسجود الشكر، وقد يعبر به عن الصلاة بقوله: “وأدبار السجود” (ق 40)، أي: أدبار الصلاة، ويسمون صلاة الضحى: سبحة الضحى، وسجود الضحى، “وسبح بحمد ربك” (طه 130) قيل: أريد به الصلاة (أخرج عبد الرزاق وغيره عن ابن عباس في الآية قال: هي الصلاة المكتوبة)، والمسجد: موضع الصلاة اعتبارا بالسجود، وقوله: “وأن المساجد لله” (الجن 18)، قيل: عني به الأرض، إذ قد جعلت الأرض كلها مسجدا وطهورا كما روي في الخبر (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نصرت بالرعب، وأوتيت جوامع الكلم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وبينا أنا نائم أتيت بمفاتح خزائن الأرض فتلت في يدي).
جاء في موقع مركز تراث البصرة عن جامعُ الهُدى المعروف ب جامعُ العلّامة السيّد حامد السُّويج رحمه الله منارة من منارات الهدى في البصرة: المراحل العمرانيّة: مرّ المسجدُ بعدّة مراحل عمرانيّة، فكانت بداية التأسيس عام1965، واكتمل عام 1968، وقد تعرّض المسجد إلى أضرارٍ في الحرب العراقيّة – الإيرانيّة جراء وقوع إحدى القذائف فيه، فأغلق المسجد مدّةً من الزمن، وفي تلك الفترة كان السيّد يصلّي في مسجد الحَمْد في منطقة السرّاجي، وبدأ الترميم فيه عام 1997م، وأُعيد فتحُه أمام المصلّين في هذا العام، وتحديداً في 27 رجب. كان الجامعُ يغَصُّ بالمصلّين في تلك السنوات حتى أنَّ بعضَ المخازن في المسجد فُتِحَت للصّلاة، ولتوسعته تمَّ شراء قطعة أرض مجاورة لاستيعاب أعدادِ المصلّين المتزايدة وسط إمكانيّاتٍ محدودةٍ في ذلك الوقت، ووُسِّعَ المسجد بتبرّعاتٍ بسيطةٍ تُجمَعُ من المصلّين أيّام الجُمَع، وشارك وأسهم في بنائه بعض ميسوري الحال، ولكنَّ أغلب مَن شارك في البناء هم الفقراء، وبعد وفاة السيّد حامد السُّويج عام 2007 بدأت حملة إعمار واسعة للمسجد، فقد هُدِمَ المسجد وأُضيفت له ثلاثة أمتار من عُمْق الدّار التي أوقفها السيّد للمسجد، وبُنيت القبّة، ورفعت المنارة بارتفاع 25 متراً تقريباً، ووسِّع الطابق الأرضيّ للمسجد، حتى وصل استيعابُه إلى “1100” مصلٍّ. بُني المسجد على طرازٍ عمرانيٍّ راقٍ، إذْ بُنِيتْ قبّته على أيدي خيرة البنّائين، وغُلِّفَت بالكاشي الكربلائيّ من قبل المِعمار الشهير السيّد جليّل النقّاش، صاحب معمل الكاشي الكربلائي في أصفهان، الذي تربطه علاقةٌ خاصّةٌ مع العلّامة السيّد حامد السّويج، حتى إنَّ السيّد توفّي في بيته في مدينة أصفهان أثناء عودته من زيارة مشهد الإمام الرضا عليه السلام. ولم تكن في المسجد مكتبةٌ خاصّة به، بل كانت للسيّد حامد مكتبتُه الخاصّة في بيته، وتحوي أُمَّهات الكتب، وبعض الطبعاتِ الحجريّةِ القديمةِ، وبعض الكتب التي خُطّت بيدهِ الشريفةِ، وبيد والده السيّد أحمد السويج، وهناك مكتبةٌ للمرحوم العلّامة السيّد محمّد زكي السويج تضمُّ أكثر من 3000 آلاف كتابٍ تقريباً تمَّ تبويبها بعنايةٍ، وستكونُ مع مكتبة السيّد حامد السّويج وقفاً للسيّدين الجليلين عند اكتمال البناية المقابلة للجامع وسيُهيَّأُ جناحٌ خاصٌّ بها، ليكونا مكتبةً عامّةً لخدمة أهالي البصرة الكرام. شرفُ الخدمة: كانَ الناسُ يتسابقون على الخدمة في هذا المسجدِ المباركِ تقرّباً للهِ تعالى، ومنها الأذانُ فيه، ومِن مؤذِّني المسجد في أيّام الستينيّات والسبعينيّات، المرحوم الحاج إبراهيم العيد، والمرحوم الملا صبيح، والحاج محمود العيد، نجل الحاج إبراهيم العيد، والأخ علي حسين ثامر، المعروف بـ (علي منّاوي)، كونه يسكن منطقة المنّاوي، والأستاذ الفاضل المقرئ الشيخ علي فيّاض، والأخ كريم “أبو علي”، والأخ عماد، وهم مِن خَدَمَة المسجد أيضاً، وكثيرٌ من القُرَّاء أمثال الملّا ياسين “أبو منصور”، الذي كانَ محلَّ عنايةِ سماحة السيّد حامد منذُ صغره. وخَدَمةُ هذا المسجد يفوقون حدَّ الإحصاء، وكلُّهم من المتطوّعين، ويتفاوتون في مستوياتهم العلميّة والمادّية، فمنهم التاجر، ومنهم الكاسب، ومنهم الطالب، ومنهم الدكتور، وكان سماحة السيّد حامد يردّد دائماً: “كلّنا خَدَمٌ، وأنا كبيرُ الخَدَمِ”، هذا ما نقله السيّد حسن السّويج ابن شقيقة السيّد حامد السّويج، وغالباً ما كان سماحتُهُ يُشرف بنفسه على طهارة فِراش المسجد وأثاثه. حفظ اللهُ مساجدنا التي أذِنَ اللهُ أن تُرفعَ ويُذكرَ فيها اسمُهُ، وزادها علوّاً وشرفاً ورفعةً، ورحِم اللهُ الماضينَ من علمائِنا، الذين كانَ لهم الدورُ الفاعلُ في تأسيس هذه البيوت الإلهيّة، التي ترتقي بالفَرد والمجتمع إلى درجاتِ الكمالِ الروحيّ، وحفِظ الله الباقين منهم.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
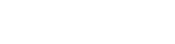 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل