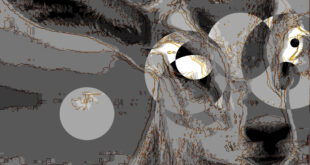السيمر / الأحد 17 . 07 . 2016
أحمد الشرقاوي / مصر
حتـى لا نكيـل بمكياليـن..
الآن وقد فشل الانقلاب واستعادت الحكومة التركية سلطتها على كامل مفاصل الدولة، وبعد أن تابعنا ليلة الجمعة وفجر السبت تفاصيل ما حدث، فقد آن الأوان لنفهم لماذا؟.. وهل الأمر يتعلق بعملية داخلية أم بمؤامرة خارجية؟..
وحيث أننا تعوّدنا في مدرسة المقاومة أن نعالج الوقائع والمعطيات بتجرد وموضوعية، ونتعاطى مع الأحداث من منطلق القيم والمبادئ والأخلاق، فلا يمكن أن نكون إلى جانب الانقلاب على الشرعية الشعبية التي ندعمها في كل مكان من دون استثناء، باعتبارها مصدر كل السلطات، حتى لو كان المستهدف خصما تآمر على أمتنا كـ”إخوان مصر” مثلا، أو عدوا مُجرما أوغل في دماء أهلنا وأحبّائنا في سورية والعراق ولبنان، وعتا فسادا وخرابا في أوطاننا كالديكتاتور أردوغان المتعطش للسلطة والهيمنة..
ذلك، لأن الانقلاب في حقيقة الأمر لم يكن ضد السلطان وحزبه، بل ضد إرادة الشعب التركي الذي انتخبه، وإلا فسيفقد خطابنا المدافع عن شرعية الرئيس الأسد معناه وجدواه، وسنُتّهم بأنّنا نتعامل مع الأحداث بانتقائية ونفاق، ونكيل بمكيالين مثل من ننتقدهم صباح مساء.
وهذا هو ما ميّز الموقف الروسي والإيراني منذ بداية الأحداث، حيث رفض البلدان الانقلاب باعتباره انقلابا على إرادة الشعب، وانتهاكا سافرا لمقتضيات الدستور المعبر عن إرادة الأمة الأسمى.
هل نحن أمام انقلاب داخلي أم مؤامرة خارجية؟..
في البداية، لا بد من توضيح أمر غاية في الأهمية، وهو أن الجيش التركي الذي يعتبر ثامن جيش في العالم، هو جيش أطلسي يخضع لسياسات الحلف وتوجهاته الجيوسياسية إن على المستوى الإقليمي أو الدولي، وبالتالي، لا يستطيع القيام بانقلاب عسكري من دون ضوء أخضر أمريكي ومباركة أطلسية.
وبالتالي، هذا المعطى الجوهري يقودنا حكما لبحث فرضية المؤامرة، وتفكيك خيوطها لتنجلي لنا الصورة واضحة برغم حجم التضليل الإعلامي الذي رافق الانقلاب..
لقد لاحظنا كيف أن القنصلية الأمريكية في أنقرة عمّمت رسالة على مواطنيها لاتخاذ الحيطة والحذر، مُدّعية أن ما يحدث في تركيا هو “انتفاضة شعبية” برغم كل مظاهر العسكرة، وهذا ليس بمستغرب، فأمريكا التي تستطيع رؤية الماء في المريخ بفضل أقمارها الصناعية المتطورة، تبدو عاجزة عن رؤية قوافل الإرهابيين وهي تتنقّل بعرباتها المدرعة ودباباتها وشاحنات مؤنها وأسلحتها بحرية وأمان من موقع إلى آخر في براري العراق وسورية المكشوفة لساعات طويلة، وبالتالي، فكيف لها أن تعرف إن كان ما يحدث في ليل تركيا المضيء “انقلابا عسكريا” أم “انتفاضة شعبية”؟..
كما وأن من تابع الإعلام الغربي والعربي المُوجّه ليلتها، لا شك أنه فوجئ بنوع العزف المُوحّد الذي حرصت من خلاله امبراطوريات الإعلام الأمريكية والبريطانية والفرنسية و”السعودية” على إيصال رسالة للعالم مفادها أن الانقلاب العسكري نجح، وأن الطاغية أردوغان انتهى ولجأ إلى ألمانيا بعد أن رفض اقتراحا باللجوء إلى روسيا..
الأمر الذي يؤكد أن العناوين والتقارير والتحليلات الإخبارية كما لغة الخطاب، كانت جميعها مُعدّة بشكل مُسبّق، وكأن أردوغان وحكومته وحزبه أصبحوا في حكم الماضي ولم يعد لهم من مكان في تركيا الجديدة، وطبعا لا أحد كان يتحدث عن الديمقراطية والشرعية والانقلاب على إرادة الشعب.
وإذا كانت أجهزة المخابرات والحكومات وكبريات وسائل الإعلام في المنطقة والعالم في صورة ما كان متوقعا أن يحدث في تركيا، وحضّروا للتعامل مع نجاحه كواقع غير قابل للنقاش، فهل كان أردوغان ومخابراته وحكومته كالزوج المخدوع آخر من يعلم؟..
بالتأكيد لا، لأن الصحافة الغربية سبق وأن سرّبت معلومات تحدث عن استعداد الجيش للقيام بانقلاب ضد حزب العدالة والتنمية، الأمر الذي فهم في حينه على أنه نوع من التحذير الموجه للسلطان أردوغان كي يكفّ عن حرده ومعاكسته لسياسات واشنطن، ويتراجع عن اللعب على التناقضات الجيوسياسية من خلال التصالح مع روسيا وإعلان عزم حكومته تطبيع العلاقات مع سورية والعراق بهدف منع إقامة الإقليم الكردي في الشمال السوري وربطه لاحقا بكردستان العراق في إطار مشروع التقسيم، الأمر الذي يهدد وحدة الأراضي التركية والإيرانية أيضا، ويؤشر لرغبة أمريكية ملحة في خلق الظروف المثالية لتفجير حرب أهلية على امتداد ساحات المنطقة.
والحقيقة أننا لا نعلم إن كان أردوغان ومخابراته على علم بتوقيت الانقلاب، لكن فشل الانقلابيين في اعتقال السلطان ورئيس حكومته ووزرائه الأساسيين ومدير مخابراته، يؤشر إلى أنهم كانوا على علم بالمؤامرة، وأعدوا خطة لإجهاضها في الوقت المناسب للاستفادة منها سياسيا، سواء لجهة دعم شعبية أردوغان وحزبه، أو لجهة مساعدته على تمرير مشروعه القاضي بتحويل النظام في تركيا إلى نظام رئاسي من دون معارضة بدعوى الدفاع عن تركيا التي تتعرض لمؤامرة التفتيت من قبل من كانت تعتقد أنهم حلفائها..
من هنا خرجت بعض الأصوات تتّهم أردوغان بتدبير الانقلاب للاستفادة منه، ومنها تصريح فتح الله غولن من أمريكا، وهو اتهام هدفه خلط الأوراق وتضليل الرأي العام الداخلي والعربي والدولي، لأن أردوغان لا يمكن أن يتآمر مع الولايات المتحدة ضد نفسه.
ولعل ما يُؤكد معرفة أردوغان بالمخطط ومن يقف ورائه بشكل لا لبس فيه، هو قوله في أول إطلالة إعلامية له بعد الإعلان عن فشل التمرد فجر السبت، أن “الولايات المتحدة الأمريكية دعمت الإرهابيين”، مضيفا بثقة، أن “لا توجد قوة في العالم تستطيع الوقوف في وجه إرادة الشعب”..
هذه الكلمات، تلخص إلى حد بعيد ما وقع في تركيا، وتجيب بشكل واضح عن سؤال: من يقف وراء المتمردين؟.. ومن أفشل الانقلاب؟..
كما أن مسارعة المخابرات وقوات الشرطة بإغلاق قاعدة أنجرليك حيث تتمركز القوات والمخابرات الأمريكية بمعية التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وقطع الكهرباء عنها وتطويقها واعتقال 100 من العسكريين الأتراك المتواجدين بها ثم اعتقال القائد العسكري المشرف على القاعدة متورطا في المؤامرة، يدعم هذا الاتهام، ويؤشر إلى أن السلطات التركية كانت تسعى إلى قطع الطريق أمام أية محاولة خارجية لدعم الانقلابيين بشكل من الأشكال انطلاقا من قاعدة أنجرليك العسكرية، هذا بموازاة قطع كل وسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر لإفشال الرهان على الحراك الشعبي المعارض لنظام أردوغان الذي كانت تراهن عليه الولايات المتحدة لتحويل الحدث في تركيا إلى “ربيع عثماني”، وهو ما جعل حديث القنصلية الأمريكية عن “انتفاضة شعبية” كلام بدون قيمة ولا معنى..
كما لاحظنا باستغراب صمت الدول الأطلسية عن إبداء موقفها المبدئي الرسمي من الانقلاب في الساعات الأولى، خصوصا وأن الأمر يتعلق بدولة حليفة للغرب، وهو ذات الموقف المراوغ الذي اتخذه الوزير جون كيري من موسكو حين قال أنه يتابع ما يحدث عبر الإعلام، وأنه يتطلع إلى “أن يسود الأمن والاستقرار والسلام والتواصل داخل تركيا”، دون أن يدين الانقلاب أو يعبر عن وقوف بلاده الداعم للشرعية الديمقراطية كما فعلت روسيا، هذا علما أن أمريكا تقول أنها تدعم الديمقراطية، وهو الأمر الذي دفع بالرئيس أوباما بعد أن تأكد أن الانقلاب فشل إلى إعلان دعم بلاده للرئيس أردوغان المنتخب ديموقراطيا في خطوة متأخرة تفوح منها رائحة النفاق، فيما رفض الوزير كيري بقوة اتهام أردوغان لبلاده بالوقوف وراء الانقلاب، وطالب أردوغان بتقديم الأدلة على تورط الداعية فتح الله غولن في ما حدث.
ولعل ما يدعم نظرية المؤامرة والتخطيط الخارجي للانقلاب بقوة، هو تصريح أمير قطر السابق حمد بن خليفة السبت، واتهامه لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير بالتواطؤ مع الانقلابيين ضد أردوغان، حيث أشار صراحة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإحدى الدول الغربية (دون أن يسميها) هي من تقف وراء ما حدث، واتهم “السعودية” بأنها كانت على علم بما حيك ضد أمن واستقرار الدولة التركية، ولم يسلم الإعلام السعودي والإماراتي من سهامه.
ونرجح أن يكون الأمير القطري السابق قد قصد فرنسا بإشارته إلى دولة غربية، لأنها الدولة الأطلسية الوحيدة التي أغلقت سفارتها وكافة خدماتها القنصلية في تركيا لدواعي أمنية يومين قبل الانقلاب، كما أنها الدولة التي استهدفها إرهاب “داعش” الذي يديره أردوغان بشكل مركّز ومُتكرّر، بسبب معارضة فرنسا الشديدة لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وانتقادها الحاد لموجة اللاجئين وكيلها الاتهامات الصريحة لأردوغان بابتزاز أوروبا.
كما تبين بعد فشل الانقلاب أن فرنسا هي الدولة التي عبرت عن استيائها وقلقها بشكل مكشوف، فقد حذرت أردوغان من الإقدام على حملة قمع ممنهج ضد معارضيه بعد فشل الانقلاب، مشيرة إلى نجاح أردوغان في السيطرة على السلطة لا يعطيه شيكا أبيضا ليتصرف ضد جيشه كيف يشاء، متسائلة إن كانت حكومة أردوغان شريك فعلي في محاربة الإرهاب، وهو ما ينم عن تخوف لدى السلطات الفرنسية من إقدام السلطان على زعزعة استقرار فرنسا انتقاما من تورط حكومتها في الانقلاب ضده، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى سقوطها وصعود اليمين المتطرف المطالب بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وبذلك قد ينجح السلطان أردوغان في ضرب عصفورين بحجر الإرهاب: إسقاط الحكومة الإشتراكية المتواطئة ضد نظامه من جهة، والمساهمة في تفجير الاتحاد الأوروبي من الداخل من جهة ثانية.
لماذا اتهم أردوغان واشنطن بدعم الإرهابيين؟..
ما من شك، أن هدف أردوغان من اتهام الولايات المتحدة بدعم الإرهابيين، جاء للضغط عليها كي تدفع ثمن تآمرها على نظامه مقابل سكوته على ما حدث، والثمن حدده السلطان في تسليم واشنطن للداعية المعارض فتح الله غولان لمحاكمته وإنهاء خطره، برغم أن الأخير أعلن رسميا وخلال الساعات الأولى لتنفيذ الانقلاب أن لا علاقة له بما حدث في تركيا، وجدد بعد ذلك نفي تورطه في قلب النظام الشرعي في تركيا جملة وتفصيلا، مذكرا بمواقفه من الانقلابيين الذين اكتوى بنارهم خلال فترة حكمه.
نقول هذا لأن اتهام أردوغان للولايات المتحدة جاء بعبارة ملتبسة تحتمل أكثر من تأويل، فهو لم يقل أنها “دعمت الانقلابيين” بل قال أنها “دعمت الإرهابيين”، الأمر الذي يفهم منه أنها تدعم خصمه فتح الله غولن بحمايته والسكوت على نشاطاته، خصوصا من خلال التنظيم الموازي المتنفذ في مؤسسة الجيش والقضاء في تركيا وفق ما يدعيه أردوغان، وأن الانقلاب ما كان ليحدث لولا دعم هذا الرجل الذي تقف خلفه أمريكا وتُحضّره كورقة بديلة لمرحلة ما بعد أردوغان.
لأن اللافت حقا، هو أن يأتي هذا الاتهام في ساعات الفجر الأولى وقبل حتى أن يتم القضاء على التمرد بشكل نهائي ويبدأ التحقيق بشكل رسمي.. فكيف عرف أردوغان أن فتح الله غولن هو من يقف وراء الانقلاب؟..
نفس الأمر يمكن ملاحظته على خلفية عزل 10 قضاة من المحكمة العليا و2745 قاضي من مختلف محاكم البلاد واعتقال المئات من ضباط وقوات الجيش صبيحة يوم السبت، في عملية انتقائية يقول أردوغان أنها هبة من الله لتطهير مؤسسة الجيش الذي تعرضت لأكبر إهانة في تاريخها بسبب استعراض معتقليها في الشوارع من قبل المخابرات والشرطة، ما يوحي بأن السلطات التركية كانت على علم مسبق بتفاصيل المؤامرة، وأعدت حملة التطهير مسبقا وحددت قائمة المستهدفين في انتظار ساعة الحقيقة.
لكن، لماذا طالب أردوغان بتسليم فتح الله غولن ثمنا لصمته؟..
كل المعطيات تؤكد أننا أمام محاولة انقلابية جديّة أريد لها أن تنجح لتضع حدا لحكم “إسلام الإخوان” بعد فشله الذريع في المنطقة، وبالتالي، إسقاط وهم استعادة أمجاد الدولة العثمانية البائدة.. واستبداله بـ”إسلام غولن”، ذو الطابع الصوفي الروحي المنحاز للقومية التركية، والذي يعتبر أنموذجا يحتذى به في المنطقة، بسبب انفتاحه على العالم وخطابه الفكري المعتدل والمتسامح، خصوصا وأنه يحظى بترحيب كبير من الغرب الأطلسي، وسبق أن باركه بابا الفاتيكان خلال استقباله لفتح الله غولن في ذروة صعود وتجذر حركته في تركيا.
وتشير تقارير غربية إلى أن فتح الله غولن الذي يعيش في منفاه الاختياري في ولاية بنسلفانيا الأميركية، يترأس شبكة ضخمة غير رسمية من المدارس والمراكز البحثية والشركات ووسائل الإعلام في خمس قارات الأرض، وقد أنشأ أنصاره وأتباعه ما يقرب من 100 مدرسة مستقلة في الولايات المتحدة وحدها، كما اكتسبت حركته زخما قويا في أوروبا منذ تأسست أولى مدارسها في ألمانيا عام 1995 وبدأت تنتشر في عديد الدول الأوروبية.
ويعود تاريخ التصعيد بين أردوغان وغولن إلى عام 2010، على خلفية سياسات أردوغان الداخلية والإقليمية الكارثية التي أضرّت بتركيا وأدت إلى عزلها إقليميا ودوليا، بسبب إصراره على الاستثمار في الإسلام السلفي الإخونجي المتطرف من أجل تحقيق طموحاته الأنانية.. هذا وتشير تقارير غربية عليمة بالشأن التركي، إلى أن السلطان ومنذ توليه الحكم في تركيا، بدأ بتطبيق سياسة ممنهجة لأسلمة المجتمع ومؤسسات الدولة والجيش والشرطة، في انقلاب ناعم على العلمانية يتم التحضير له من خلال بناء القواعد الشعبية المناصرة لمشروعه الإديولوجي الكبير ضد منافسه في الإديولوجيا الداعية فتح الله غولن.
كيف نجح أردوغان في إفشال المؤامرة؟..
ما من شك أن السلاح الحاسم الذي استعمله السلطان أردوغان بذكاء لإفشال الانقلاب هو سلاح الشارع، حيث وبمجرد أن طالب السلطان من الأتراك النزول إلى الشوارع لمواجهة الانقلابيين برسالة بثها عبر هاتفه النقال من مخبئه، حتى ارتفع الآذان بالتكبير والدعوة إلى الجهاد في صوامع أنقرة وإسطنبول في عز الليل، فغصت الساحات بملايين المناصرين الذين واجهوا الانقلابيين بصدور عارية فأفشلوا تحركاتهم ونزعوا سلاحهم، مُتحدّين بذلك إعلان الجيش حظر التجوال والأحكام العرفية، هذا في ما لعبت قوات الأمن وعناصر المخابرات دورا محوريا في مواجهة الانقلابيين واعتقال العديد منهم، ورأينا كيف أن لا أحد تقريبا كان يناصر الانقلاب، بل حتى أحزاب المعارضة اتخذت الحيطة والحذر، وأعلنت أنها مع الشرعية الديمقراطية، خصوصا وأن تركيا اكتوت بنار الانقلابات العسكرية منذ عام 1960، حيث يعتبر هذا التمرد هو الخامس في مسار الصراع على السلطة بين الجيش الذي يقول أنه يدافع عن العمانية من جهة، والإسلاميين الذين يريدون تغيير طبيعة النظام بالديمقراطية مراهنين على عقيدة الشعب الإسلامية كمحدد للهوية الجامعة من جهة أخرى.
هذا مع الإشارة إلى أن الانقلاب لم يحظى بدعم المؤسسة العسكرية كاملة، وحصلت انشقاقات كبيرة في صفوف القوات الجوية والبرية التي قادت الانقلاب، كما ورفضت القوات البحرية والجندرمة (الدرك) المشاركة في التمرد.
ومهما يكن من أمر، فالثابت مما حصل، أن ليس كل من نزل للساحات والشوارع كان مؤيدا للسلطان أردوغان، بل كل القوى الشعبية كانت ترفع علم تركيا لا علم حزب العدالة والتنمية، وهذه إشارة دالة على أن العنوان الأبرز للمواجهة مع الانقلابيين هو الدفاع عن الديمقراطية والشرعية الشعبية المكتسبة عبر سنوات من التضحية والنضال.. بمعنى، أن الانقلاب كان يستهدف إجهاض التجربة الديمقراطية لا إسقاط حكم الإخوان فحسب.
وتجدر الإشارة إلى أن الشعب التركي في غالبيته العظمى شعب متعلم، يمتلك حسا وطنيا عاليا، ووعيا سياسيا متقدما بحكم قربه من أوروبا واحتكاكه بالمجتمعات الغربية، وتوجد في تركيا طبقة وسطى واسعة تدافع عن مكتسباتها السياسية ومصالحها الاقتصادية التي حققتها في ظل النظام الديمقراطي المنفتح، بخلاف ما حدث في مصر حيث لا وجود لطبقة وسطى، بل مجرد طبقة فاسدة غنية متواطئة وطبقة فقيرة معدمة ومغلوبة على أمرها.. وهذا هو الفرق بين الشعب التركي والشعب الإيراني وبقية الشعوب العربية.
وهذا هو الدرس الكبير والمفيد الذي يمكن استخلاصه من تجربة الانقلاب الفاشل في تركيا، وهو الدرس الذي عبر عنه أردوغان خلال إطلالته الأولى فجر السبت بالقول: “لا توجد قوة في العالم تستطيع الوقوف في وجه إرادة الشعب”..
أما كيف سيرد أردوغان على المتآمرين عليه وعلى حكومته وحزبه، فتلك حكاية أخرى تحتاج لمعالجة مستقلة، وواهم من يعتقد أن أردوغان لن يلجأ إلى الانتقام، خصوصا من فرنسا و”السعودية” ومصر التي عارضت صدور بيان من مجلس الأمن يدين الانقلاب العسكري.. لأن أردوغان بقدر ما هو ذكي وسياسي داهية، إلا أنه رجل أناني، غير عقلاني، واثق من نفسه وقواعده الشعبية في الداخل وتنظيم الإخوان المسلمين في الخارج..
هذا بالإضافة إلى أن مخابراته هي من تدير لعبة الإرهاب في المنطقة باختلاف أسمائه ومسمياته ويملك بنكا من المعلومات حول الجماعات “الجهادية” وداعميها والمتورطين في تسليحها وتدريبها، وبالتالي، لا نستبعد أن يكون الإرهاب هو سلاحه الضارب في المرحلة المقبلة..
هذا بموازاة الاستدارة نحو روسيا وإيران والانفتاح على سورية والعراق لحماية ظهره وتغيير موازين القوى في المنطقة لغير صالح أمريكا وحلفائها وأدواتها..
لكن ما من شك أن اللعبة لم تنتهي بعد بالنسبة لأمريكا وحلفها الأطلسي في تركيا، وقد نرى محاولات تمرد واضطرابات جديدة أو ربما محاولة اغتيال تقوم بها المخابرات الأطلسية، لأن الوحش الجريح لن يستكين ويزول خطره إلا إذا تم القضاء عليه قضاءا مُبرما.
ملحوظـــة:
قد أريد وتريد لكن الله يفعل ما يريد، ونحن بالمناسبة لا نملك إلا أن نقول أن الخير في الواقع، بدليل قوله تعالى (وعسى أن تكرهوا…).
 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل