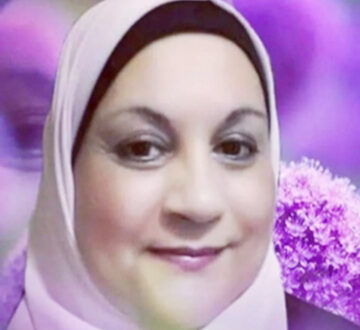السيمر / فيينا / الخميس 18 . 08 . 2022
دراسة: الأديبة سامية خليفة/لبنان
هيكلية وبناء الديوان بشكل عام:
يستفتحُ الشاعر عبد الستار نورعلي ديوانه بإهداءٍ خاصٍّ الى الأديبة والشاعرة فاطمة منصور؛ لدورها وجهدها ومتابعتها في أنْ يرى ديوانه هذا النور؛ وذلك تقديراً لما قامتْ به.
الشاعر نورعلي؛ قبل الروايات الثلاثة (القصائد الثلاثة): الرواية الأولى، الرواية الثانية، الرواية الثالثة؛ يستهلُ ديوانه بما يمكن اعتباره مقدمة، يجوز تشبيهها بما يستخدمه الرياضي كتحميّة ممهّدة قبل الشروع بألعابه الرياضية.
هناك ثلاث قصائد كمقدمة ما قبل الروايات الثلاثة. وأيضاً هناك خاتمة من أحدى عشرة قصيدةً، تعتبر كشلالات دافقة لا تتوقف بحركتها المتسارعة التي لا تهدأ.
القصيدتان الأولى والثانية من الديوان المذيّلتان بتأريخ (١٩٧١) تتشابهان بمسحة حزن، وتنقلان مزاجاً سوداوياً، أما القصيدة الثالثة المؤرخة بعام ١٩٧٦ فهناك انتقالية جذرية إلى عالم سحري رومانسي.
القصيدة الأولى : المسرح
المسرح دلالته مكانية والمسرح يرمز إلى محيط الشاعر. يغلب على القصيدة استخدام أداة الاستفهام (لماذا) يقول : لماذا أكتب ثم يجيب عن نفسه مقدماً تبريراته:
“أكتبُ كي أحيا
أشمُّ صفحةَ الهواءِ،
إذن فالكتابة بالنسبة إليه هدية وعطاء، وهي التي تمدّه بالحياة يقول:
” أكتبُ كي أهديَ للكبيرِ صوتهُ
وللصغير لعبةً
منْ كلِّ ما في إصبعي
منْ ثمرِ القمرْ”
الشعر بنظره رسالة تحثّ الكبير على الثورة والتحدي؛ للصراخ بوجه الظلم. فحين يكون هناك أمانٌ، يمكن حينها للطفل أنْ يهنأ بألعابه. الشاعر عبد الستار نورعلي يكتب لتدوين تاريخ وأحلام وأفراح وأحزان البشر .فالشاعر ابن بيئته، والحياة مسرح والنصُّ ملهاة بشرية:
” إن الحياةَ مسرحٌ،
والنصَّ ملهاةٌ
بإخراجِ البشرْ “.
القصيدة الثانية: “السقوط في أرض الموت”
ينجلي حزن الشاعر جلياً وهو يبوح بشوقه لأبيه الذي ” ينام على صوت الناي الحالم” وارثاً حزنه عن أبيه. كيف لا ! وهو يعيش في أرض الأموات قمر تلك الارض يكلّله الحزن:
” روّيْتُ الجذرَ قلوباً
وجداولَ
منْ دمعِ القمرِ الغارقِ
في صمت الاشياء”
أرضٌ لم يحصدْ فيها غير الجوع:
“لم أحصدْ
غيرَ الجوعِ النابتِ
في عينِ الأحياءْ”
هو ذا ينادي على الأحزان (الكبرى ):
“يا كلَّ الأحزانِ الكبرى!
صوتي يترى،
يتراقصُ في قاعِ الأسرى
يتلوّى….
فتجفُّ الأصداءْ”
هي أحزان تتجاوز أيّ أحزان أخرى في أيّ مكان آخر. الأحزان عبر الأزمنة والأمكنة تصبّ في قلبه؛ فهو الشاعر الذي تتضاعف في وجدانه الآلام والأحلام.
القصيدة الثالثة: “الرحلة”
دور الزمكانية مضطرب في القصيدة، فيها انتقال ملحوظ إلى أجواء رومانسية . هناك مهرجان للبحث فيه:
“في مهرجان البحثِ
في أزمنةِ الكرِّ
صدى السيولِ
والخيولُ مُلجمات”
نتفاجأ بهذه النقلة النوعية من حزن وكرب إلى أجواء رومانسية ساحرة تضيء في القصيدة. كان للطبيعة فيها النصيب الأكبر حيث يسيطر المكان على الزمان، ولكن بعدم إلغائه له:
” والخطى سحبٌ
ورعدٌ
وانتظارْ ”
تنتشلنا كلمة “انتظار” من هيمنة المكان إلى بروز دور الزمان بقوله:
” في انتظار القادم الآتي
على أصداء لحنكَ
نامتِ الأعينُ والأرجلُ والأيدي
وكانتْ يقظةُ الغافي بعينٍ واحدةْ”
كما ويتجلّى اكتساح الزمانية في قوله :
” أتصوغُ هذا اليومَ ملحمةً ،
وتطفئها غداً….”
يستكشف كلُّ مَنْ يتمعن بالنصّ أنّ هناك مناجاة داخلية وجدانية. فما نظنه موجهاً للقارئ منْ أسئلة هو موجّه إلى ذات الشاعر؛ ربما ليُريَ القارئَ ما يدور بخلده، فيتحسس معاناته، وهو حين ينادي على الطير المهاجر:
” أيها الطيرُ المهاجرْ
فوق دفءِ المطر الهاطلِ”
إنّما يقصد بذلك القارئ مستخدماً (إنّنا) لتشمل صيغة (نا) المتكلم القارئ والشاعر معاً. إنّه يستهدف القارئَ لإيقاظه وتوعيته:
” إنّنا في مهرجانِ الهجرِ
في أزمنةِ الفرِّ سقطنا
في انحباس الصوتِ”…
“الرواية الأولى” : وكأنّما الشاعر رحّالة في هذه الرواية
يقول الشاعر فيها بأنّه يمرّر أناملَه في الريح : ليتقصّى الحقيقة عن رؤى في عرق أمنية سرابيّة . ويعتبر الشاعر أنها رواية حمراء ربما في تأويل هذه العبارة ما يحمل من مآس ودماء:
“وتلكَ روايةٌ حمراءُ تروي قصةَ الماضينَ في لهبِ
صحارى تحملُ الواحاتِ إنجيلاً منَ السغَبِ،
أتلكَ روايتي؟
قالوا: نعم!”
يتساءل الفارس الرحّالة: ” أتلك روايتي“، يقولون له نعم. يأتي استغراب الشاعر: فهل يعقل لروايته أن تضمّ في طياتها على كل تلك المآسي، الفارس يهيم على وجهه ، وعشقه مراقٌ دمُه ، يبطل استغرابه حينما يستسلم قائلا :
“وتلك روايةٌ عمياءُ”
عنْ حبٍّ يلوحُ على حبالِ مشانقِ الرغبةْ”
إنها الرواية العمياء، فهي كُتبَتْ عن حبٍّ يلوح على مشانق الرغبة.
هنا حيث:
“تموتُ دلالةُ الرؤيا
وترتفعُ التراتيلُ الصديديّةْ”
كلّ العشاق ما هم إلا من طين، مهما سموا بمشاعرهم فهم ليسوا أكثر من هياكل بشرية يجسدون بها الخديعة الأولى ، فنحن البشر لسنا إلا مجبولين بالطين ، ها هو الشاعر ينادي على آدم فيلقبه بسليل الطين وأن نسله أيضا من الطين:
“أيا آدمْ،
سليلَ الطينِ، يأكلُ نسلُكَ الطينا”
تتجلى المناجاة مضمخة بمرارة العتاب: إننا سلالات مشبعة بالحبّ، لكنها في نفس الوقت تواقة إلى دنيا المرارات والآلام. أما حواء فمناجاتها أيضاً مصبوغة في عتاب يحملها فيه إثمها، هي التي حملت بأجنّة الشيطان:
“فيا حواءُ، هذا ابنُكِ قد شُلّتْ بقاياهُ
تعوّدتِ الخطيئةَ في انطلاقِ النارِ منْ حلقِ الأباطيلِ،
ومنْ وترِ الأضاليلِ،
رميتِ ابنّكِ في الشارعِ ظلّاً للخفايا،
رُحْتِ تلتهمينَ فاكهةَ الخطايا،
تحملينَ أجنّةَ الشيطانِ في الحشرِ”
الصرخة تحتدم في أوجها، تارةً موجهة إلى آدم، وطوراً إلى حواء، عتاب يوارب توبيخاً معتبراً أنّ الإنسانية تحكمها الخطايا منذ تاريخ خطيئة آدم وحواء الأولى:
” وهذا اسمُ الخطيئةِ في انحدارِ السفحِ نحو قرارةِ الوادي
المُشاعِ لكلِّ ذي عينٍ تمجُّ اللونَ في خضرةِ أثمارِ “.
لم يتوان الشاعر عن مناجاة نفسه فقال:
” أيا وجهاً رواه الحزنُ
طافَ على ملامحه اصطخابُ الدهرِ بالأحلام والنشوةْ،
رحلتَ على عيونِ الآخرينَ شربْتَ
منْ كأسِ المرارةِ رحلةَ الغصّةْ،
تحمّلتَ الشرائعَ فوق كاهلكَ،
أخذتَ تهزُّ نشواناً على إنشادِ سُمّارِ السلاطينِ،
رجعتَ مُسمَّر العينينِ والشفتينِ والأذنِ،
وقد مسخوكَ أغنيةً ومرثيّةْ …..”
الشاعر في روايته الأولى يبتدئها بعتاب، مُحمِّلاً لومَ مرارة الحياة إلى الخطيئة الأولى، خاتماً لها بخيبة وإحباط وبخذلان كبير.
“الرواية الثانية”: الحبّ والصدق
في هذه الرواية يعتبر الشاعر أننا حينما تسيطر الرغبات على مفاهيمنا، نعدم بذلك الحبّ، فتموت لغة أصيلة جسّدتها القصائد والروايات عن قصص الحبّ؛ إذ هناك واقع مرير يكتسح عالمنا. وهنا في هذه الرواية يفضح الشاعر الحقائق بجرأة، يعرّيها من المواربات. يبدأ الرواية بقوله:
” سقطَ الهوى في قعرِ رغبتنا البليدةْ
وتراجعتْ لغةُ الموداتِ العتيدةْ
بقي الحنينُ على العيونِ تدفقاً
يروي حكاياتٍ فريدةْ”.
ثم ينادي على مهجة الصبِّ المولّع بالروايات الطريدة:
“يا مهجةَ الصبِّ المُولّعِ
بالرواياتِ الطريدةْ”
فماذا يقصد بتلك العبارة؟ ربما نؤولها إلى أنها روايات عن قيس وليلى، جميل وبثينة، روميو وجولييت، ليستطرد قائلا:” تلك ملحمةُ التواريخ الشهيدةْ “
أي أنّ ذلك كان في الماضي يوم كانت القصائد لها هيبتها واعتبارها ذلك أيام السلاطين الأوائل، أمّا في زمننا الحاضر فكله “ذاهب في محيطات النقائض”:
“نامَ الحنينُ على سفوحِ تولُّعِ الصيّادُ
يصطادُ السواحلَ
في محيطاتِ النقائضِ”
المقارنة بين الروايتين:
إذا قارنا بين الروايتين الأولى والثانية نجد اختلافاً كبيراً من حيث نظرة الشاعر للماضي والحاضر. ففي الرواية الأولى تبخيسٌ للماضي مذكراً الإنسان بخطيئته الأولى، أما في الرواية الثانية فيعتبر أنه في الماضي كانت هناك أهمية للشعر وفحواه، حيث كان هناك تمجيد له ولما يحمل من روايات الحبّ الصادق.
الرواية الثالثة: الحكمة والنضج
يبدأ الشاعر روايته بتقديم نصيحة للقرّاء بعدم المجازفة في الحياة :
“أقِمِ اليومَ على الجُـرْفِ
ولا تقفزْ إلى الموجِ،
فتُسقَى منْ صديدِ الغورِ،
إيّاكَ!”.
ويستخدم الضمير المنفصل (إيّاك) وهو في محل نصب مفعول به لفعل (إحذر) المحذوف، كأداة تحذير يليه بعبارة (فإنَّ) ليبرر تحذيره :
“فإنَّ الخازنَ الموقوتَ
في البرجِ على البندولِ
قد أشرفَ أنْ يُشرعَ بابَ العرشِ
في وادي المنونْ.”
ليكمل بإعطاء أمثلة عن نحر ثمود ناقتها:
“والصالح في الوادي غريبٌ،
وأنا في يدهِ قنديلُهُ نارٌ ونورْ”
فإلامَ يمكن تأويل هذه التحذيرات ؟
إنها بلا شك نابعة كردود فعل للإنسان لتجارب إنسانية مرّ بها عبر الأزمنة ، هي رسالة موجبة يحملها الشاعر على كاهله ليبثَّ من خلالها روح الوعي لدى القراء.
دور الشاعر كواعظ في الرواية الثالثة:
ويتبين في الرواية مدى الحكمة والنضج لدى الكاتب، فبعد ما تقدّم في الروايتين الأولى والثانية، وما سبقهما من قصائد، احتوت على مناجاة وتساؤلات وتعجب، انتقل إلى أسلوب الواعظ المحنّك الذي يفرض كلمته متأكداً من صحتها، يريد بها تخليص مَنْ حوله من ضياعهم ونزواتهم ومفاهيمهم الخاطئة.
ما بعد الروايات الثلاثة:
تلي الرواية الثالثة مجموعة من القصائد . سأقوم بقراءة إحداها وهي “هذا هو الدرب”: حيث يسيطر عاملُ المكان على هذه القصيدة: وادي النخل، مدينة، الأزقة، حقل، الدرب، القارات، وديان ، على فراش السجن.
هنا في القصيدة يطرحُ شاعرُنا أسئلة:
“أمُغفّلاً كانَ الحمامُ
أم استعارَ جناحَ شوكِ لسانهم؟
أمُغفّلاً كانَ الصبيُّ ابنُ الأزقةِ والفقيرُ
يستعيرُ كتابَ أيامٍ مضتْ في سالفِ التاريخِ
مشرقةً شروقَ الأبجديةْ؟”
تليها انثيالات من أجوبة هذا هو الدرب والتأويل: هذا هو الدرب الذي سلكناه وتهنا فيه:
“هذا هو الدربُ:
سباقُ الخيل يعبرُ هذه القاراتِ
بعد قطارِ ذاكَ الشرق …”
وكأنه يريد القول إنه درب التخلّف بعد نهضة وحضارة. في قوله:
“هذي فجيعتُنا،
ثيابُ الغيرِ نلبسُهُ، وننزعُ
عنْ حرارةِ هذه الأجسادِ ثوبَ مياهِنا
فنعيدُ مكياجَ الوجوهِ الناحلةْ”.
هنا يثور معدّداً أخطاءنا، فهو يستخدم صيغة جمع المتكلم كي لا يبرّر لنفسه أنه معصوم عن ارتكاب الأخطاء، ليعود إلى السؤال بعد يقين مع يقين بأنّ في السؤال تنقيباً عن الحقيقة:
” أهو السرابُ اجتاحَنا
أم إنه نقدٌ مُزوّرُ
عند صرّافٍ حديثِ العهدِ
في بنك الكلامْ؟”
إنها الحيرة التي استدعته ليسأل ذلك السؤال.
يلي الحيرةَ البحثُ عن الحقيقة، فهل يمكن العثور عليها، والناس ينامون ملءَ عيونهم على فراش السجن؟ والسجن هنا ليس السجن الحقيقي، إنّه تعبير مجازيّ يقصد به سجنَ التقوقع في ظلام اجترارنا لمفاهيم خاطئة متوارثة، وعادات بائسة، وخرافات تسيطر على العقول، سجن التذلل إلى الحكام:
“قالَ الرفاقُ على فراشِ السجنِ:
ها نحنُ نصبُّ الزيتَ في نارِ الحقيقةِ،
والحقيقةُ في سجونِ القومِ تغرقُ في الظلامْ”
ثم يتساءل حول الحقيقة، فلا يجد أمامه إلا حقيقة واحدة جلية بأنّ الحقيقة ما هي إلا واقعنا، ونحن نتخبط بجهلنا لنقع ضحية سهلة بيد الخارج، لنمسي رهائنَ فتنِ الأممِ التي تدرك تمسكنا بالدين، فكانت الطائفية، وتدرك انقساماتنا إلى مذاهب ففرقتنا وزرعت في قلوبنا البغضاء تجاه بعضنا. هم أتقنوا اللعبة ونحن كنا كبش محرقة جهلنا:
“فهل الحقيقةُ لعبةُ الأممِ
بأيدي صاغةِ الإتقانِ
في حرقِ المراحلِ،
ثم حرقِ القافلةْ؟“
يقول الشاعر وكأنّه عثر على حقيقة مخفية:
“كلُّ الحقيقةِ راحلةْ
يومَ اجتياح الصنم الأكبر
وديانَ الحشودِ الغافلةْ“
فمن هو الصنم الأكبر الذي سيجتاح وديان الحشود الغافلة ؟
الحقيقة هي النور، هي الواقع النقي من الجهالة والتخلف، ولن يبقى قبسٌ من ذلك النور ونحن أتباع ذلك الصنم الأكبر الذي قد يكون زعيماً عميلاً أو فاسداً، أو قد يكون دولة تسيطر علينا من منطلق مذهبي أو طائفي، أو قد يكون نظاماً كما النظام الرأسماليّ الجشع، يقضي على ثرواتنا ونحن غافلون مسيّرون في وديان مظلمة بعيدة عن نور الحقيقة.
وُفِّقَ الشاعرُ باختتام قصيدته العميقة في مدلولاتها وإشاراتها بسؤال؛ ليبقى النصُّ مفتوحاً:
“هذي فجيعتُنا،
فهل يستيقظُ العصفورُ
تحتَ شجيرةِ الرارنجِ
في البيتِ العتيقِ
فقد تسمّرتِ الشفاهُ
وعاثَ في الأرضِ الجرادْ؟”
 السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر موقع عراقي مستقل